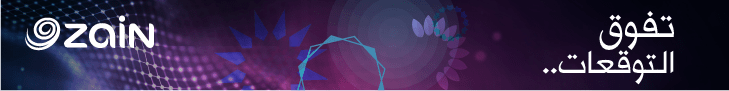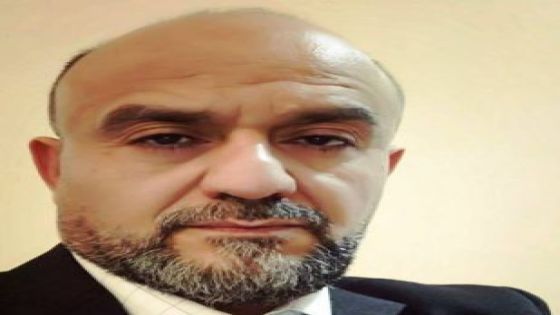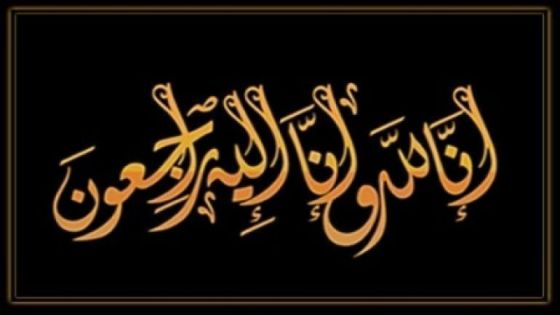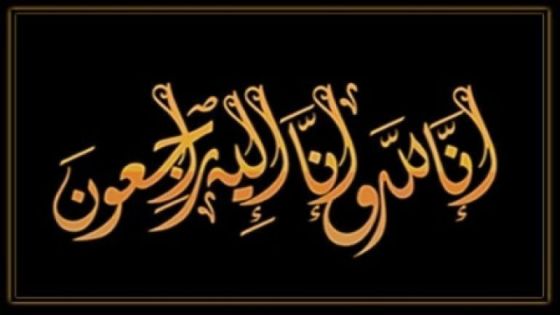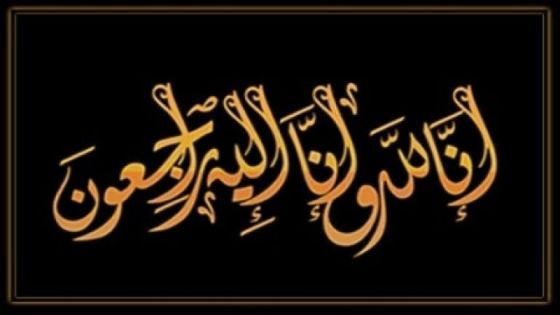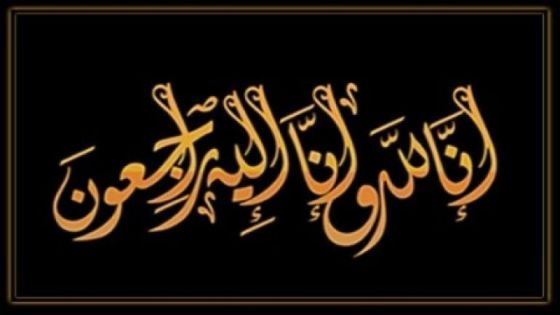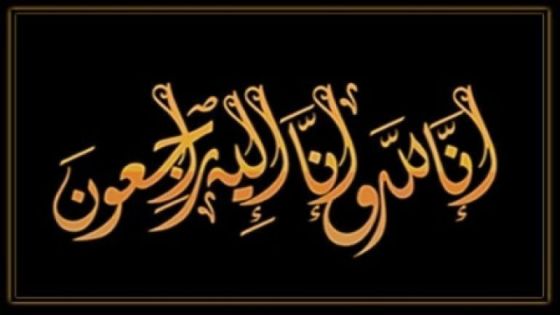بقلم المهندس فراس الصمادي
كاتب سياسي
لماذا يتحول مصطلح “الهوية” إلى أداة تحكم وتوظيف سياسي؟
ما الذي يخشاه “نادي اللوردات” من الحديث عن “الهوية الجائعة”؟
كيف يمكن أن تكون الهوية الوطنية الأردنية درعًا سياديًا في وجه محاولات التذويب والتوطين.؟
كيف يمكن استعادة التمثيل السياسي الحقيقي للهوية الوطنية الأردنية، في ظل تحالفات نخبوية تعيد إنتاج السلطة بعيدًا عن إرادة الشعب؟
هل نحن أمام أزمة هوية حقيقية، أم أزمة تمثيل سياسي؟
وهل يمكن حلها عبر مراجعة قوانين الانتخاب والأحزاب؟
قراءة سياسية في أزمة التمثيل وتحوّل الهوية إلى أداة إدارة فوقيه.
في ندوة عامة تناولت التحديات السياسية والفكرية في المنطقة، تطرق رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور عمر الرزاز إلى تعقيدات الانتماء والهوية، ونصح الحاضرين بقراءة كتاب “الهويات القاتلة” للمفكر اللبناني–الفرنسي أمين معلوف، باعتباره نصًا تأسيسيًا في فهم أسباب النزاعات المعاصرة القائمة على الانتماءات الدينية أو القومية أو الثقافية.
لكن الرزاز لم يكن أول من يستدعي هذا المفهوم، فقد سبقه إلى ذلك كثيرون من شخصيات نادي اللوردات وأذرعهم الفكرية والإعلامية، الذين لطالما وظّفوا مصطلح “الهوية” بأشكال متناقضة – مرة جامعة، ومرة موحدة، ومرة مدنية – ثم عادوا فجأة ليحذروا من خطر الهويات المتعددة، كما لو أنها قنابل موقوتة في جسد الدولة.
نادي اللوردات… من يدير الهوية ومن يحتكر تمثيلها؟
في قلب المعادلة الأردنية تقف طبقة مغلقة من اللوردات البيروقراطيين وأذرعهم المتجددة:
تحالف مستقر بين النخبة الإدارية المتنفذة والمجموعات المالية الصاعدة، يُعيد إنتاج السلطة لا عبر تمثيل الناس، بل عبر إعادة تعريف معنى الانتماء بما يخدم مصالحهم .
هذه الطبقة لا تعادي الهوية، لكنها تخشى أي هوية تُنتج كتلة سياسية خارج السيطرة.
لهذا، تُدير الهوية كما تُدار الموازنة: بتقنين الصرف، وترتيب الأولويات، وتحديد من يستحق الانتماء الكامل ومن يظلّ على الهامش.
الهوية الوطنية الأردنية: درع سيادي لا قاتل
في هذا السياق الأردني والفلسطيني، فإن استدعاء مفهوم “الهويات القاتلة” يتطلب حذرًا نقديًا شديدًا، لأن إسقاطه دون تمحيص على الهوية الوطنية يُفضي إلى خلط خطير، بل إلى تجريم الذات الوطنية ومشروعها السيادي، بدلًا من مساءلة المشاريع التي تسعى إلى تذويبها أو شطبها أو توظيفها.
الهوية الوطنية الأردنية ليست قاتلة، بل تشكّلت كدرع سيادي في وجه مشاريع التذويب والتوطين والوظيفة الجغرافية. هي هوية دولة لا طائفة، مشروع وطني لا رديف لأحد. ومن يُشهِر “الهويات القاتلة” في وجهها، يُهدّد الركيزة السياسية للدولة الحديثة.
الهوية الفلسطينية: صرخة وجود في وجه الاقتلاع
أما الهوية الفلسطينية، فهي ليست تعصبًا، بل صرخة وجود في وجه الاقتلاع. هوية نشأت من النكبة، واستمرت في المخيم، وتجذّرت تحت الحصار. الدفاع عنها ليس عنفًا رمزيًا، بل بقاء في وجه الإلغاء.
الهوية الجائعة… ما لا يُقال وما لا يُمثّل
وسط هذا المشهد، تظهر الهوية الجائعة بوصفها الهوية الوحيدة التي لا يجرؤ نادي اللوردات على الحديث عنها.
وهي ليست هوية فكرية أو ثقافية، بل هوية واقعية مسحوقة:
هوية المواطن الذي يُطلب منه الولاء دون أن يحصل على الاعتراف، أو الحماية، أو التمثيل.
هذه الهوية تتموضع في:
المحافظات التي تُستدعى فقط عند الحاجة لملء الصناديق،
البوادي التي تُستثمر رمزيًا وتُقصى ماديًا،
الأرياف التي تُعزل عن التنمية،
المخيمات التي تُعلّق بين الاعتراف الإنساني والتوظيف السياسي.
الهوية الجائعة: صوت المحافظات المهمشة
في خضم كل هذا، أصبح مصطلح “الهوية” يتكرر بطريقة تثير السخرية والقلق معًا.
كل ما دق الكوز بالجرة يطفوا مصطلح الهوية وكأنه أساس أزمتنا!
مرة “هوية جامعة”، مرة “موحدة”، مرة “مدنية”، ثم فجأة يصبح الحديث عنها تهديدًا! وكلما تعثّر الخطاب السياسي، أو ارتبك المشهد العام، عاد المصطلح ليطفو على السطح.
لكن الهوية ليست ترفًا لغويًا، ولا نشيد علاقات عامة. الهوية – كما نراها – هي تعريف الذات السيادية للدولة والشعب، هي العنوان الذي لا يُختصر ولا يُحلّ بعبارات عائمة.
أما الهوية الجائعة، فهي ليست أزمة لغوية أو ثقافية، بل صرخة سيادية مُعلّقة: هوية تبحث عن صوت في برلمان صامت، وعن تمثيل في معادلة بلا تمثيل، وعن اعتراف في دولة تراكم الولاء وتبخس الانتماء.
هذه الهوية هي هوية المحافظات والأرياف والبوادي التي لم يُسمح لها بتمثيل ذاتها في هندسة السلطة، بل حوصرت في شعارات التوازن الديمغرافي دون أن تُمنح فرصة الحضور السياسي الحقيقي.
الهوية الجائعة لا تملك ناطقين رسميين، ولا تحظى بحصص في ورش تمكين الهوية الجامعة. إنها الوحيدة التي يُمنع الاقتراب من سؤالها، لأن طرحها يفتح ملفاً لا يريد نادي اللوردات ولا نُخَبه المُتحَلِّقة حول الدولة أن يُفتَح.
ختاما من يملك تعريف الهوية؟ ومن يحق له أن يُمثّلها؟
لسنا فقط في مواجهة استدعاء مكرور لمصطلحات كالهوية الجامعة أو المدنية، بل أمام لحظة سياسية تتطلب طيّ هذا الملف الاستهلاكي وفتح ملف مسكوت عنه:
ملف التحديث السياسي نفسه، الذي لم يعد صالحًا للاستهلاك ولا للترويج، بل يحتاج إلى مراجعة جذرية وتصويب حقيقي يبدأ من قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، بما يعيد التمثيل السياسي الحقيقي للشعب الأردني ويحفظ مصالحه في مواجهة استحقاقات كبرى جاري العمل عليها في الداخل والإقليم.
فإما أن نملك تعريف هويتنا ومصالح شعبنا ووسيلة تمثيله… أو نُترك لمصيرٍ يُحدده لنا آخرون.