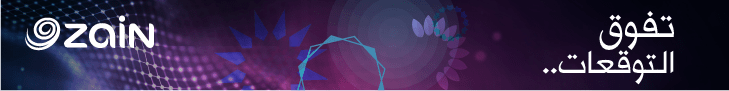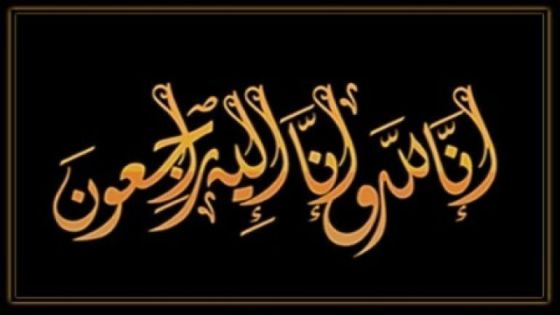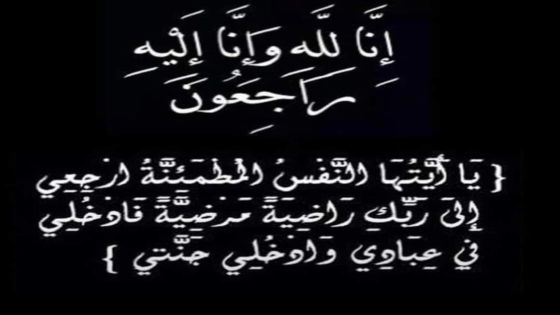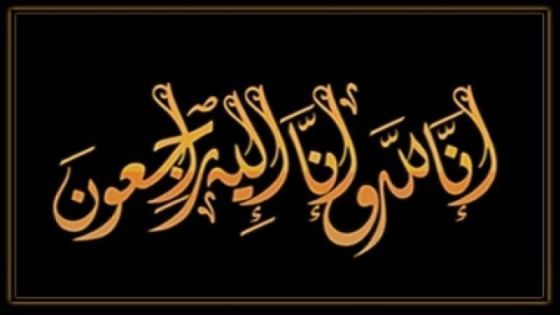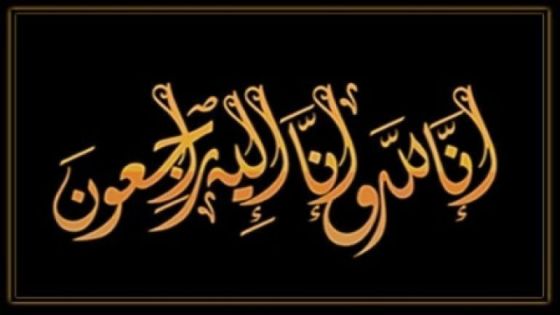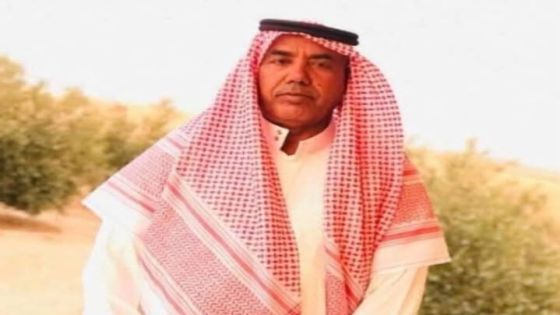بقلم إبراهيم السيوف
الصراعات الكبرى لا تنفجر بين
عشية وضحاها. إنها تتخمّر في الصمت، تتشكل تحت الطاولات، وتتحرك ببطء مثل الصفائح التكتونية، حتى تأتي اللحظة التي يهتز فيها السطح، ويعلو الدخان. هذا ما يحدث اليوم بين الصين والولايات المتحدة. ما يُرى على الشاشات من حروب رسوم جمركية أو مناورات بحرية ليس إلا القشرة. أما في العمق، فثمّة زلزال حضاري يتمدد، قد يُفضي إلى إعادة تشكيل العالم كما نعرفه.
لنفهم هذا الاشتباك، لا بد أن نغور في التاريخ حيث الجرح الصيني لم يُشفى. قبل أن تُولد أمريكا كدولة مستقلة، كانت الصين تحكم ملايين البشر بثقافة مركزية لا ترى للعالم حدودًا سوى تلك التي تنتهي عند سورها العظيم. كانت الإمبراطورية الوسطى ترى نفسها محور الأرض، ومع ذلك انهارت أمام المدّ الغربي بفعل حروب الأفيون، والانقسامات الداخلية، والتغوّل الأوروبي. ومع دخول القرن العشرين، لم تكن الصين إلا ساحة للمستعمرين والمحتلين. عاش الصينيون زمنًا طويلًا وهم يُوصمون بأنهم “شعب مريض لرجل آسيا”، بينما أمريكا تمددت من المحيط إلى المحيط دون أن تشهد غزوًا واحدًا على ترابها.
لكن التاريخ لا يسير في خط مستقيم. فمع تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، قررت القيادة الشيوعية أن تتخلص من رواسب الهزيمة، وأن تعيد تشكيل الأمة الصينية على أسس جديدة. البداية كانت دامية. ماو تسي تونغ، بوحشيته المثالية، دفع البلاد إلى كوارث بشرية واقتصادية هائلة. ومع وفاته، كان يمكن للصين أن تُدفن تحت أنقاض الفقر والتخلف إلى الأبد، لولا ظهور دنغ شياو بينغ، الرجل الذي قرأ العالم كما لم يقرأه صيني قبله.
في خطاباته، لم يكن دنغ يتحدث عن الديمقراطية أو الحريات، بل عن “اللحاق بالغرب”. قال عبارته الخالدة: “ليس مهمًا لون القط، ما دام يصطاد الفئران”. فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، أنشأ مناطق اقتصادية خاصة، وأرسل آلاف الطلبة إلى جامعات أمريكا وأوروبا. لم يكن ذلك تسولًا للتكنولوجيا، بل خطة لاستيعابها، تمهيدًا لإنتاجها، ثم التفوق فيها.
وخلال ثلاثة عقود، تحولت الصين من مصنع للقمصان إلى مصنع للذكاء الصناعي. صعدت خطوةً خطوة، دون أن تثير الكثير من الضجيج. كانت تقرأ سقوط الاتحاد السوفييتي بعين باردة، وتتعلم من أخطائه. لم تُسرف في التسلّح، بل أسرفت في البُنى التحتية، في التعليم، في التكنولوجيا. كان في ذهنها هدف واحد: لا بد أن نصل إلى 2049 – مئة عام على تأسيس الدولة – ونحن في القمة.
في الجانب الآخر، كانت أمريكا تمضي في الاتجاه المعاكس. منذ نهاية الحرب الباردة، تصرفت كإمبراطورية منتصرة فقدت خصمها، فذهبت تبحث عن أعداء هامشيين لتثبت وجودها. دخلت العراق، وأفغانستان، وأنفقت تريليونات في حروب لا منتصر فيها. وبينما كانت تقصف بطائرات الشبح، كانت الصين تشتري موانئ إفريقيا وتبني شبكات اتصالات في أوروبا. أمريكا اعتقدت أن القوة العسكرية وحدها تصنع المجد، بينما الصين كانت تبني القوة الاقتصادية التي تُخضع العالم بلا طلقة واحدة.
عندما جاء ترامب، كان أول من صرخ في وجه المؤسسة الأمريكية: “لقد بعتم أمريكا للصين!” ففرض الرسوم، وفتح الحرب التجارية. لكن الصدمة كانت أن الصين لم تنهزم، بل استمرت في التقدم. ومع بايدن، تغيرت الأدوات، لكن الهدف بقي واحدًا: عرقلة الصين قبل أن تصل إلى خط النهاية.
ما نراه الآن ليس مجرد تنافس اقتصادي، بل بداية اشتباك مصيري بين نموذجين للهيمنة. أمريكا تمثل الليبرالية الغربية التي آمنت بأن العالم سيتبعها إن فتحت له السوق والديمقراطية. لكن الصين صعدت بنموذج مختلف تمامًا: حكم الحزب الواحد، الاقتصاد المركزي، والانضباط الجماعي. وهي تقول للعالم بصوت خافت: “لا حاجة للديمقراطية لتكون عظيمًا”.
الصراع بلغ ذروته حين بدأت الصين في تحدي هيمنة الدولار. أبرمت اتفاقات باليوان مع روسيا، وإيران، والسعودية. شكّلت مع البريكس تحالفًا يهدد قلب النظام المالي العالمي. ثم جاءت ضربتها الكبرى: البدء بتطوير رقائق إلكترونية بمعزل عن أمريكا، وهي الرسالة الأوضح بأن بكين لا تخشى من الحصار، بل تستعد له.
إذا استمر هذا الاشتباك، فإننا أمام لحظة تاريخية نادرة، كتلك التي شهدها العالم عند سقوط روما، أو تفكك الاتحاد السوفييتي. لكن الفرق هنا أن التغيير قد لا يكون نتيجة لحرب نووية أو اجتياح عسكري، بل لانقلاب هادئ في موازين الثقة والأسواق والنفوذ. والعالم قد لا يعود موحدًا تحت مظلة واحدة، بل ينقسم إلى معسكرين: عالم يقوده الغرب كما كان، وآخر تُديره الصين بلغتها الصامتة ونظامها الحديدي.
والسؤال الآن ليس من سيربح الجولة القادمة، بل: من سيصمد حتى النهاية؟ من يملك النفس الطويل؟ من يستطيع التحكم بالمعرفة، بالطاقة، بالثروات؟ من يملك الرواية التي تُقنع العالم؟
الصين لا تخوض حربًا، بل تعيد كتابة التاريخ. وأمريكا لا تدافع عن اقتصادها فحسب، بل عن مركزها كرمز للحضارة الحديثة. هذه ليست مجرد منافسة، إنها لحظة تقرير مصير للبشرية كلّها