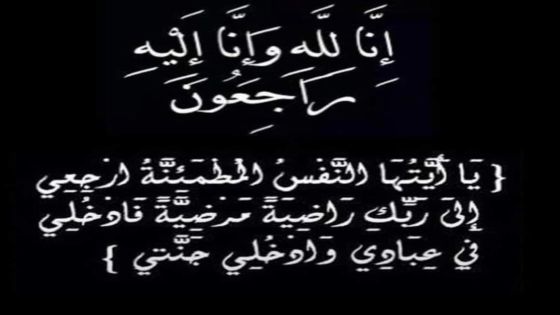وطنا اليوم:في عام 1992، حددت الأمم المتحدة يوم 22 مارس ليكون اليوم العالمي للمياه، بهدف إذكاء الوعي بالأمور ذات الصلة بالمياه، حيث تُنظَّم الاحتفالات لتسليط الضوء على أهمية المياه واستلهام الإجراءات الرامية إلى التصدي للأزمة العالمية للمياه.
اختارت الأمم المتحدة موضوع يوم المياه العالمي لعام 2024: “المياه من أجل السلام”. وذلك على اعتبار أن “المياه قد ترسي السلام أو تشعل فتيل النزاع”، فعندما تكون المياه شحيحة أو ملوثة، أو عندما يفتقر الناس إلى الفرص المتكافئة للحصول على المياه أو تنعدم فرص حصولهم عليها، فإن التوترات قد تتصاعد بين المجتمعات والبلدان.
في هذا السياق، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشحة لتكون من أكثر المناطق تأثراً وتضرّراً بالتغيّر المناخي حول العالم، والأكثر تأثراً بشح الموارد المائية الناجمة عنها، وهو ما بات أمراً واقعاً في العديد من دول هذه المنطقة.
“المياه تساوي الذهب” بأسعارها
في تونس، على سبيل المثال، شهد مطلع مارس الجاري ارتفاعاً في أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 16 بالمئة في مواجهة الشح المائي نتيجة جفاف طيلة السنوات الخمس الماضية. وفرضت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، منذ العام الماضي، نظام الحصص في مياه الشرب، وحظرت استخدامها في الزراعة، وبدأت قطع المياه ليلاً.
أما في جزيرة صقلية المتوسطية، التي لا تبعد كثيرا عن المنطقة، فالوضع بات أكثر سوءاً. فسكان تلك المنطقة من إيطاليا باتوا مجبرين على التفكير حتى بإعداد إبريق شاي، يخزنون مياه الشرب في عبوات وأحواض الاستحمام، بسبب شدة الجفاف وتراجع مخزون المياه بعد غياب الأمطار الشتوية، ما دفع لإعلان السلطات حالة طوارئ في 29 فبراير الماضي، فيما بات السكان يرون أن “المياه تساوي الذهب”، بحسب ما نقل تقرير لوكالة رويترز.
هذه الأمثلة الحديثة، مجرد نموذج عما تواجهه أو تنتظره دول كثيرة في الشرق الأوسط، معرضة هي الأخرى لموجات جفاف وشح بالمياه العذبة المخصصة للزراعة والاستخدام البشري، نتيجة تراجع المتساقطات ومنسوب الأنهار وخزانات المياه الطبيعية، الأمر الذي يشكل تهديداً كبيراً للمجتمعات في تلك المناطق.
الضغط على السكان، سينعكس على الحكومات، التي ستكون مجبرة على اتخاذ خيارات أكثر تشدداً وصرامة في مواجهة هذا التحدي الوجودي، وهو ما من شأنه أن ينعكس على سياساتها الداخلية والخارجية في الوقت ذاته، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الموارد المائية المشتركة بين الدول، والتي من المتوقع أن تكون السبب الرئيسي لقيام الصراعات والنزاعات في المنطقة، وفق تقديرات سابقة لمعهد واشنطن، في حين أن مواقف الحكومات وتعاملها مع هذه القضايا يرفع من احتمال اندلاع “حروب المياه” في المستقبل القريب.
وفي هذا السياق، تبرز في الشرق الأوسط ثلاث أزمات مياه تعتبر الأكثر حساسية وإلحاحاً، لاسيما وأنها ترتبط بالأمن المائي لأكثر من نصف مليار إنسان موزَّعين على الدول المعنية بهذه الأزمات، وهي: أزمة مياه دجلة والفرات بين العراق وتركيا وإيران، أزمة نهر النيل بين مصر والسودان واثيوبيا، وأزمة المياه المشتركة بين الأردن وإسرائيل.
تاريخ العلاقات بين تلك الدول، والتي شهدت بمعظمها حروباً، والاختلافات العرقية والقومية، والخلافات السياسية، تنعكس بصورة مباشرة على ملف المياه المشتركة، لاسيما مع الاستخدام السياسي لورقة “الأمن المائي” في سياق الضغط والنفوذ. وهو ما يثير مخاوف من اتخاذ العلاقات بين تلك الدول اتجاهاً أكثر توتراً في المرحلة القادمة مع اشتداد حدة الأزمة المائية وازدياد الجفاف.
أزمة “ما بين النهرين”
تزداد المخاوف في العراق، المُسمَّى تاريخيا “بلاد ما بين النهرين”، من خسارة الرافعة الحضارية الأساسية التي عاشت حول ضفافها الشعوب المتلاحقة على مدى آلاف السنوات، نهرا دجلة والفرات، اللذان يشهدان تراجعاً تاريخياً في منسوبهما لم يسجل من قبل، وذلك لعوامل عدة، بعضها مرتبط بالتغيير المناخي والبعض الآخر ناجم عن سياسات “دول المنبع”، أي تركيا وإيران.
في يونيو عام 2022، خرج نائب رئيس البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، في مؤتمر صحفي، مهددا الحكومتين التركية والإيرانية بإصدار قانون تجريم التعامل التجاري مع الدولتين، كرد على احتجاز البلدين لمياه الأنهار التي تنبع منها دون الوقوف عند حاجات العراق المائية.
وعلى الرغم من أن ذلك لم يحصل، إلا أنه كان مؤشراً على حجم الأزمة التي يعيشها العراق، والتي دفعته العام الماضي إلى تقليص قاس وكبير للمساحات الزراعية أفقد المحافظات معظم أنشطتها الزراعية في سبيل توفير المياه، الأمر الذي هدد بانهيار الأمن الغذائي للعراقيين، وفق ما أعلنت وزارة الزراعة العراقية حينها.
ويعود أصل الأزمة بين الدول الثلاث إلى منطلقات كل دولة في نظرتها للمياه المشتركة فيما بينهم، ففي حين تعرّف الأمم المتحدة الأنهار الدولية بأنها “المجاري المائية التي تقع أجزاء منها في دول مختلفة”، لا توافق كل من تركيا وإيران على إسقاط هذا التعريف على الأنهر المشتركة مع العراق، إذ لم يوقع أي من البلدين على اتفاقية الأمم المتحدة حول استخدام المجاري المائية للأنهار الدولية غير الملاحية لعام 1997، وهو ما يحلهما من الالتزام بالقانون الدولي في هذا الشأن.
ويعتمد أكثر من 3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم على مياه تعبر الحدود الوطنية، بحسب الأمم المتحدة، ومع ذلك، فإن 24 بلداً فقط لديها اتفاقيات تعاون بشأن جميع مياهها المشتركة.
وتستند تركيا في تفسيرها لطبيعة نهري دجلة والفرات إلى نظرية قديمة تمنح الدولة السيادة المطلقة في التصرف بما يقع ضمن أراضيها، بما في ذلك مياه الأنهار، دون قيد أو شرط. وطبقا لذلك، فمن حقها إقامة ما تشاء من مشاريع للانتفاع بهذه المياه، وإحداث أي تغييرات، بما في ذلك تغيير مجرى النهر بصرف النظر عما يترتب عليه من أضرار بمصالح الدول الأخرى.
مع إيران.. المشكلة أعقد و”أكثر ضرراً”
على الجانب الآخر تقطع إيران بشكل كامل روافد مهمة لنهر دجلة، مثل نهر الزاب، وروافد سد “دربندخان” وبحيرة حمري وبحيرة دوكان، ما أدى إلى أزمة كبيرة في حوض نهر ديالى حيث انخفض مستواه بنسبة 75 بالمئة، فيما عانى شرق العراق وجنوبه من أزمة جفاف خانقة لاسيما عام 2021 وصيف عام 2023، حيث بلغت إطلاقات المياه من الجانب الإيراني صفرا، وفق تصريحات المسؤولين العراقيين.
قصة المياه المشتركة بين إيران والعراق، تختلف عما هو سائد مع تركيا، إذ سبق للبلدين أن أبرما اتفاقاً عام 1975 لتقاسم المياه المشتركة تم بموجبه تقاسم مياه شط العرب، عرف بـ “اتفاقية الجزائر”، إلا أنه وبعد الحرب التي نشبت بين البلدين، انسحب الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، من الاتفاقية، عام 1980، واعتبر مياه شط العرب ملكاً كاملاً للعراق، وهو ما تبرر عبره إيران اليوم عدم التزامها بمنح العراق حصصه المائية.
وعلى الرغم من أن كمية المياه القادمة من إيران إلى العراق أقل بكثير من تلك التي تصل عبر تركيا، إلا أن الأزمة مع إيران أكثر تعقيداً بحسب سليمان، الذي يضيف أنه، “ومنذ عام 2017، يتحدث المسؤولون الإيرانيون بشكل واضح أنهم يعانون من مشكلة مياه، وأنهم سيمنعون الأنهار من الوصول إلى أي بلد آخر ومن بينهم العراق”.
الأردن وإسرائيل.. فشل التعاون
ما يعانيه العراق من تأثير للتغير المناخي، ينطبق على جاره الأردن الذي يصنف ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه، حيث نصيب الفرد منها يتراوح ما بين 60 و90 متراً مكعباً سنوياً لكل الاستخدامات، في وقت يبلغ فيه خط الفقر المائي العالمي 1000 متر مكعب.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت بحق الإنسان في الحصول على كفايته من المياه للاستخدام الشخصي والمنزلي (ما بين 50 و100 لتر لكل فرد يوميا)، على أن تكون تلك المياه مأمونة وبأثمان معقولة (لا ينبغي أن تزيد كلفة المياه عن 3 في المئة من مجمل الدخل الأسري)، وأن تكون متاحة مكانا (ألا تبعد أكثر من 1000 متر من المنزل) وزمانا (ألا يستغرق الحصول عليها أكثر من 30 دقيقة).
ما يشهده الأردن اليوم فيما يتعلق بالمياه المشتركة مع إسرائيل، خير مثال على التأثير المتبادل ما بين السياسة والأمن المائي، وانعكاسه على علاقات الدول المتشاركة بمصادر المياه.
على هامش معرض إكسبو 2020 في دبي، عام 2021، وقع كل من الأردن والإمارات وإسرائيل إعلان نوايا عام للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك يقوم على تبادل الطاقة والمياه، رعته الولايات المتحدة عبر مبعوثها جون كيري، بحيث تُؤمَّن للأردن كميات إضافية من المياه التي يحتاجها، وفي المقابل تحصل إسرائيل على مصدر طاقة متجددة تبلغ عبره الحد المطلوب أوروبياً بموجب اتفاقية باريس لتخفيض الاعتماد على الطاقة الأحفورية.
وبعد دراسة جدوى بين الطرفين، وجهود دبلوماسية متبادلة أفضت إلى تحديد موعد لتوقيع الاتفاقية بين البلدين في نوفمبر عام 2023، أعلن الأردن قبل أسبوعين من الموعد انسحابه من الاتفاقية كنوع من الضغط على إسرائيل، على خلفية اندلاع الحرب في غزة بعد أحداث السابع من أكتوبر، والتي عكست توترا واضحا في العلاقات بين الأردن وإسرائيل.
في حينها، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في تصريحات إعلامية: “لقد توقفت المناقشات… لن نوقع الاتفاقية”، مضيفا “إسرائيل تقتل الأبرياء، ونحن أمامنا رأي عام وشعب نحترمه… لا يمكن تخيّل أن وزيرا أردنيا يجلس إلى جانب وزير إسرائيلي اليوم ليوقع اتفاقية تعاون”، وذلك في وقت شهدت فيه المملكة تحركات شعبية واسعة متضامنة مع قطاع غزة.
في المقابل، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينت، والذي سبق أن وافقت حكومته على الاتفاق، بالقول: “لدى إسرائيل مصادر طاقة كافية لتوليد الكهرباء، الأردن لا يملك ما يكفي من المياه لشعبه.. لقد فعلنا ذلك لمساعدة جيراننا المتعطشين للمياه. إذا كان قادة الأردن يريدون أن يعطش شعب الأردن، فهذا حقهم”.
يذكر أنه وفي عام 2021 جرى التوصل لاتفاقية بين الجانبين يقوم عبرها الأردن بشراء 50 مليون متر مكعب من المياه من إسرائيل، بأسعار مخفضة، قابلة للتجديد سنوياً، حيث يحين موعد التجديد في أبريل المقبل. ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد طلب الأردن، في 11 يناير، من إسرائيل تجديد “اتفاقية المياه” لمدة عام.
إلا أن الموقف الأردني من الحرب في غزة أثار حفيظة واستياء العديد من الجهات السياسية في إسرائيل، والتي تضغط من أجل عدم تجديد الاتفاقية هذا العام والاكتفاء بما تنص عليه اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل لناحية تقاسم كميات المياه، فيما قالت تقارير إعلامية إن إسرائيل اشترطت “تخفيف المسؤولين الأردنيين من انتقاداتهم الصريحة لإسرائيل، وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين”.
وسط علاقات “متوترة” بين الأردن وإسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة، بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخري، ينتهي مفعول “اتفاقية شراء المملكة للمياه من إسرائيل”، بينما يكشف مسؤولون ومختصون مدى إمكانية “تمديد الاتفاقية”، والشروط التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية للموافقة على التمديد.
ووقّع الأردن وإسرائيل اتفاقية “وادي عربة” للسلام برعاية أميركية، عام 1994، تحصل الأردن بموجبها على 55 مليون متر مكعب من المياه من الجانب الإسرائيلي، وتلزم الاتفاقية الطرفين بتبادل “الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما، وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربة”، إضافة لإمكانية شراء الأردن 50 مليون متر مكعب سنوياً من المياه.
وتتهم تيارات سياسية وشعبية أردنية الحكومة بالتفريط بالحقوق المائية للأردن في اتفاقية وادي عربة، لاسيما لناحية مياه نهر الأردن والمياه الجوفية الحدودية، في حين تؤكد الحكومات الأردنية المتعاقبة أن الأردن حصل على حقوقه المائية كاملة.
في هذا السياق تقول الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري في الأردن، ميسون الزعبي، إن اتفاقية وادي عربة اعطت إسرائيل تحكماً بمصادر المياه المشتركة، “ولم تكن الاتفاقية مدروسة كما يجب ما أدى إلى ظلم الأردن”، على حد وصفها.
وتضيف “لكن في النهاية، الاتفاقية وُقِّعت، والمشكلة أنه بمجرد توقيع اتفاقية ثنائية بين دولتين لا يمكن بعدها اللجوء إلى القانون الدولي لأخذ الحقوق في المياه المشتركة”.
وتبلغ حاجة الأردن سنوياً من المياه نحو مليار و400 مليون متر مكعب للاستخدامات كافة، يتوفر منها نحو 950 مليون متر مكعب، بينما يبلغ العجز المائي نحو 400 مليون متر مكعب، بحسب وزارة المياه والري الأردنية.
وتزداد الحاجة الأردنية للمياه مع تزايد عدد السكان وأعداد اللاجئين، إذ تقول الأمم المتحدة إن الأردن يشهد ثاني أعلى نسبة في العالم من حيث عدد اللاجئين نسبة للفرد الواحد.
وبحسب الزعبي، فقد أدى التغيير المناخي وتضاؤل المتساقطات، فضلاً عن تراجع واردات المياه من الجانب السوري (سد الوحدة) منذ عام 2011، إلى جعل الأردن بحاجة لشراء المياه من إسرائيل، “ما حوَّل ملف المياه إلى أداة ضغط وتحكم سياسي تستخدمه إسرائيل كسلاح في وجه الأردن”.
مع ذلك لا تتوقع الزعبي أن تتجه الأمور بين الأردن وإسرائيل نحو التصعيد، خاصة وأن الأردن “ليس مع المزيد من الحروب، ولا في وارد الخروج عن اتفاقية السلام”.
وتضيف أنه وبنتيجة التطورات الأخيرة “تزداد القناعة لدى الأردن بأن الاعتماد على إسرائيل في تأمين المياه بصورة مستدامة هو أمر غير مضمون ودونه عواقب، خاصة أن سيناريو غزة لا يزال ماثلاً، حيث أول ما قامت به إسرائيل كان قطع المياه. كان ذلك درساً لنا، بعدم تقديم أداة لإسرائيل للتحكم بنا”، واصفة المياه بأنها باتت “أسلحة دمار شامل قادرة على قتل الملايين والتحكم بقرارات الدول”.
يذكر أنه وعقب الإعلان عن وقف توقيع اتفاقية المياه بين الأردن وإسرائيل، اعتبر الملك عبد الله الثاني، خلال اجتماع مع مسؤولين، أن المضي قدماً في مشروع “الناقل الوطني”، الذي يهدف إلى تحلية ونقل المياه من العقبة (البحر الأحمر) إلى العاصمة عمّان، بات “أولوية وطنية” لتعزيز الأمن المائي. وهو ما يشير إلى اتجاه الأردن لعدم الاعتماد على التعاون مع إسرائيل.
حوض النيل.. الصراع الوشيك
وقبل أن تستحوذ أحداث السابع من أكتوبر وما بعده على المشهد العام في منطقة الشرق الأوسط، كان المصدر الأبرز لخطر اندلاع نزاع في المنطقة يتمثل في الصراع المائي بين مصر والسودان وإثيوبيا حول مياه نهر النيل، بسبب قضية سد النهضة.
ففي السادس من أكتوبر تحديداً، وجهت وزارة الخارجية المصرية رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي قالت فيها إن “ممارسات إثيوبيا أحادية الجانب (بشأن ملء السد وتشغيله) يشكل تهديداً وجودياً لمصر واستقرارها، ويعرِّض السلام والأمن على الصعيديْن الإقليمي والدولي للخطر”.
غيّر سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا على نهر النيل من المشهد الجيوسياسي في شمال شرق أفريقيا. ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير واضح على مستقبل تلك المنطقة، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، نظراً لما يمثله نهر النيل لدول حوضه، إذ يعد المصدر الوحيد المهم للمياه في شمال أفريقيا، ويعيش 40 في المئة من سكان قارة أفريقيا على حوض نهر النيل وروافده، الذي يعتبر الأطول في العالم.
تعتمد مصر بشكل خاص على نهر النيل في 97 في المئة من احتياجاتها المائية، للسكان كما للزراعة والصناعة، في وقت يصف البنك الدولي مصر بأنها من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ، ما يجعل الواقع المصري بالغ الحساسية تجاه أمنه المائي، لاسيما أن نصيب الفرد في مصر يبلغ 500 متر مكعب من المياه سنويا، أي نصف الحد الأدنى للفقر المائي الذي تحدده الأمم المتحدة بـ 1000 متر مكعب.
كل ذلك يجعلها الدولة الأكثر قلقاً من تأثير سد النهضة على إمداداتها المستقبلية من المياه، فضلاً عن التغيير الجيوسياسي الذي سيطرأ في المنطقة، نتيجة إمساك الجانب الإثيوبي بورقة الأمن المائي لمصر وتحكّمه بها، ما سيضعف من النفوذ والتأثير المصري في المنطقة.
ومنذ عام 2011، حين انطلقت إثيوبيا بمشروعها، خاضت مع مصر والسودان مساراً طويلاً من المفاوضات والمباحثات المشتركة حول مشروع السد وآلية إنشائه وعمله، إلا أنها فشلت على مدى الأعوام الماضية في الوصول إلى اتفاق مشترك ينهي الأزمة، على الرغم من بلوغهم مراحل متقدمة في أكثر من محطة زمنية، أبرزها التوقيع على “إعلان مبادئ سد النهضة” عام 2015، حيث جرى الاتفاق على كيفية إنجاز السد وتشغيله من جانب إثيوبيا دون الإضرار بمصر والسودان.
هذا الإعلان سرعان ما سقط مع عدم استجابة إثيوبيا لملاحظات ومطالب فنية من الجانب المصري، حيث عادت الأمور إلى نقطة الصفر، لتدخل الأطراف بعدها في مسار مفاوضات جديدة مُضنية، لم تفضِ بأي نتيجة بدورها.
وفي ديسمبر الماضي، أوقفت مصر “مسار التفاوض” بشأن سد النهضة، وتحدثت في بيان عن “تعنّت الجانب الإثيوبي ضد مطالب دولتي المصب، مصر والسودان”، حيث أكدت القاهرة أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، مع احتفاظها بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
ومن جانبها، قالت الخارجية الإثيوبية، إن القاهرة “حرّفت” مواقف أديس أبابا في المحادثات، مضيفة أن مصر لا تزال لديها “عقلية العصر الاستعماري ووضعت حواجز أمام جهود التقارب”، وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان بأن “إثيوبيا تظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية عن طريق التفاوض تلبي مصالح الدول الثلاث، وتتطلع إلى استئناف المفاوضات”.
أثار البيان المصري بانتهاء “مسار التفاوض” بشأن سد النهضة واحتفاظ مصر للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر، والذي قابله بيان إثيوبي يتهم القاهرة بـ”التحريف”، التساؤلات حول السيناريوهات المتوقعة بشأن الأزمة، وهو ما يوضحه مختصون.
وبذلت أطراف دولية عدة، على رأسها الولايات المتحدة، جهوداً دبلوماسية كبيرة في سبيل حل هذا الملف، حيث دفعت باتجاه توقيع اتفاق بين دول حوض النيل، لاسيما مصر وإثيوبيا والسودان، بهدف تقاسم المياه بصورة عادلة، تبدد مخاوف كافة الأطراف، إلا أن ذلك لم يحصل.
ويزيد نمو السكان المخاوف المصرية حول الأمن المائي، لاسيما وأنه مع بداية إنشاء سد النهضة، كان عدد سكان مصر في حدود 80 مليون نسمة، في حين يقترب العدد اليوم من 120 مليون نسمة.
وبحسب تقرير سابق لمركز كارينغي، فإن الخلاف بشأن السد ليس مرتبطًا فقط بالجوانب المادية لأمن الموارد، بل يعتبر أيضًا نزاعا بين الهوية المصرية القديمة المتمحورة حول النيل والهوية الإثيوبية الجديدة المتمركزة حول النهر أيضا، والتي هي قيد البناء، حيث باتت المفاوضات حوله عبارة عن “لعبة غالب ومغلوب”.
وبحسب المركز، فإن مصر قد تضطر بسبب مشروع السد إلى إعادة تعريف هويتها الوطنية المتمحورة حول نهر النيل، حيث كانت قد بنتها حول رؤيتها للنهر ككائن حي لا ينفصل عن تاريخ البلاد وثقافتها وهويتها الحضارية.
بينما تسوِّق إثيوبيا لمشروع السد بكونه رمزا لوحدة البلاد في مواجهة الفقر والتخلف المُتصوَّر، وتُقدِّم السد على أنه مشروع سيادي سيحمل القوة التنموية للبلاد.
وبينما لم تتراجع إثيوبيا منذ انطلاقها بالعمل على مشروع السد، ولم تتوقف عند المطالب والملاحظات والاعتبارات المصرية والسودانية، تبدو الخيارات المتاحة أمام دول المصب، ولاسيما مصر، محدودة، وأحلاها مرّ.
وفي هذا السياق يشرح زيدان أن موقف مصر اليوم عاد ليكون أقرب إلى ما يسمى “إعلان مرسي”، وهو الموقف الذي سبق أن أطلقه الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، وقال فيه إن “مصر لا تريد خلافا مع إثيوبيا لكن كل الخيارات مطروحة”، كما تضمن تلميحات بتدخل عسكري.
ولا يزال أمام مصر، بحسب زيدان، خيار الحل الدبلوماسي واستغلال علاقاتها الدولية من أجل الضغط على إثيوبيا، وهذا ما حصل فعلياً، لكنه لم يؤدِّ إلى نتيجة حتى الآن، وهذا الحل مرهون بتفهم أثيوبيا للمطالب المصرية.
أما الخيار الثاني فهو التصعيد العسكري، الذي يستبعده زيدان حتى الآن، رغم أن مصر أوحت بذلك في أكثر من مناسبة، أبرزها في عملية شرائها لطائرات الرافال الفرنسية والتي تتميز بقدرتها على التحليق لمسافات بعيدة، ما فُهم بأنه تهديد مصري بقدرته على مهاجمة السد.
كذلك كانت مصر قبل اندلاع الحرب في السودان، تجري تدريبات في السودان، وكان لديها طائرات حربية في مطار “مروي”، وكان الكلام أن السبب الرئيسي لتلك التدريبات هو الضغط على إثيوبيا، بحسب زيدان.
ولكن في نفس الوقت، يستدرك زيدان، أن القاهرة لا تسعى للوصول إلى هذا الخيار ولا تريده، “والدليل أن مصر قد حصلت في أكثر من مرة على ضوء أخضر دولي، لاسيما من الولايات المتحدة في عهد الرئيس (الأميركي السابق) دونالد ترامب، للدفاع عن مصالحها، ومع ذلك لم تتخذ مصر الخيار العسكري وآثرت استكمال المفاوضات”.
لكن في نهاية الأمر، تعد المياه عنصرا أساسيا للحياة، وبحسب زيدان فإن “قطعها عن الناس هو بحد ذاته عمل عدائي، قد يستدعي، إن حصل بشكل خطر، تدخلاً عسكرياً، خاصة وأن الضغط يزداد كل يوم، فكلما تضاءلت الموارد المائية بفعل التغير المناخي، ازداد الضغط أكثر وأثّر على مواقف الدول وخياراتها، وعزّز من حظوظ سيناريوهات أسوأ”.
يذكر أن الأمم المتحدة دعت في اليوم العالمي للمياه 2024، إلى تفعيل التعاون في مجال المياه، في سبيل تحقيق التناغم والازدهار والصمود في مواجهة التحديات المشتركة بين الدول، وذلك انطلاقاً من كون المياه “ليست مجرد مورد يمكن استخدامه والتنافس عليه – بل هي حق من حقوق الإنسان، متأصل في كل صغيرة وكبيرة من مناحي الحياة، تتطلب التوحد واستخدام المياه من أجل إرساء السلام”.