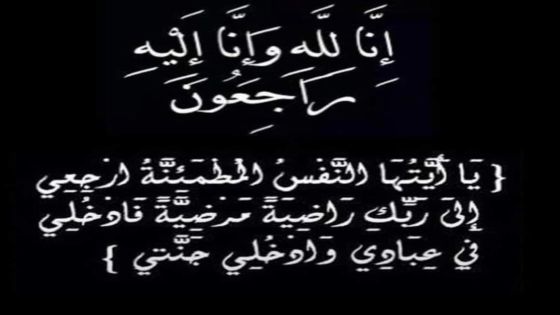وطنا اليوم:”لدينا معاهدة دفاع مع اليابان. إذا تعرضت اليابان لهجوم، فسنقاتل. وإذا تعرضت أميركا لهجوم؟ فلن يفعل اليابانيون شيئا، فقط سيشاهدون على تلفزيون سوني”.
لم تكن الكلمات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دورته الرئاسية الأولى على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة أوساكا اليابانية آنذاك، مجرد مزحة عابرة أو زلة لسان. فبالنسبة لليابانيين، كشفت العبارة عن هشاشة افتراض استمر منذ عام 1947، مفاده أن مظلة الحماية الأميركية ستظل دوما مفتوحة.
فالمقولة، الصادرة عن رأس الدولة الأميركية وفي قلب الأراضي اليابانية، بدت دعوةً لإعادة التفكير في الترتيبات الأمنية التي حكمت العلاقة بين البلدين، لأكثر من سبعة عقود. ومنذ تلك اللحظة، تغير شيء في حسابات اليابان الأمنية.
فبعد عقود من التزامها الصارم بعقيدة “الدفاع البحت”، كان على طوكيو أن تعيد تقييم ركائز أمنها القومي، لا بوصفها تابعا للحماية الأميركية، بل بوصفها قوة تمتلك زمام المبادرة في وجه التهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية والصين.
وبعد ثلاث سنوات على ذلك التاريخ، تحديدا في ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلنت اليابان رسميا تحوُّلها من عقيدة “الدفاع البحت” إلى امتلاك قدرة “الضربة المضادة”، بوصفها جزءا من مفهوم مُحدّث للدفاع عن النفس.
جاءت هذه النقلة ضمن إستراتيجية أمن قومي جديدة، وصفت الهجمات الصاروخية بأنها “تهديد محسوس”، وأكدت أن تطوير القدرة على توجيه ضربات استباقية لمراكز إطلاق العدوان أصبح إجراءً لا غنى عنه، لضمان الحد الأدنى من الحماية.
بهذا الإعلان، طوت اليابان صفحة امتدت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث قيّدها “دستور السلام”، تحديدا مادته التاسعة، التي تنص على “تخلي الأمة اليابانية إلى الأبد عن الحرب بوصفها حقا سياديا للأمة، وعن التهديد بالقوة أو استخدامها وسيلة لتسوية النزاعات الدولية”، وهي قيود امتنعت طوكيو بموجبها عن تطوير أسلحة هجومية صريحة، كالصواريخ الباليستية أو القاذفات الإستراتيجية، والتزمت بعدم استخدام القوة إلا في حالة التعرّض لهجوم مباشر.
اللافت أن هذا التحوّل لا يقتصر على المستوى السياسي أو الأمني، بل يصاحبه تبدّل في المزاج الشعبي داخل اليابان، حيث يُظهر استطلاع رأي حديث أن نحو 60% من اليابانيين باتوا يؤيدون امتلاك القدرة على “الضربة المضادة”، وهي نسبة تأييد لم تكن ممكنة قبل عقد واحد فقط.
“تايب-12”.. مدى أبعد وبصمة أقل
في هذا السياق، تُشكِّل الصواريخ بعيدة المدى محور الإستراتيجية الدفاعية الجديدة لطوكيو، فتنفيذ “ضربة مضادة” يتطلب امتلاك وسائل هجومية دقيقة وقادرة على اختراق العمق المُعادي. ولتحقيق ذلك، خصصت اليابان خلال العقد الحالي استثمارات كبيرة لبناء ترسانتها وتحديثها، سواء عبر مشروعات تطوير محلية أو من خلال شراكات تسليحية مع حلفائها.
أحد أبرز هذه المشاريع يأتي في صورة تطوير نسخة محسّنة من صاروخ “تايب-12″، وهو صاروخ مضاد للسفن من إنتاج شركة “ميتسوبيشي” اليابانية للصناعات الثقيلة، استُخدم بالأساس لصد التهديدات البحرية قصيرة المدى (نحو 200 كيلومتر)، وقد رُفع مداه ليصل إلى نحو 900 كيلومتر، بما يسمح له بتغطية معظم أراضي كوريا الشمالية وأجزاء واسعة من الساحل الصيني، حالة إطلاقه من القواعد البرية في جزيرة كيوشو أو في الجزر الجنوبية اليابانية.
التجارب الأولية للطراز المحسّن أظهرت نتائج واعدة، دفعت وزارة الدفاع إلى تسريع خطط الإنتاج الكمي، تمهيدا للبدء في تزويد الوحدات البرية به أواخر العام الحالي.
ويُشكِّل هذا التحديث نقلة نوعية في قدرات اليابان الدفاعية، فقد صُمِّم بطريقة تقلل من بصمته الرادارية بفضل هيكل خارجي أكثر انسيابية، مما يُصعِّب من مسألة رصده وتعقّبه، كما زُوِّد بتقنيات توجيه متقدمة، من بينها القيادة بالقصور الذاتي مع تحديثات مستمرة عبر نظام “تحديد المواقع العالمي” (GPS)، بما يضمن دقة المسار.
بالإضافة إلى ذلك، يتميز الصاروخ بامتلاك رأس هدفي ذكي، وهو الجزء المسؤول عن تتبع الهدف وتوجيه الضربة بدقة عالية. ويرجع “ذكاء” هذا الرأس إلى احتوائه على رادار نشط بمصفوفة مسح إلكتروني “AESA”، بما يمكّنه من رصد الأهداف المتحركة وتتبعها، سواء كانت بحرية أو أرضية، والتعامل معها حتى في بيئات تشويش إلكتروني أو ظروف مناخية معقدة.
وبحسب وكالة المشتريات والتقنيات واللوجستيات، صُمِّمت النسخة المحسّنة من “تايب-12” بحيث يمكن إطلاقها من منصات متعددة، مما يمنحها مرونة كبيرة وقدرة على تنفيذ مهام هجومية تتجاوز الإطلاق الأرضي التقليدي.
ومقارنة بالأنظمة العالمية المماثلة، يقترب هذا الصاروخ في خصائصه من صواريخ “ستورم شادو/سكالب إي جي” البريطانية-الفرنسية و”إن إس إم” النرويجية، سواء من حيث التصميم منخفض البصمة الرادارية أو القدرة على توجيه ضربات دقيقة، لكنه يتفوّق عليها في مدى الاشتباك وتنوع وسائط الإطلاق، مما يعزز من قيمته العملياتية ضمن إستراتيجية الضربة المضادة اليابانية.
ومع ذلك، يرى خبراء أن نقطة الضعف الرئيسية في “تايب-12” تكمن في نوعية رأسه الحربي، فقد صُمِّم أساسا لمهاجمة السفن، بما يجعله أقل فاعلية في تدمير المدارج أو الملاجئ الخرسانية المحصّنة.
وللتعامل مع هذه الفجوة، قد يتطلب الأمر تطوير ذخائر متخصصة، أو الاعتماد على صواريخ فرط صوتية وباليستية متوسطة المدى، قادرة على اختراق التحصينات الصلبة وتحييد الأهداف الحيوية.
برنامج ياباني يفوق سرعة الصوت
دفع ذلك اليابان إلى البدء في تطوير نظام “القذائف الانزلاقية فائقة السرعة” (HVGP) في عام 2018، وهو نظام هجوم صاروخي متنقل، ينتمي إلى فئة الأسلحة فرط الصوتية، التي تتجاوز سرعتها خمسة أضعاف سرعة الصوت (ماخ 5)، مما يمنحها زمن وصول بالغ القصر وفرصا أكبر لتجاوز الدفاعات المُعادية.
فعلى عكس الصواريخ الباليستية التقليدية التي تتبع مسارا محددا يمكن التنبؤ به، تمتلك القذائف الانزلاقية قدرة على المناورة داخل الغلاف الجوي أثناء التحليق، مما يُصعِّب على أنظمة الدفاع الجوي التقليدية تحديد مسارها واعتراضها، لأن الصاروخ يمكنه تغيير اتجاهه وارتفاعه في اللحظات الحرجة، محدثا ارتباكا كبيرا في حسابات الرادار ومنظومات الاعتراض.
وقد نفَّذت اليابان أول اختبار فعلي للنظام في عام 2024، بالتوازي مع إنشاء كتيبتين متخصصتين لتشغيله، إحداهما في كيوشو، لتأمين الجبهات الجنوبية والغربية في مواجهة الصين وكوريا الشمالية، والأخرى في هوكايدو لتعزيز الدفاعات الشمالية.
ويعكس اختيار هاتين الجزيرتين البُعد الجغرافي الإستراتيجي للبرنامج، فكيوشو تقع في أقصى جنوب الجزر الرئيسية لليابان، قرب بحر الصين الشرقي وشبه الجزيرة الكورية، مما يمنحها موقعا مثاليا لتغطية أي تهديدات محتملة من الجنوب والغرب.
أما هوكايدو، في أقصى الشمال، فتطل على بحر أوخوتسك وتجاور مناطق النفوذ الروسي، مما يجعلها خطَّ دفاعٍ متقدما في مواجهة أي تحركات شمالية، ويضمن توزيع القدرات الصاروخية على جبهتين رئيسيتين لحماية كامل المحيط الإستراتيجي للبلاد.
وبحسب التقارير، أنجزت طوكيو نسخة أولية من النظام يتراوح مداها بين 500-900 كيلومتر، بهدف إدخالها الخدمة خلال العام الجاري. ويعمل هذا الطراز بالوقود الصلب، الذي يدفع القذيفة إلى ارتفاعات عالية، قبل أن تبدأ بالانزلاق نحو هدفها داخل الغلاف الجوي.
أما النسخة المطوَّرة، والمقرر دخولها الخدمة بحلول عام 2030، فستتمتع بمدى يصل إلى نحو 3 آلاف كيلومتر، بفضل اعتمادها على تقنية “الموجة الانزلاقية”.
تقوم هذه التقنية على ظاهرة فيزيائية تحدث عند التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت، حيث تتكوَّن أمام الجسم موجة صدمة عبارة عن طبقة كثيفة من الهواء المضغوط الذي يشبه جدارا غير مرئي.
وفي حين تحاول التصاميم التقليدية مقاومة هذه الموجة، صُمِّم الصاروخ ليستفيد منها كما يفعل متسابق الأمواج الذي ينطلق مع قوة الموجة، مما يمنحه قوة رفع إضافية تطيل زمن التحليق وتزيد المدى.
ومن المقرر أن تُجهَّز النسختان بأنظمة توجيه متقدمة، تجمع بين الملاحة بالأقمار الصناعية والقصور الذاتي، مع مستشعرات رادارية وتتبع بالأشعة تحت الحمراء لضمان دقة الإصابة في مختلف الظروف، إضافةً إلى إمكانية تزويدهما برؤوس خارقة للدروع أو شديدة الانفجار، وفق طبيعة الهدف.
“ضربة مضادة” في مواجهة قوة نووية؟
إصرار اليابان على تعجيل امتلاك قدرات صاروخية فرط صوتية يعكس إدراكها العميق قصور ترسانتها الحالية في مجاراة متطلبات أي صراع إقليمي واسع النطاق، خاصة إذا كانت الصين طرفا فيه.
فبحسب تقرير صادر عن معهد الدراسات البحرية الصيني، تعتمد إستراتيجية حاملات الطائرات التابعة للبحرية الصينية على نظام دفاعي ثلاثي الطبقات، يمنحها قدرة متزايدة على تنفيذ عمليات “المياه الزرقاء” بعيدة المدى، بقدر كبير من الاستقلالية والحماية الذاتية.
تبدأ تلك المنظومة الصينية من منطقة الدفاع الخارجي (ما بين 185-400 كيلومتر من الحدود الصينية)، وتشغلها الغواصات ومقاتلات “جيه-15” المزودة بقدرات الضربات البعيدة وجمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع.
تليها منطقة الدفاع الوسطى (ما بين 45-185 كيلومترا)، وهي مؤمَّنة بمدمرات وفرقاطات مزودة برادارات متطورة، إلى جانب أنظمة إطلاق عمودية مدمجة في بدن السفن، وكذلك قدرات حرب مضادة للغواصات. ثم منطقة الدفاع الداخلية، المحمية بأنظمة دفاع نقطية لاعتراض وتدمير التهديدات القريبة، فضلا عن أسلحة للتعامل مع أي تهديد ينجح في اختراق الطبقات السابقة.
في مواجهة بنية دفاعية معقدة بهذا المستوى، ترى طوكيو أن حيازة صواريخ فرط صوتية، بما تتميز به من سرعة هائلة وقدرة على المناورة، يُشكِّل أداة حاسمة في اختراق منظومات الدفاع المتكاملة والوصول إلى الأهداف عالية القيمة، سواء داخل الصين أو ضد الترسانة النووية الكورية الشمالية، وبما يدعم فاعلية إستراتيجية الضربة المضادة اليابانية.
لكن هذه الفاعلية تصطدم، على الجانب المقابل، بواقع القدرات الكورية الشمالية، إذ تمتلك “بيونغيانغ” ترسانة نووية موزعة على منصات برية وبحرية، تشمل صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، إضافة إلى أنظمة إطلاق بحرية وصواريخ وقود صلب قابلة للإخفاء والإطلاق السريع، يقلل من فرص كشف الأهداف أو تدميرها قبل الإطلاق. فالمنصات المتحركة والغواصات الباليستية تمنح قدرة عالية على المناورة، بينما يقلص الوقود الصلب زمن التحضير من ساعات إلى دقائق، مما يحدّ من فعالية الإنذار المبكر.
أما المنشآت الكورية الثابتة، مثل يونغبيون، فهي محصنة بعمق وبعضها تحت الأرض أو في تضاريس جبلية، مما يجعل استهدافها بدقة أمرا بالغ الصعوبة، مع بقاء خطر الرد النووي قائما إذا فشلت الضربة. لذلك، تبقى أي إستراتيجية يابانية للضربة المضادة ضد كوريا الشمالية مقيدة بشدة، وحتى الصواريخ فرط الصوتية أو أنظمة التوجيه المتقدمة لن تضمن تحييد الترسانة بالكامل في وقت قصير.
يؤكد ذلك ماساشي مورانو، الزميل الباحث في معهد هدسون الأميركي، إذ يرى أن قدرات اليابان الحالية، أو المخطط لها، تعتمد حصريا على أنظمة صاروخية تقليدية في ظل افتقارها للأسلحة النووية، وهو ما يجعل تحقيق الردع الفعّال ضد خصم مسلح نوويا، مثل الصين أو كوريا الشمالية، هدفا بالغ الصعوبة، حتى مع تحقيق تقدم ملحوظ في قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والاستهداف وتقنيات التوجيه الدقيق.
يعود ذلك، بحسب مورانو، إلى أن تنفيذ ضربة “قيمة مضادة” باستخدام قوات تقليدية، وبمستوى تدمير يقارب الأسلحة النووية، سيتطلب كميات هائلة من الذخائر ومنصات الإطلاق، وهو أمر شبه مستحيل للقوات اليابانية، التي تعاني أصلا من نقص حاد في مخزونات الذخيرة.
صراع مع فجوة الجاهزية
أما الصين، فإلى جانب أصولها النووية، تمتلك ترسانة صاروخية ضخمة تغطي معظم شرق آسيا والمحيط الهادي، مدعومة بتفوق جوي وبحري، يتجلى في حاملات الطائرات وأسطول حديث من المدمرات والفرقاطات.
في مواجهة هذا الخلل المتزايد في ميزان القوى، تعوّل اليابان على توجيه ضربات صاروخية بعيدة المدى، لتعطيل قدرات الخصم ومنصات إطلاقه في وقت مبكر جدا من أي صراع، بهدف شراء الوقت وتعقيد حسابات التصعيد لديه، قبل أن يتمكن من تنفيذ ضربة افتتاحية حاسمة.
لكن هذه المقاربة تثير تحديات سياسية وأمنية، إذ أعربت الصين عن معارضتها لنشر اليابان صواريخ طويلة المدى في كيوشو، محذّرة من أثرها المزعزع للاستقرار. كما أن تموضع هذه الصواريخ في الجزر الجنوبية يجعلها أهدافا مبكرة في حال نشوب مواجهة، وهو ما يثير مخاوف المجتمعات المحلية التي تخشى أن تتحول مناطقها إلى الخط الأمامي للنزاع، وتطالب بضمانات أمنية وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ قرب مواقع الإطلاق شرطا للقبول بها.
فضلا عن ذلك، تواجه خطط اليابان الصاروخية تحديات داخلية أخرى، أبرزها احتياج برامج التصنيع المحلي إلى سنوات إضافية قبل دخول الخدمة الفعلية، إذ أشارت تقارير إلى أن نشر نسخة مطوّرة من برنامج القذائف الانزلاقية قد يتأخر عن الجدول المحدد، وهو ما يفرض فجوة زمنية في الجاهزية العملياتية.
هذا التأخير دفع طوكيو إلى اللجوء إلى صفقات تسلح خارجية لتسريع سد النقص، غير أن هذه العقود تواجه بدورها عقبات، مثل تأخّر تسليم بعض الأنظمة، أو اضطرار اليابان لتعديل مواصفاتها كما حدث في صفقة صواريخ “توماهوك”، حيث استبدلت جزءا من النسخ الأحدث بنسخ أقدم لضمان وصولها مبكرا وتفادي اختناقات الإنتاج.
فبحسب تقارير، أبرمت طوكيو عقدا بقيمة 1.7 مليار دولار، لشراء 400 صاروخ كروز أميركي من طراز “توماهوك” فئة “بلوك-5″، لكن رغبتها في تسريع امتلاك هذه القدرة، بدلا من انتظار النسخ الأحدث، دفعتها إلى تضمين الصفقة عددا من الصواريخ الأقدم من فئة “بلوك-4”.
ويتميز “بلوك-5” بمدى يقارب 1600 كيلومتر، وقدرة على التحليق على ارتفاع منخفض، مع إمكانية المناورة لضرب أهداف برية وبحرية عالية القيمة.
ووفقا للخطة المعلنة، ستبدأ مدمرات قوات الدفاع الذاتي البحرية المزودة بنظام “إيجيس” في نشر هذه الصواريخ، اعتبارا من السنة الحالية، على أن يكتمل تسليح جميع المدمرات الثمانية بحلول عام 2027.
علاوة على ذلك، تسعى طوكيو إلى امتلاك صواريخ جو-أرض بعيدة المدى من طراز “جاسم إي آر” (JASSM-ER) الأميركية، وهي صواريخ موجهة يمكن إطلاقها من مقاتلات أميركية مثل “إف-35” و”إف-15″، مع إمكانية تهيئتها للإطلاق من طائرات النقل “كاواساكي سي-2” أو مقاتلات “ميتسوبيشي إف-2” اليابانية.
يُذكر أن مدى “جاسم” يتجاوز 900 كيلومتر، بما يمنح الطائرات اليابانية قدرة على ضرب أهداف بعيدة من خارج نطاق الدفاعات المُعادية، دون مغادرة المجال الجوي الوطني.
كل ما سبق يشير لتحول متسارع في اليابان التي كانت بالأمس القريب تعيش تحت غمامة القنبلتين النوويتين التي أعادت هندسة واقعها الاجتماعي والسياسي نحو الدفاع فقط، لكن طوكيو اليوم لا تشبه طوكيو الأمس، فهي اليوم تطور مخالبها الخاصة، التي لا تنتظر الهجوم فقط كي تدافع عن نفسها، لكنها على الأرجح، ستكون قادرة على الهجوم المباغت، إن احتاجت ذلك.
وبعيدا عن القدرات العسكرية التقنية، فإن مشهد التحول العسكري في اليابان بذاته، له دلالاته الخاصة، التي لا تشير إلا لعالم يتسلح، ويتسلح، ويتسلح، بانتظار الحرب، أو الحروب القادمة.