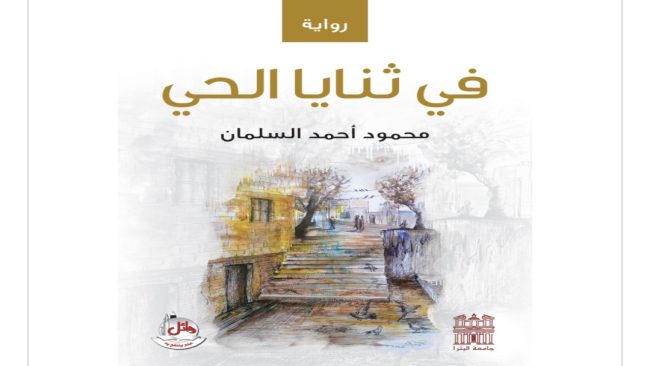بقلم الأستاذة الدكتورة رزان إبراهيم
لن يغفل قارئ روايتي محمود سلمان (في ثنايا الحي) و(مأساة في طيرة حيفا) هذا الإحساس العالي بالمكان والارتباط الشديد به، ولا أبالغ لو قلت إنه كان الدافع أو المحرك لكتابتهما. لا يأتي الحديث عن المكان هنا بصفاته الهندسية، وإنما بصفات نفسية تربط الشخصيات بأمكنة شهدت الكثير من الأحداث.
غير بعيد عن علاقة الروائي بالمكان نلاحظ في (مأساة في طيرة حيفا) مخاوف الانقطاع عن الجذور التي يستند إليها الكيان الإنساني، وهي المخاوف التي يقف وراءها إحساس واضح بالاغتراب كانت له تجلياته الواضحة حين دخل الراوي -غير المنفصل عن الروائي- فلسطين عائدا إليها في زيارة خاطفة، لمسنا خلالها استياء لافتا من دخوله أمكنة يعرفها من خلال قصص الآباء والأجداد، ويعلم جيدا أنها له، لكنه يدخلها كما الغريب؛ وتحديدا حين رؤيته (الزلاقة)، و(شجرة الخروب) التي شهدت جريمة فاقت في مأساويتها كل قصص التراجيديا اليونانية. يدخلها غريبا عليه أن يطرق الباب ليستأذن ويرى ما كان هو محروما من رؤيته:”كم هو قاس أن تدخل بيتك المسروق غريبا، والسارق هو المقيم”. فلا نعجب حينها إذ يجعل من الخروبة ملاذا، أو راية البلد التي تؤكد هوية المكان الحقيقية قبالة رايات كاذبة. ونراه في الوقت ذاته ينأى بقوة عن كل ما هو عبري(جدايل، قبعة، بندقية). والأبرز من هذا كله هذه العودة إلى الوراء إلى البيت القديم بطابونه الذي يعود دافئا، وبأصوات ساكنيه التي تملأ المكان، وبجدرانه وبصور الماضي وتحديدا عام 1948 بكل تفاصيلها الحية. علما أن الراوي والمؤلف يمتزجان ويشتركان في نظام إدراكي واحد.
(في ثنايا الحي) يحضر المكان على شكل لوحات. وهنا أستخدم مفردة الكولاج، التي تعني في الرسم إلصاق شيء على شيء، فالروائي لا يروي حكاية واحدة، وإنما يروي حكايات مختلفة على نحو متتابع يشبه حركة التصوير باستخدام كاميرا يتحكم بها راو أو(الأنا الرائية) التي تتأمل وترى وتصف. وهو ليس بالمكان الكبير، وإنما هو مجتمع صغير. أما قيمته الفنية فتكمن في أن الروائي يركن إليه في عملية شد أطراف الرواية وتماسكها ولملمتها حول نواة واحدة ليكون واحدا من أسباب حبكة مطلوبة في الرواية. وهي الحبكة التي تمكن الروائي من توثيقها من خلال شخصيات مبنية على علاقة التضاد تارة، أو على المجاورة أو الشبه تارة أخرى.
من أمثلة هذه العلاقة التجاورية نستحضر (عصام ومايا) وشخصيات أخرى تمثل جيلا لم ير فلسطين، لكن قلبه ظل معلقا بأعالي الكرمل، وبقي مستعدا للتضحية ومواجهة لص يدعي أن عكا مدينته. عاش زمن الثورة وغنى أغانيها وارتدى قميص جيفارا وراهن على الاتحاد السوفيتي، لكنه يقع في سلسلة من الخيبات مردها ثورة دون خبرة، ورصاص غبي ذهب بالاتجاه الخاطئ. بعض شخصيات الرواية جمعت بين التضاد والمجاورة معا، من مثل(مختار وتغريد)، فقد كانا على النقيض على المستوى الطبقي الاجتماعي، لكنهما يجتمعان ويجدان ما يربطهما. وكذلك كان الحال مع (حنان وزهراء) اللتين تجاورتا بحكم الصداقة، وانتهت حياتهما في مسارين مختلفين، فالأكثر جمالا كانت الأتعس إذ تتزوج من رجل أخرس يكاد يكون ردة فعل على صراخ والدها. أما زهراء فتتزوج من يتقن الكلام. وهو التضاد الذي تظهره الرواية في شخصية الوالدين بالمثل، فكل منهما هو نقيض الآخر في تعامله مع زوجته وعائلته.
غير بعيد عن هذه التناقضات يبرز التحول في الزمن محددا أساسيا في الرواية، كما عائلة أم نصار التي تتحول من الفقر إلى الغنى، وتتمكن من تجاوز أسفل الدرج إلى أعلاه. بينما تنقلب حياة عائلة أبي عماد من الغنى للفقر مع ملاحظة أن انقلاب الأحوال المالية الذي لا يواكبه تعليم لا يلغي سلوكيات معينة تبقى لاصقة (الزواج المتكرر، كثرة العيال..). ولا أدل على هذا التحول من مشهد يعود فيه الراوي عبد الكريم إلى حيه القديم بعد سفر طويل، فنراه كما الواقف على الأطلال وهو يرقب ما تبقى من البيوت؛(إبريق أبو حسني ومكان وضوئه..). ويدفعه الاشتياق إلى أنسنة حارة الدرج ومناجاتها.
يغدو لافتا تكرار الحديث عن البقايا؛ بقايا الأمكنة، وبقايا عصام الذي يمثل جيلا أحس بالخيبة والهزائم والإحباط والخذلان. لم يتبق له سوى حب مايا الذي جعل لحياته معنى: “لم يبق شيء في هذه الحياة مبتسما في وجهي إلا وجه مايا…ذبلت كل الحدائق والورود في حياتي”. نعم لم يبق شيء سوى “صحيفة وقلم وعمود يكتب فيه باسم وهمي”. فكان أن تحول من الرد بالفعل والنضال إلى الرد بالكتابة يتصدى فيها لحالات الصمت التي تقهره؛ صمت الزيتون، البحر، الخروب. يحارب الصمت بقصائد يكتبها على الشجر وقد صار ورقا: “فأنا أستطيع أن أكتب ما رواه أبي، وأقول هذا ما قاله أبي ورآه.. أستطيع القول بقصائدي ما جرى هنا لجدي الحقيقي الذي أحمل اسمه”.
في “مأساة في طيرة حيفا” بدت الطبيعة صديقة للراوي، بما لا ينفصل عن نزعة تاريخية تنظر من خلال الطبيعة إلى حوادث الزمن. يلجأ إليها الراوي شاهدا تتذكر أناسها القدامى الطيبين. كما تدخل في إطار نزعة حيوية ترى في الطبيعة حياة وروحا يخاطبها ويناجيها ويتبادل وإياها الأفكار:”البحر هنا في الطيرة تمنى البحر لو يستطيع الانغلاق عندما داهموه…”. و”الرياح تمنت ألا تسير كما تشتهي السفن”. “البحر حزين وهديره تحول إلى نواح والجبل أكثر حزنا”. ولا ننسى تماهيا هو الأجمل مع خروبة ثابتة ممتدة بجذورها في الأرض.
يلفتك في العملين واقعية الشخصيات بتركيبتها المتنوعة، وكذلك واقعية المكان أو الحي المنقسم بين تحت الدرج وفوق الدرج بعلامات تميز كل منهما؛ (ألوان المراييل المدرسية، الباصات، الحلاق والكوافير، البنطال الممزق). ولكنها في رواية (في ثنايا الحي) واقعية تختلط برومنسية تنتصر أحيانا وتنهزم في أحيان كثيرة. فإن كانت قد انتصرت مع (عصام ومايا) فإنها أخفقت مع (حنان وعبد المجيد) بسبب عقلية سلطوية تعتقد أن المال لا الحب ولا العلم هما الأساس، وتحاول أن تفرض رأيها على الآخرين وتحرمهم حتى من ممارسة حقهم في الحياة كما يشتهون، كما حين رأينا (أبو حسني) يصادر حق زوجته وابنته بالبكاء بعد الشتيمة.
في قراءتنا للمنجزين السابقين، نتوقف لنتذكر شيئا يخصنا يشبهنا ويحيلنا إلى جذورنا. نتبنى صور الراوي التي تذكرنا بأمكنتنا الأليفة التي تحضر معها شهادة وجدانية مؤثرة: “في مأساة في طيرة حيفا” حضرت بقوة في مشهد ينقل جريمة كبرى ارتكبت عام 48. يحضر فيه الأب أبو خليل مصمما على البقاء مرددا:”نبقى هنا نحيا ونموت معا”. في هذا اليوم الذي يحفر في ذاكرة الراوي لم يرسل الأب أطفاله لبيت جدتهم خوفا عليهم من القصف، خبأتهم الأم في مغارة، خرجوا منها، حممتهم، تناولوا فطورهم. خرجوا إلى فناء البيت بشعورهم المبللة يلعبون بكرة مصنوعة من قماش وجوارب طويلة؛ ثلاثة أطفال مع صديق لهم. تنفجر القذيفة في أجسادهم البريئة النظيفة فتسرق فرحتهم باللعب؛ (خليل، يموت سريعا حتى حقه في البكاء يغتال)، (عيسى، ينزف ساعة ويموت)،( رومية، تستشهد بعد أسبوع)، (الأم تصاب وكذلك سميحة البنت الكبرى تنزف وتصاب برأسها ورجليها)، (ينجو الأب الذي كان خارج البيت وابنة أخرى زريفة)، (الكرة التي لعب الأطفال بها تتدحرج ولا تجد من يلتقطها). أما من نجا بجسده فإن روحه لم تنج من ألم هذه المأساة.
مع هذا المشهد يصح الحديث عن جماليات الألم التي نقلت تجربة مريرة مع ألم لا يطاق، ويصح الحديث عن كتابة فيها رتق لشقوق الروح، غايتها إعادة تثبيت مفقود آلم الراوي فقده. ولكأن الفنان هو المنوط بتصوير ألم الحياة الذي وإن كان سببا في فعل البوح والكتابة، فإنه كان السبب في صمت الأب الذي نأى بنفسه عن الحديث عن هذه المأساة مدة تمتد إلى لحظة يقطع فيها الصمت قرب شجرة تشبه الخروب. تتصاعد درجة الوجع في الرواية لتبلغ ذروتها مع نهاية تستحضر الأطفال الذين استشهدوا في القرية؛ (خليل وعيسى ورومية). يتخيلهم الراوي في الباحة بين الخروبة والمغارة، وكأنها حالة رتق بعد فتق، ينبعث معها الفنيق عائدا من جديد، فها هو خيط الدماء خلف أذن خليل يعود لجسده ويلتحم مع باقي دمائه في الجسد الصغير، وتخرج الشظية من الأذن التي اخترقتها، وتعود أحشاء عيسى إليه من جديد، ويكمل خليل ابتسامته، ويعود الأطفال بشعرهم المبتل:”يعود كل شيء كما كان حتى يبعث بينهم أخا جديدا لم يعرفوه ولم يعرفهم. أكبر منهم سنا لكنه أصغرهم”. وإن كان الغريب قد اغتال طفولتهم وجمد أعمارهم، فهم يرقدون آمنين في قبور لهم حمتهم من التشرد ومن القهر وأبقتهم طيراويين كما ينبغي لهم أن يكونوا.