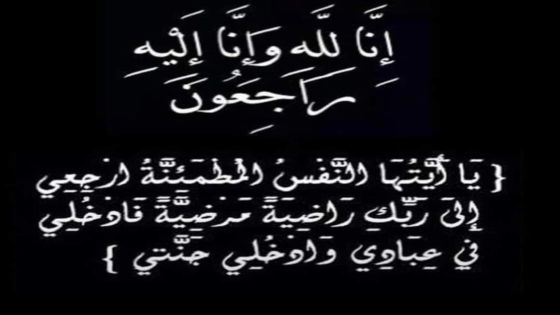سمير الرفاعي
• برزت فئة قليلة لكن ظاهرة، تضرب عرض الحائط بالقوانين والأعراف والقيم، في مقابل أغلبية ملتزمة لكن صامتة
• المجتمع الأردني متمدن متحضر يعلي شأن القانون ويلتزم به، والعشائرية التي هي إحدى أهم ركائز المجتمع، بريئة من العيب
• الأردني نسيج فريد قادر على أن يحب ويحترم الجميع ويشعر بالانتماء إلى هذه العباءة التي تحمل اسم الأردن
• الأردن الحديث لم يكن رهنا لشكل واحد من النمط الاجتماعي
• دور المرأة القيادي والقوي يتراجع رغم زيادة الحديث عن تمكين المرأة
• لا نقبل أن يصبح طلب العلم نقيصة، والاطلاع على ثقافات الأمم عيبا
• لا يمكن أبدا أن يكون الأردنيون ممن يتغنون بالعصبيات الضيقة
• عمان كانت قرية، وجل أهلها اليوم من أبناء الطفيلة ومادبا وعجلون والخليل وغيرها من بقاع الأردن والمعمورة
• في عمان، مثل جميع مدن المملكة، أحياء فقيرة، ومناطق لا تتلقى حقها من الخدمات، كما في معان واربد والسلط أحياء فقيرة وأخرى تملؤها البيوت الفارهة وتشقها الطرقات الواسعة
• لا أخطر على الدول من انقسام مجتمعاتها
• إن قصرت الدولة بات محكوما على ابن المدرسة الحكومية بالفشل ومريض المستشفى العام بالموت
• أول خطوات حل المشاكل هي الاعتراف بوجودها
• غياب خدمة العلم والتوزيع في الجامعات أوقفا التلاقي والتعارف
• لا كرامة لمن لا يعلي كرامة وطنه، ولا عزوة لمن لا يستند إلى إرث وطني راسخ وجامع
• غضب الناس الذي ينفسون عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجل لمشكلة حاولنا تجاهلها طويلا
• ما نشهده من نزاعات مجتمعية لا تصلح معها الفزعات ولا المهدئات
مصادفة طيبة شاءت أن يأتي نشر هذه السطور متوافقا مع مرور ١٠٠ عام على وصول جلالة الملك المؤسس طيب الله ثراه إلى معان في ٢١ تشرين الثاني ١٩٢٠، لتلتف حوله عشائر الأردن وأحرار العرب إيذانا بنشأة هذا الوطن الذي بناه وحماه الأردنيون رغم كل التحديات، بتمسكهم بقيمهم والتفافهم حول قيادتهم.
لذلك فمن المستغرب أن يدور طوال أيام جدل مقلق، وُضع فيه المجتمع الأردني عموما والعشيرة الأردنية خصوصا موضع اتهام، وانقسم المتجادلون إلى من يحاول أن يلصق بالعشائرية تهما وادعاءات غير صحيحة، فيما أخذت الجهالة قسما آخر إلى اعتبارها أمرا واقعا بل ومدعاة للتفاخر بكل أسف، وكانت النتيجة إساءة فادحة وغير محقة للأردن والأردنيين.
هذا الجدل دار حول ما جرى بعد الانتخابات من تجاوزات على القانون وأوامر الدفاع، وبالتالي على هيبة الدولة وصحة المواطن وأمنه، وهي للأسف ما قال البعض أنها مظاهر اعتيادية، وأنه لا يمكن لوم الناس على إظهار الفرح.
وهي حجة قد تدغدغ مشاعر البعض، لكنها كالسم في الدسم، فالواقع أظهر اختلافا وانقساما في المجتمع، برزت فيه فئة قليلة لكن ظاهرة، تضرب عرض الحائط بالقوانين والأعراف والقيم، في مقابل أغلبية ملتزمة لكن صامتة. وباتت الأسر الأردنية تتوزع بين قسم يجتهد في تعليم أطفاله ضرورة الالتزام بالقانون وتحمل تبعات الحظر، وأهمية وسائل الوقاية والتباعد، ليروا بعدها أطفالا من قسم آخر يحملون أسلحة أتوماتيكية وسط مئات من المتجمهرين المخالفين للقانون.
حجة ثانية كانت الاستسلام لفكرة (إحنا هيك) والضغط باتجاه أن هذه التصرفات هي موروث لا يقبل النقد، ولا يجوز التعامل معه كجرم يستحق العقاب، بل كمسألة تحتاج العلاج المتأني في أحسن الأحوال، أو تستحق الاحترام والإشادة في أسوئها، وفي كل الأحوال تم تعليق ذلك على مشجب العشائرية وتوجيه الاتهام للمجتمع.
والواقع أن المجتمع الأردني متمدن متحضر يعلي شأن القانون ويلتزم به، والعشائرية، التي هي إحدى أهم ركائز المجتمع في وطننا، بريئة من العيب، فالأردن الذي جمع بحكم الجغرافيا بين ثقافتي البدوي والفلاح، تشربت عشائره بأفضل ما لدى الطرفين، وبنت هذا الوطن بتمازج فريد بين الموروث العشائري القيمي، والتمدن المستند إلى القانون، وبحكم اجتماع أصول ومنابت شتى على هذه الأرض، أصبح الأردني نسيجا فريدا قادرا على أن يحب ويحترم الجميع ويشعر بالانتماء إلى هذه العباءة التي تحمل اسم الأردن.
لكن مع نمو المجتمع وتلاقح الثقافات خاصة في عصر المعلوماتية هذا، كان لا بد لأمراض الحضارة أن تظهر، فكان منها مثلا مسألة المبالغة في المظاهر الاجتماعية، وهي مشكلة جديدة نسبيا لم يكن الأردنيون يعرفونها حتى وقت قريب، فهذا البذخ والأعداد الضخمة التي أصبحت تلازم مختلف مناسباتنا الاجتماعية أمر غريب علينا كما أنه غير صحي، وله تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
الأردن الحديث الذي يعيه أغلبنا لم يكن رهنا لشكل واحد من النمط الاجتماعي كما يكاد يكون اليوم، ولا كان الإقصاء المبني على التنميط من شيم أهله، والأهم من ذلك أننا يوم اخترنا التنميط وبدأنا الإقصاء على أساسه، اخترنا الأنماط الخاطئة والتي استوردنا كثيرا منها دون تمحيص في أصولها وملاءمتها لثقافتنا.
فثقافة الأردني لم تكن يوما مبنية على العصبية الضيقة، ولا تميل إلى الفج من التصرفات والطباع، بما فيها الذوق العام الذي تميز دائما بالرقي، فكان الذوق الشعبي الأردني يرتبط بفيروز ونجاة الصغيرة، وكانت الأغنية الشعبية تؤديها قامات مثل سميرة توفيق وعبده موسى، وكانت الأغنية الوطنية تستدعي غرفة عمليات على أعلى مستوى قبل إجازتها وبثها، فتبقى عالقة في الذهن حاضرة في الوجدان لعقود، لا كأغنيات التفاخر بالعنف التي تصم أذاننا هذه الأيام وتزول دون خير يذكر.
الأردن الذي غنت له فيروز، وتنافس كبار الشعراء على مدحه أرضا وشعبا وقيادة، وكنا وما زلنا نفتخر فيه بأول سفيرة وأول وزيرة، وببناته اللواتي يجبن الأرض رافعات اسم الوطن بجهدهن ونجاحهن الآتي من رحم المجتمع وقيمه، لا نقبل له أن تُحصر سيداته في الكوتا للوصول إلى مجالس النواب أو البلديات بعد أن وصلت العديد منهن إلى هذه المواقع خارجها، فبات دور المرأة القيادي والقوي يتراجع رغم زيادة الحديث عن تمكين المرأة.
الأردن الذي كنا وما زلنا نفخر بأنه قادر، رغم شح الإمكانات، على أن يبتعث أبناءه وبناته، وخيرة ضباطه وموظفيه إلى أرقى المعاهد العالمية لطلب العلم والاستزادة من المعرفة، لا نقبل له أن يصبح طلب العلم فيه نقيصة، والاطلاع على ثقافات الأمم عيبا.
الأردن الذي فتح أبوابه وقلوب أبنائه، للقاصي والداني ولكل مكروب ومظلوم، لا يمكن أبدا أن يكون أبناؤه ممن يتغنون بالعصبيات الضيقة ويتنافسون في مظاهر لا يمكن وصفها إلا بالمشينة.
وجزء من هذه العصبية الضيقة ما نراه من تعنصر مناطقي، وظهور مصطلح “أبناء الحراثين” عند البعض، بينما نحن جميعا ومن كل أصل ومنبت، كنا بدوا وفلاحين وحراثين حتى عهد قريب، وإن استدعت حاجة الوطن فكلنا جنود له وسنعود حراثين لأرضه.
ثم جاء التصنيف إلى أبناء محافظات وأبناء عمان، حيث يتناسى دعاة هذه العصبية أن عمان كانت قرية حتى وقت قريب، وأن جل أهلها اليوم هم من أبناء الطفيلة ومادبا وعجلون والخليل وغيرها من بقاع الأردن والمعمورة، من القوقاز حتى موريتانيا. وأن في عمان، مثل جميع مدن المملكة، أحياءا فقيرة، ومناطق لا تتلقى حقها من الخدمات، تماما كما في معان واربد والسلط أحياء فقيرة وأخرى تملؤها البيوت الفارهة وتشقها الطرقات الواسعة، وهذا حال كل دول ومدن العالم.
ثم تجاوز دعاة هذه العصبية إلى اعتبار مختلف الموسرين من أبناء البلد، هدفا مشروعا لكل تهمة، وكأن من وسع الله له في رزقه، أو اقتدر على طلب العلم خارج البلاد، أو استطاع أن يسافر ويطلع على ثقافات الأمم، بات لا يشبهنا وليس منا، أو أن ما أنعم الله به عليه هو تهمة وجريمة، لنجد أنفسنا أمام مجتمع منقسم ومتهم، بعد أن كنا محط أنظار الجميع بالتمدن والتحضر والتآلف، ولا أخطر على الدول من انقسام مجتمعاتها، فما بالكم لو كان هذا الانقسام مبنيا على باطل.
وإن كان في عمان، التي تضم قرابة ربع سكان المملكة، أو غيرها من بقاع الوطن من تجاوز على القانون أو أثرى بغير حق أو ارتكب أي جرم على أي شبر من أرض الوطن، فواجبنا أن نلاحقه قانونيا دون أن نعمم التهم على أهله ومنطقته وعشيرته دون حق.
وهنا لا بد أن نقول: كما أن الفقر ليس عيبا، فإن الغنى ليس تهمة إلا إن كان من باطل، وكما لا يعيب أي منا أن يرسل أبناءه إلى مدرسة حكومية أو يعالجهم في مستشفى حكومي، فلا يميزه أن يرسلهم إلى مدرسة خاصة أو يعالجهم في مستشفى خاص، إلا إن قصرت الدولة وبات محكوما على ابن المدرسة الحكومية بالفشل أو مريض المستشفى العام بالموت، وهي أمور تستوجب الوقوف عندها واستجلاء مقدار ما فيها من حق أو باطل، لنحدد كل مشكلة وأسبابها ونعمل على حلها.
وأول خطوات حل المشاكل هي الاعتراف بوجودها، فالواسطة والمحسوبية مشكلة، وانعدام العدالة في توزيع المكتسبات مشكلة، والبطالة المقنعة في القطاع العام مشكلة، وسياسة الاسترضاء في توزيع الخدمات التي تنتهي بحرمان مناطق لحساب مناطق أخرى مشكلة، والتوسع في حجم القطاع العام والهيئات المستقلة مشكلة، واستغلال الوضع الاقتصادي الذي نعانيه في ظل وباء كورونا للتفرقة بدل الاجتماع مشكلة، وتلاشي الطبقة الوسطى التي تشكل ميزان أي مجتمع والقوة المحركة فيه مشكلة، ولعل من أكبر مشاكلنا غياب الشفافية والمكاشفة والتقصير الرسمي في إيصال المعلومة، حيث يفاجأ المواطن بحجم المديونية أو تضخم عجز الموازنة وسواها من مسائل دون أن يعرف التفاصيل الحقيقية والكاملة لذلك، فتأخذه الظنون.
أما أن يعتبر وجود الاختلاف والتفاوت، وهما من سنن الله في خلقه، مشكلة وسببا للتباغض والتعنصر، ويستغلهما البعض، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ليشق صف الأردنيين، فهذا مما لا يقبله العقل. ولنا في الموروث الإسلامي خير مثال، حيث كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو عظيم الثراء كما منهم من هو شديد الفقر، رضي الله عنهم.
ثم كيف لمجتمع تجد فيه الزوج من البلقاء وأخواله من الزرقاء، والزوجة من القدس وأخوالها من معان أن ينقسم، وكيف للمجتمع الذي قرعت أجراس كنائسه في مواعيد السحور والفطور أن يتعنصر ضد ذاته؟ ما الذي حدث في غفلة منا حتى نصل إلى هذه النقطة؟ هل هو غياب خدمة العلم التي كانت تخلط كل أبناء البلد من شتى الأصول والخلفيات وتجعلهم سواسية في المأكل والمشرب والملبس لأشهر طويلة؟ أم هو غياب التوزيع في الجامعات حتى بات أبناء كل إقليم مغلقا عليهم في جامعات إقليمهم، فتوقف التلاقي والتعارف الذي يجعلنا ندرك أن لا فرق بين ابن عمان ومعيشته عن ابن العقبة ومعيشته، كما لا فرق بين ابن المفرق ومعيشته عن ابن الرمثا ومعيشته؟
وانتهى بنا الحال بنسيان الهوية الأردنية الوطنية الجامعة، لحساب هويات ممزقة، ولم نتوقف عند عنصرية الجهة أو الطبقة، بل بالغنا في التضييق حتى باتت العنصرية أسرية ومناطقية، ولن يطول بنا الحال حتى نرى عنصرية فردية يتعالى بها الفرد على وطنه ومجتمعه، متناسيا أن لا كرامة لمن لا يعلي كرامة وطنه، ولا عزوة لمن لا يستند إلى إرث وطني تاريخي راسخ وجامع.
إن النقاش الدائر، وغضب الناس الذي ينفسون عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس إلا تجليا لحجم المشكلة التي حاولنا تجاهلها طويلا، وها هي تصفعنا اليوم جميعا، وللأسف بدل النظر في حلول جذرية ألهينا أنفسنا بالقشور، ولجأنا للفزعة التي ستنقضي دون أثر. فهل هذه رسالتنا التي نعبر بها نحو المئوية الثانية؟
إن ما نشهده من نزاعات مجتمعية لا تقل في حجمها وصفتها عن الكوارث، التي لا تصلح معها الفزعات ولا المهدئات. وإن لم نسع سريعا وحثيثا لتطويقها وإنهاء تبعاتها، عبر تكريس سيادة القانون، والتوزيع العادل للمشاريع التنموية، والخدمات العامة في جميع المحافظات، وإيجاد فرص حقيقية للشباب، والاعتماد على رأس المال الوطني، وإقامة مشاريع كبيرة ومستدامة، وتخفيض الضرائب والرسوم وأسعار الطاقة والمياه، ودعم مؤسسات القطاع الخاص، وتشجيع تشغيل الأيدي العاملة الوطنية بمنح الحوافز لمن يشغلها، وتعظيم ما بيننا من جوامع، وزرع الروح والهوية الوطنية في كل قلب وبيت، فإننا سنعبر نحو المئوية الجديدة من عمر الدولة محملين بوزر رأب شروخ المجتمع، بدل توظيف وحدته نحو مزيد من البناء والإنجاز.
أقول هذا بين يدي الأردن الذي يشبهنا ولا يشبهه أحد، الأردن الذي نراه ونعرفه في وجه فلاح لوحته الشمس، وموظف حكومي يتشرب وجهه بالحمرة، في مغازل صوف الجدات، ودفاتر جامعات الحفيدات، في بدوي اسمه لورنس، ومسيحي اسمه علي أو عمر، في عقباوي أشقر الشعر أخضر العينين، وشركسي أسمر يتحدث بلهجة العبابيد، في شابة تعمل دليلا سياحيا في البترا، وعامل وطن يفتخر بخدمته لمجتمعه، وشاب مغترب لم ينسه النجاح الذي حققه في الخارج أهله ولا وطنه.. هذا الأردن الذي يشبهنا ومن أجله يجب أن نظل الأردنيين الذين يحمونه بالروح ويحملونه في شغاف القلب.
حفظ الله الأردن وأهله وقيادته من كل سوء