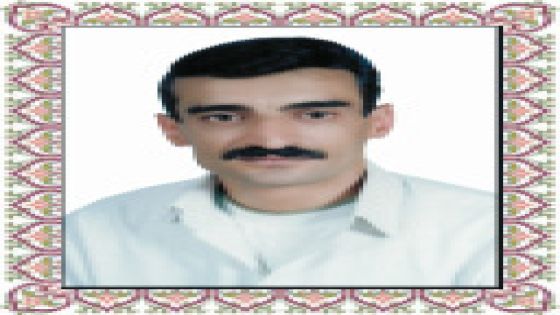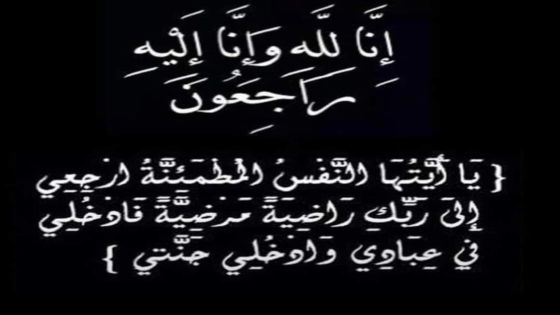بقلم عمار بوايزه
يُتعبنا كثيراً التّغني بأناشيد الزَّمن الجميل ، وتُزمجرُ فينا قهقهة الأيام المرتدة عبر تلعثم الذّكريات بسنابلِ القمح الممتدّة في أرواحنا الحائرة ، وتَنحتنا تلك الصخور التي تُطوّقُ أُفقنا ، وتسلبُ بعضَ حُزننا الجاثم على صدورنا ، لتصرفهُ عبر تنهُّداتِ الطين المَحشوّ بين حجارة فكرنا المرصوفة على جدران الزمان ؛ يغلبنا الوقتُ ونحنُ نُقلقلُ ظلام مسالكنا لنُخرِجَ من لدُنّا أيقونة فرحٍ ، ونَبتَزُّ ليالينا الواقفة على مسافة قبرٍ منّا ، لتُخرجَ لنا من الأجداث ما يؤنسُ بؤسنا ، ويمسحُ نوائبنا المتفشية بين حُجراتِ قلوبنا الواهية اللاهية ، حينما تعثَّرت قوافلنا ، ونحنُ نُسافرُ بنا إلى عالمٍ آخر غير عالمنا.
الزَّمنُ الجميلُ ليسَ أولئك المتحللون في جوفِ الأرض ، ولا تلك الفؤوس التي تُشرقُ الشَّمسُ على أنغامها ، ولا كؤوس الفخّار التي زخرفتها قسوة الحياة ، وجلّتها مياهُ الينابيع المتدفِّقةِ من قلب الأرض ؛ ولم يكن الزمن الجميل أبداً حلقة النار التي يلتفُّ حولها الصغير والكبير في بيت العائلة ، فتشدُّهم بحبالِ لهبها بميثاق حبٍّ ورباط مودة ، لا ينالُ منهم بردُ شتاء ، ولا يستنزفُهم حرُّ صيف ؛ وما كان الزمنُ الجميلُ ذلك الشَّغب العفوي ، الذي ترسمه ملامحُ البساتين والطُّرقات ، وهي تُلبي أصداءهم ونداءاتهم وغناءهم وحُداءهم ، فتراها تفتقدُ إطلالتهم وحنوِّ نظراتهم ، فتحزنُ لمصابهم وتفرحُ لفرحهم ؛ وليس هو رائحةُ خبز الطّابون ، التي تستنشقها حيطان القُرى ومداخلها في صورةٍ تعكسُ لذّة انتزاع مذاق العيش من قلبِ الرَّماد.
الزَّمنُ الجميلُ مسرحيّةٌ شيِّقة ، نستأنسُ بأبطالها وشخوصها وجمهورها ، ويأخذنا الشَّجن والحنين وربّما البكاء ، حينما نستعرضُ أحداثها على أثير الذّكريات ، ويأخذنا الطوفان إلى جزيرة الذّاتِ ، وقد لبسناً زمناً آخرَ ، وتَجرَّدنا من الأصول والقيم الحميدة ، ووقفنا على الهوامش ؛ تلك مسرحية لم يعشْ أبطالها إلا حياة العوز والفاقة في المأكل والملبس ، فترى أحدهم يلتفُّ بمعطفٍ بالٍ يقيه برد الشتاء القارص ، ثم يلتحفه في الليل ليلخلدَ فيه الى فقره وبؤسه وشقائه ، أو ينتعلُ حذاءً من جلد بعير أو من مخلَّفات جنود الحروب العالمية ، يشتريه من “البالات” ؛ لم يكن أولئك يعرفون البذخ والثراء والتّمرُّد على الرزق ، وحتى الجيل الذي خرج من أصلابهم بعد سنين ، لا زالَ على ذاتِ الحال بالعموم ، وإنْ اغتر بمظاهر الحياة ومكياجها ، واستحوذت عليه اكسسواراتها الفاتنة ؛ الجميلُ في تلك الحقب أنّهم كانوا سعداء رغم كل شيء ، ونحنُ نبحثُ عن السعادة في كل شيء ولم نجدها بعد.
أولئك قومٌ جابوا الأرض حُفاة عُراة ، فما تركوا وادٍ ولا شِعبٍ إلا ولأقدامهم فيه نقشٌ من كفاح ، “زادهم في الصُـرّة وماؤهم في الجـرَّة” ، ولدوا على فطرة الخير والسّخاء والنخوة والخلق الكريم ، وامتشقوا معاول البركة والرضا ؛ ونفثوا ريحهم الطيب في الأنحاء والحواري والبيوت ، وما انغمسوا في صغائرِ الدًّنيا ، ولا سعوا لبُهرجها ؛ لقد كانوا على السواء في المجمل العام ، مصدر الرزق واحد والعمل واحد ، فلا طبقية مقيتة تفرقهم ، ولا ثراء فاحش يجعلُ أحدهم مملوكاً لغيره ، وإنْ حدث ذلك ، فقد كان على نطاقٍ ضيّق جداً ؛ ولكن ذلك لم يُجرّدهم من عاداتهم النبيلة ، التي جعلتهم كالبنيان المرصوص ، يشدُّ بعضه بعضاً.
لقد كان أولئك الآباء والأجداد رغم عناد الحياة وانكساراتها وتقلّبِ أحوالها مدرسةً في إدارة الاقتصاد ، ذلك الاقتصاد البسيط القائم على ما تزرعه أيديهم ، وما يوفّرهُ عنائهم وعرقهم وإصرارهم العجيب على مجابهة الحياة لأجل الحياة ، يبتسمون لزخّاتِ المطرِ ، ولا يقنطونَ من سعة رحمة ربّهم ، لا مسَّتهم سنينَ المحل ؛ فتجدهم ، لا طالهم ضنكٌ أو استبد بهم جور الليالي ، يجترّون مؤنهم مما كانوا قد خزّنوه في صوامعهم “الكواره” وغيرها من خيراتٍ وفيرة ، ولا يتشاكون أو يتباكون ، ولا يستجدون استجداء الأعرابي لمعن بن زائدة: “فجُدْ لي يا ابن ناقصةٍ بمالٍ” ؛ فسبحان الذي ألهمهم كيف يضربوا أروع الأمثلة ، وقبل عقودٍ طويلةٍ من الزَّمان ، ويثبتوا بأنَّ التخزين من أهم عوامل قوة الاقتصاد.
اليومُ ، ونحنُ قد ودَّعنا ذلك الزمانُ بكلِّ إرثه وموروثه الجميل ، نركنُ الى محاجرنا ونوباتِ حُزننا ، لنبعثَ فيها موشّحات الحنين ، وروايات الأماكن ووقفات البشر ؛ وقد نسينا أنَّ الزَّمنَ ليس هو علّتنا ولا مصيبتنا ، فالزمنُ لا يتغير لكنه يتقدَّم ، ويفرضُ سُبلاً ووسائلَ ومعطياتٍ جديدة ، ويضعنا أمام أنماط أكثر حداثة في المأكل والملبس والمسكن ؛ نسينا أنَّ الأرضَ هي ذاتها الأرض ، والسَّماءُ لا زالت هي السَّماء ، وأن خالقَ الكون منزَّه عما عليه البشر ، تتغير كُل الأشياء في الوجود ولا يتغير ، وتبقى رحمته للبشرية جمعاء ، وسعت وتسع كل شيء ؛ نسينا أنَّ نلوِّن قلوبنا ونفوسنا وأرواحنا بذلك الإرث العظيم من المعاني العظيمة والأخلاق العالية ، التي تجذَّرت في الأقدمين ، فرُحنا نسير وراء لوحة الحياة البرّاقة ، وتلونَّا بألوانها وصورها وحُللها الزاهية ، حتى خدشنا تلك العادات الاصيلة ، وتفرَّقنا شيعاً ، وضاقت علينا الأرضُ بما رَحُبت.
ما نسميه الزمن الجميل ، ليس إلا أنشودةٌ نتغنى بها ، لا شاكنا الحنين أو قرص وجنتينا الدمع ؛ فلو أمعنا التفكير قليلاً في ذاتنا لوجدنا أنَّنا نحنُ من لوّثَ الزَّمن ، وأنَّ قلوبنا وأنفسنا انشقَّت ، لا بل تنصّلت من كل ما هو جميل ، وغزاها عامل الشر والبغضاء ، واجتاحتها أمواج الحسد والضغينة ، حتى أصبح الواحد منّا يحسدُ نفسه على نفسه ؛ فكيف بعد كلِّ هذا نقف لنعلّق الاتهامات على زماننا الذي نعيش ، مُردّدين “لكل زمانٌ دولة ورجال” ، ونلقي باللوم على حقولنا ، التي غابت عنها سواعد الخير ، وأصابها القحط واليباس ؛ فالبركة في العيش لم تأتِ من الزمن الجميل ، بل جاءت من الخيرية التي استوطنت قلوب من عاشوا ذلك الزمن وعاصروه ، فإذا انتفى الخير في شيء ، وتغيّر المقصد عن بوصلة الحق زالت البركة.
يُتعبنا كثيراً التّغني بأناشيد الزَّمن الجميل ، وتُزمجرُ فينا قهقهة الأيام المرتدة عبر تلعثم الذّكريات بسنابلِ القمح الممتدّة في أرواحنا الحائرة ، وتَنحتنا تلك الصخور التي تُطوّقُ أُفقنا ، وتسلبُ بعضَ حُزننا الجاثم على صدورنا ، لتصرفهُ عبر تنهُّداتِ الطين المَحشوّ بين حجارة فكرنا المرصوفة على جدران الزمان ؛ يغلبنا الوقتُ ونحنُ نُقلقلُ ظلام مسالكنا لنُخرِجَ من لدُنّا أيقونة فرحٍ ، ونَبتَزُّ ليالينا الواقفة على مسافة قبرٍ منّا ، لتُخرجَ لنا من الأجداث ما يؤنسُ بؤسنا ، ويمسحُ نوائبنا المتفشية بين حُجراتِ قلوبنا الواهية اللاهية ، حينما تعثَّرت قوافلنا ، ونحنُ نُسافرُ بنا إلى عالمٍ آخر غير عالمنا.
الزَّمنُ الجميلُ ليسَ أولئك المتحللون في جوفِ الأرض ، ولا تلك الفؤوس التي تُشرقُ الشَّمسُ على أنغامها ، ولا كؤوس الفخّار التي زخرفتها قسوة الحياة ، وجلّتها مياهُ الينابيع المتدفِّقةِ من قلب الأرض ؛ ولم يكن الزمن الجميل أبداً حلقة النار التي يلتفُّ حولها الصغير والكبير في بيت العائلة ، فتشدُّهم بحبالِ لهبها بميثاق حبٍّ ورباط مودة ، لا ينالُ منهم بردُ شتاء ، ولا يستنزفُهم حرُّ صيف ؛ وما كان الزمنُ الجميلُ ذلك الشَّغب العفوي ، الذي ترسمه ملامحُ البساتين والطُّرقات ، وهي تُلبي أصداءهم ونداءاتهم وغناءهم وحُداءهم ، فتراها تفتقدُ إطلالتهم وحنوِّ نظراتهم ، فتحزنُ لمصابهم وتفرحُ لفرحهم ؛ وليس هو رائحةُ خبز الطّابون ، التي تستنشقها حيطان القُرى ومداخلها في صورةٍ تعكسُ لذّة انتزاع مذاق العيش من قلبِ الرَّماد.
الزَّمنُ الجميلُ مسرحيّةٌ شيِّقة ، نستأنسُ بأبطالها وشخوصها وجمهورها ، ويأخذنا الشَّجن والحنين وربّما البكاء ، حينما نستعرضُ أحداثها على أثير الذّكريات ، ويأخذنا الطوفان إلى جزيرة الذّاتِ ، وقد لبسناً زمناً آخرَ ، وتَجرَّدنا من الأصول والقيم الحميدة ، ووقفنا على الهوامش ؛ تلك مسرحية لم يعشْ أبطالها إلا حياة العوز والفاقة في المأكل والملبس ، فترى أحدهم يلتفُّ بمعطفٍ بالٍ يقيه برد الشتاء القارص ، ثم يلتحفه في الليل ليلخلدَ فيه الى فقره وبؤسه وشقائه ، أو ينتعلُ حذاءً من جلد بعير أو من مخلَّفات جنود الحروب العالمية ، يشتريه من “البالات” ؛ لم يكن أولئك يعرفون البذخ والثراء والتّمرُّد على الرزق ، وحتى الجيل الذي خرج من أصلابهم بعد سنين ، لا زالَ على ذاتِ الحال بالعموم ، وإنْ اغتر بمظاهر الحياة ومكياجها ، واستحوذت عليه اكسسواراتها الفاتنة ؛ الجميلُ في تلك الحقب أنّهم كانوا سعداء رغم كل شيء ، ونحنُ نبحثُ عن السعادة في كل شيء ولم نجدها بعد.
أولئك قومٌ جابوا الأرض حُفاة عُراة ، فما تركوا وادٍ ولا شِعبٍ إلا ولأقدامهم فيه نقشٌ من كفاح ، “زادهم في الصُـرّة وماؤهم في الجـرَّة” ، ولدوا على فطرة الخير والسّخاء والنخوة والخلق الكريم ، وامتشقوا معاول البركة والرضا ؛ ونفثوا ريحهم الطيب في الأنحاء والحواري والبيوت ، وما انغمسوا في صغائرِ الدًّنيا ، ولا سعوا لبُهرجها ؛ لقد كانوا على السواء في المجمل العام ، مصدر الرزق واحد والعمل واحد ، فلا طبقية مقيتة تفرقهم ، ولا ثراء فاحش يجعلُ أحدهم مملوكاً لغيره ، وإنْ حدث ذلك ، فقد كان على نطاقٍ ضيّق جداً ؛ ولكن ذلك لم يُجرّدهم من عاداتهم النبيلة ، التي جعلتهم كالبنيان المرصوص ، يشدُّ بعضه بعضاً.
لقد كان أولئك الآباء والأجداد رغم عناد الحياة وانكساراتها وتقلّبِ أحوالها مدرسةً في إدارة الاقتصاد ، ذلك الاقتصاد البسيط القائم على ما تزرعه أيديهم ، وما يوفّرهُ عنائهم وعرقهم وإصرارهم العجيب على مجابهة الحياة لأجل الحياة ، يبتسمون لزخّاتِ المطرِ ، ولا يقنطونَ من سعة رحمة ربّهم ، لا مسَّتهم سنينَ المحل ؛ فتجدهم ، لا طالهم ضنكٌ أو استبد بهم جور الليالي ، يجترّون مؤنهم مما كانوا قد خزّنوه في صوامعهم “الكواره” وغيرها من خيراتٍ وفيرة ، ولا يتشاكون أو يتباكون ، ولا يستجدون استجداء الأعرابي لمعن بن زائدة: “فجُدْ لي يا ابن ناقصةٍ بمالٍ” ؛ فسبحان الذي ألهمهم كيف يضربوا أروع الأمثلة ، وقبل عقودٍ طويلةٍ من الزَّمان ، ويثبتوا بأنَّ التخزين من أهم عوامل قوة الاقتصاد.
اليومُ ، ونحنُ قد ودَّعنا ذلك الزمانُ بكلِّ إرثه وموروثه الجميل ، نركنُ الى محاجرنا ونوباتِ حُزننا ، لنبعثَ فيها موشّحات الحنين ، وروايات الأماكن ووقفات البشر ؛ وقد نسينا أنَّ الزَّمنَ ليس هو علّتنا ولا مصيبتنا ، فالزمنُ لا يتغير لكنه يتقدَّم ، ويفرضُ سُبلاً ووسائلَ ومعطياتٍ جديدة ، ويضعنا أمام أنماط أكثر حداثة في المأكل والملبس والمسكن ؛ نسينا أنَّ الأرضَ هي ذاتها الأرض ، والسَّماءُ لا زالت هي السَّماء ، وأن خالقَ الكون منزَّه عما عليه البشر ، تتغير كُل الأشياء في الوجود ولا يتغير ، وتبقى رحمته للبشرية جمعاء ، وسعت وتسع كل شيء ؛ نسينا أنَّ نلوِّن قلوبنا ونفوسنا وأرواحنا بذلك الإرث العظيم من المعاني العظيمة والأخلاق العالية ، التي تجذَّرت في الأقدمين ، فرُحنا نسير وراء لوحة الحياة البرّاقة ، وتلونَّا بألوانها وصورها وحُللها الزاهية ، حتى خدشنا تلك العادات الاصيلة ، وتفرَّقنا شيعاً ، وضاقت علينا الأرضُ بما رَحُبت.
ما نسميه الزمن الجميل ، ليس إلا أنشودةٌ نتغنى بها ، لا شاكنا الحنين أو قرص وجنتينا الدمع ؛ فلو أمعنا التفكير قليلاً في ذاتنا لوجدنا أنَّنا نحنُ من لوّثَ الزَّمن ، وأنَّ قلوبنا وأنفسنا انشقَّت ، لا بل تنصّلت من كل ما هو جميل ، وغزاها عامل الشر والبغضاء ، واجتاحتها أمواج الحسد والضغينة ، حتى أصبح الواحد منّا يحسدُ نفسه على نفسه ؛ فكيف بعد كلِّ هذا نقف لنعلّق الاتهامات على زماننا الذي نعيش ، مُردّدين “لكل زمانٌ دولة ورجال” ، ونلقي باللوم على حقولنا ، التي غابت عنها سواعد الخير ، وأصابها القحط واليباس ؛ فالبركة في العيش لم تأتِ من الزمن الجميل ، بل جاءت من الخيرية التي استوطنت قلوب من عاشوا ذلك الزمن وعاصروه ، فإذا انتفى الخير في شيء ، وتغيّر المقصد عن بوصلة الحق زالت البركة.