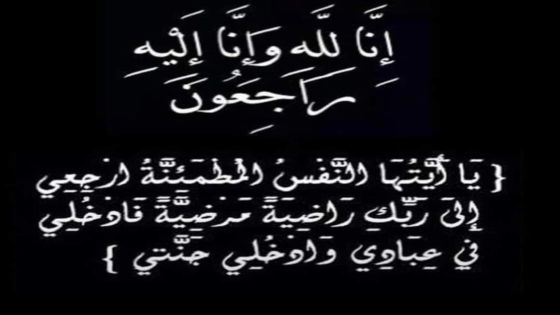د. حفظي اشتية
يُعدّ القائد المناسب من أهم عوامل نجاح أيّة مؤسسة، فهو الذي يخطط، ويشرف على التنفيذ، ويراقب ويحفّز ويقوّم ويصوّب ويعالج ويثيب ويعاقب …. يفعل كلّ ذلك للوصول إلى أهداف المؤسسة النبيلة، وتحقيق النتائج المرضية.
ويحرص أيضاً في كلّ ذلك على أن يكون الأنموذج المثالي أمام موظفيه في صدقه واستقامته ونزاهته وعدالته وانتظامه ومواظبته وتضحيته وتفانيه، لا يأمرهم بأمر ويخالفه، ولا ينهاهم عن أمر ويأتيه، يعزّز الجيد منهم، ويأخذ بيد الضعيف، يجمع بينهم ولا يفرّق، يتصرّف كأنّه واحد منهم، يتواضع لهم، ويسمع شكواهم، ينصرهم على من يظلمهم، ويخفّف عنهم ويحمل همّهم….. ويعاقب المستحق منهم، نعم, يعاقب المستحق، لأن ميزان العدل في الدنيا والآخرة قائم على فكرة الثواب والعقاب، لكنّه عقاب العادل الرحيم، الذي يهدف إلى العلاج السليم، وقسوة الحكيم الذي يهدف إلى التقويم:
فقسا ليزدجروا ومَن يك حازماً فليقسُ أحياناً على من يرحمُ
هذا غيض من فيض الملامح الإنسانية النبيلة التي يجب أن تتوافر في القائد، ليقود مؤسسته نحو النجاح وتحقيق المقاصد.
فإذا انضاف إلى هذه الأخلاق النبيلة الكفايات المعرفية التخصصيّة، والخبرات العمليّة الكافية، نكون في حضرة القائد المناسب، ويبقى أن يوضع في مكانه المناسب لتكتمل المواهب.
ومؤكد أننا نجد في مؤسساتنا ووزاراتنا وجامعاتنا أمثلة كثيرة مضيئة تطابق المأمول السابق، وتعطينا المزيد من الأمل بالمتحقّق اللاحق.
لكننا أيضاً سنجد أمثلة أخرى تثير في النفوس الأسى على واقع سلبي غير مَرضيّ. من ذلك، مثلاً، اختيار أحد اللاهثين وراء بريق المناصب ممّن تقلّ عنده المطالب المُثلى التي استعرضناها للشخصية القياديّة من النواحي التعاملية الأخلاقية، أو المتطلبات العلميّة والخبرات العمليّة، ويتمّ تكليفه ليكون رئيساً لقسم أكاديميّ، أو عميداً لكليّة جامعية، ويكون تخصصه بعيداً تماماً عن التخصصات في تلك الكليّة، كأن يكون تخصصه في الطب أو الزراعة أو الحاسوب، ويُكلّف بعمادة كلية معظم تخصصاتها في القانون أو اللغة الإنجليزية، أو اللغة العربية، فكيف سيستقيم الحال؟ وكيف سيتم تجاوز الفجوة الحاصلة لا محالة بين العميد والمدرسين؟ وهل يكون هذا العميد على دراية كافية بإشكالات التخصصات وأساليب التدريس وطرق التقويم وأنواع الامتحانات ومعايير العلامات……؟ وكيف سيتحمل عضو الهيئة التدريسية في تخصص اللغة العربية, مثلاً, أن يتلقّى كتاباً من عميد كليّته لا يكاد يكون له أدنى علاقة بفصاحة اللغة العربية، أو سلامة قواعدها، أو نصاعة أساليبها وبيانها؟!
بل تصل الحال أحياناً إلى أنّ هذا العميد قد يكتب سطراً واحداً على كتاب رسميّ شارحاً أو مُحيلاً، فتئنّ اللغة العربية من وطأته، وفُحش أخطائه!! فلِمَ الإصرار على وضع عميد غير مناسب في مكان غير مناسب، فلا نظفر بأيٍّ من الحُسنيين؟!
أليس من الأولى أن يُعيّن مثل هذا عميداً لكليّة ضمن تخصصه، عسى أن تتفجر هناك طاقاته العلميّة والعمليّة فتتجلّى إبداعاته وإنجازاته؟! حتى لو لم يحقّق هناك النجاح والفلاح فإننا نكون قد اخترنا أهون الحالين، فقد قيل : حنانيكَ بعض الشرّ أهون من بعض.
أمّا الاستمرار في فرضه على مدرسين من غير تخصصه، فذلك تفسير صادق صائب لقول العرب : أحَشفاً وسوءَ كيلة؟ (الحشف هو التمر الرديء).
نعم، إنّه الحشف في المستوى الأكاديمي الذي يجعلك صريع العجب: كيف عَبَرَ مثل هذا مستويات الدراسة في المدارس والجامعات، ونال أعلى الشهادات دون أن يتقن أساسيات لغته، فتعثَّر وسقط في أخطاء لغوية يترفّع عنها طلاب المرحلة الابتدائية؟!
وإذا هان عليه هكذا أمر اللغة العربية، فما ذنب المتخصصين بها ليكون مثله مسؤولاً عنهم، يؤذيهم بهذا التلويث اللغوي؟
ورد في سِيَر أعلام النبلاء: قال محمد بن سلّام الجمحي: كان عمر إذا رأى الرجل يتلجلج في كلامه، قال: خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد!! ونحن نقول كيف يستوي مثل هذا مع طه حسين في مسمى عميد؟!
ألا يستحق الأمر أن يعاد النظر في نتائجه المدرسيّة والجامعيّة، وتُفحص رسائله الجامعيّة وأبحاثه، وتُعرف منابع شهاداته العليا ومصادرها؟
وإنها أيضاً لسوء كيلة، لأن مثل هذا وُضع في مكان غريب عنه، بعيد عن تخصصه، غير مناسب له، فيعجز عن النهوض بواجبات مهمته، ويُبتلى به مَن هو مسؤول عنهم حين يدرك البون الشاسع بين ثُريّاهم وثراه، فتتراقص في المضمار ركبتاه، ولا يجد له تفوّقاً إلّا في التصيّد والتسلّط والمكائد، ليزداد بذلك ضغثاً على إبّالة! ( يعني: مصيبة على مصيبة أخرى).
والمستهجن أنّ مثل هذا قد يفرد أحياناً جناحيه الكليلين على كليّتين لأنّ النساء عجزن أن يلدنَ مثله !! فأيّة جامعة تلك التي تعجز عن إيجاد عميد مناسب متخصص لكليّة إنسانية؟! ولعل الأولى أنْ تترك لمثل هذا فرصة التحليق في فضاء تخصصه، عسى أنّ ينفعنا هناك بفائض عبقريته، فلكلّ منّا طاقات ينبغي أنْ توظَّف في مكانها اللائق بها المناسب لها، وإلّا فإنها تُخنق، أو تتفلّت فتنسرب نائية عن بيئتها، منحرفة عن سويتها، فتعمّ بلواها، ويكتوي الأسوياء بلظاها، فيُحبطون، ويضمحلّ انتماؤهم، ويصبحون زاهدين في المكان ومَن فيه.
وهذا حتماً ليس من مصلحة أحد، ولا يعود بأيّة فائدة على المؤسسة والعمل.
فهل بقي بيننا مَن يسمع أو يجيب ؟!
رحم الله سعد زغلول وصفيّة، وأطال في عُمر أحمد حسن الزعبي وكرمة العلي.