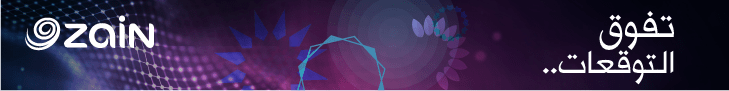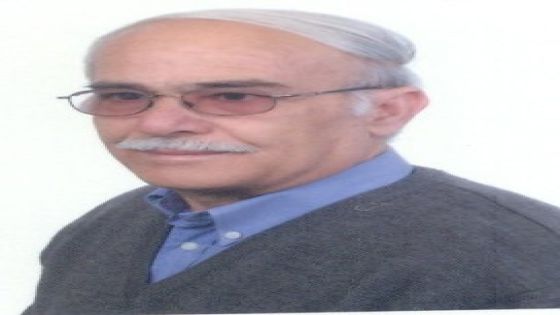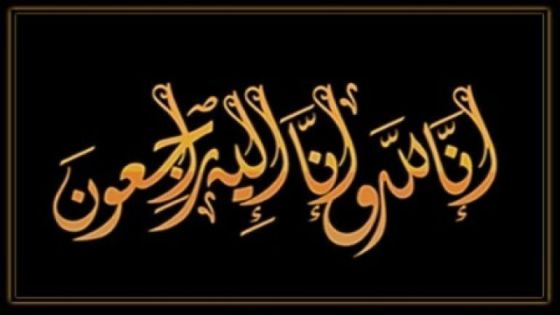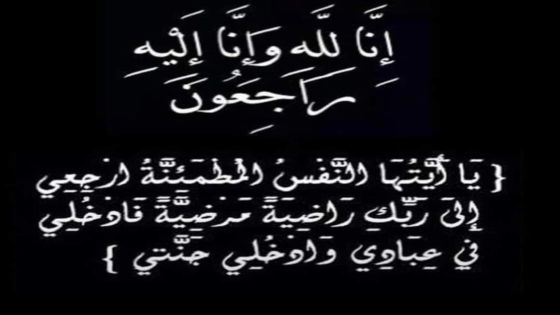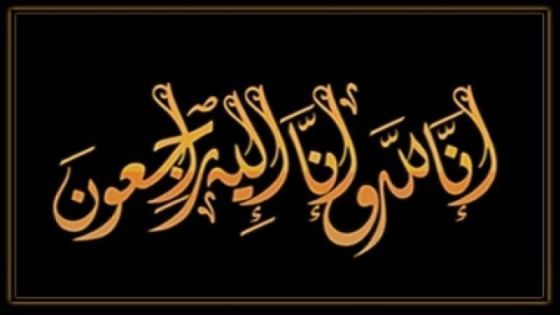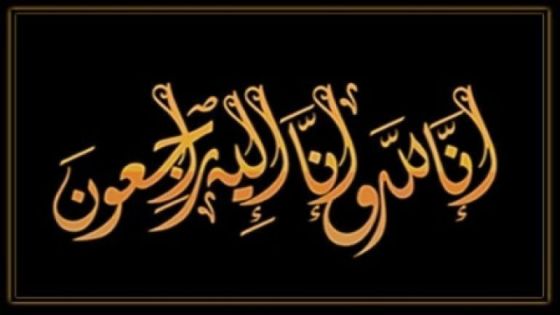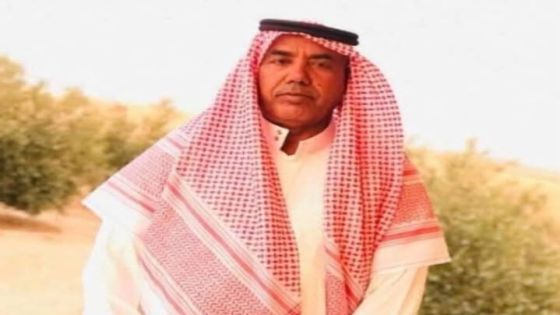بقلم د. محمد عبد الله القواسمة
المعروف أن اللغة، أية لغة ما هي إلا رموز، أو علامات، أو إشارات يستخدمها الإنسان ليعبّر بها عن مشاعره وأحاسيسه المتقلبة، وأغراضه المتعددة. ونرى أن لكل حالة أو موقف، أو وضع إنساني لغة خاصة، قد تكون مفعمة بالفرح والسرور، أو طافحة بالحزن والبؤس والتعاسة.
في المخيمات الفلسطينية، التي أنشئت في البلاد العربية المجاورة لفلسطين: الأردن وسوريا ولبنان عام النكبة 1948م، وتلك التي أقيمت عام النكسة 1967م إثر طرد معظم الشعب الفلسطيني من وطنه، ظهرت لغة خاصة بين أبناء المخيمات أسميها لغة الزينكو، التي تبلورت في الفترة الأولى من إقامة تلك المخيمات، حيث انتشرت أكواخ الصفيح وألواح الزينكو، واستمرت في الاستخدام حتى بعد تطور المخيمات من الخيام إلى الزينكو، ثم بيوت اللبن، ثم البيوت الإسمنتية. ولعل ذلك الاستمرار يعود إلى أن الطبيعة الأولى للمخيم لم تتغير، وإحساس الناس الذين سموا لاجئين ما زال يملأ قلوبهم الأمل في العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها.
لم يقتصر استخدام لغة الزينكو على الأدباء من فلسطين والأردن في إبداعاتهم عن فلسطين ومخيماتها، بل استخدمها أدباء من مصر ولبنان، مثل إلياس خوري ورضوى عاشور. لكن النماذج الحقيقية لتلك اللغة كانت على أيدي الأدباء الفلسطينيين، الذين عاشوا المأساة في المخيمات، مثل: عادل الأسطة، وإبراهيم أبو هشهش، وزياد أبو لبن، ومحمد مشة وغيرهم.
نستطيع معاينة لغة الزينكو في العمل الذي أبدعه زياد أبو لبن تحت عنوان «رائحة الزينكو» (عمان: دار الخليج، 2025) الذي جُنّس خطأ من المؤلف بأنه قصص قصيرة، وسايره في ذلك من تناوله بالنقد. إنه – كما أرى – ذكريات أدبية عن تجربة المخيم وليس من القصص القصيرة. وتواجهنا لغة الزينكو بدءًا من العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية، إلى المتن النصي.
ففي العنوان الرئيسي» رائحة الزينكو» لا تشير مفردة الزينكو إلى معناها القاموسي، لوح من التنك كالذي يستخدم لبناء كوخ أو عريشة، بل تشير الكلمة إلى حياة البؤس والشقاء التي يحياها الناس، الذين استخدموا الزينكو ليقيهم حر الصيف وبرد الشتاء. وتحمل الكلمة من خلال التركيب الإضافي معاني الإحساس بالمهانة والعجز والفقر بعد حياة سعيدة. وقد وردت كلمة «رائحة» في تركيب إضافي كما في العنوان الرئيسي في عنوانين فرعيين آخرين: «رائحة البؤس»، و»رائحة المخيم» لتشير إلى عدم نظافة المخيم من ناحية، وشقاء من فيه من ناحية أخرى. ونجد في عناوين كثيرة دلالات واضحة على قلة الطعام، وعدم توافر الملابس المناسبة، والأدوات اللازمة للوقاية من البرد والحر، كما في العناوين: «صحن العدس البارد»، و»البطانية المرقعة»، و»المشط ذو الأسنان المكسورة» و»الصوبة ذات الفتيل»، و»براد الشاي المحروق»، و»مروحة السقف لا تدور» و»حذاء عالق في الطين»
مع هذه المفردات البائسة في العناوين وردت في المقابل بالمتن مفردات تنطق بالأمل والحنين والصبر والدعوة إلى مقاومة التطبيع، مثل المفتاح والكوفية والمولوتوف؛ فالمفتاح يرمز إلى الحنين، والتعلق بالوطن، والأمل بالرجوع إلى مسقط الرأس، يظهر ذلك في حركة الأب «كان أبي ينهض. يضع الغلاية على دفاية الكاز، ويجلس تحت المفتاح تمامًا» (ص 49). ويقول وهو يشير إلى صدره ثم إلى المفتاح» كل شيء كان هون» (ص49)
والكوفية ترمز إلى الوطن، كما ظهر في رد أبي محمود، سائق تاكسي في المخيم على شرطي المرور حين أمره بفك الكوفية؛ لأنها تحجب الرؤية: «هي اللي مخليتنا نشوف» (ص67) وحين سئل من أين اشتراها؟ أجاب: « من دكان الوطن.. بس هسا مسكر» (ص 68)
وكلمة مولوتوف ترمز إلى الرفض، والحث على المقاومة، كما يبدو في قول النص الأخير من الكتاب عن بقايا مولوتوف إنها «تروي قصة رفض الصمت، وقصة وطن ما زال ينبض رغم الرماد» (ص 119)
وتقدم لغة الزينكو، كما نعاينها في كتاب الأديب زياد أحداث المخيم، التي تتمحور حول ما كانت تقوم به وكالة الغوث الأونروا من خدمات، مثل توزيع المؤن والوقود والبقج، وخدمات الصحة والنظافة، كلها تُقدم بواقعية بسيطة، تتخللها المفردات والتراكيب العامية، التي يتكلم بها اللاجئون في مخيم عين السلطان بالقرب من أريحا. فهذا الأخ الصغير يصرخ عندما ينطفئ نور اللوكس: « العتمة أكلت اللوكس» فتضحك الأم وتقول: « لا بس أبو شنبر عطشان» (ص113) وقول الأم عن علبة السردين:» بنفتحها اليوم … ما ضل شيء»(ص99)
وتحمل لغة الزينكو حكايات من التراث الشعبي تحت مسمى «كان يا ما كان في قديم الزمان» تقصها الأم عن الغول الذي يهزم بالحيلة، و»أبو رجل» مسلوخة الذي يخرج من تحت الأرض، والعفاريت التي تقيم في الآبار وغيرها.
وإذا كانت اللغة بسيطة في وافعيتها فإنها تزداد واقعية وبساطة بتلك الانزياحات البلاغية، التي تتمثل غالبًا بالتشبيهات والاستعارات، مثل: تشبيه صوت الأم بالنسيم في القول: «تبدأ بصوت خافت يشبه النسيم» (ص15) ومثل الاستعارات والتشبيهات في الفقرة التالية: «في زوايا مخيم يكتظ بالناس والهموم، كانت حنفيات المياه تفيض بالحكايات، كما تفيض من شفاه النسوة شتائمهن وأوجاعهن. تلك الحنفيات التي شيدت في أزقة المخيم الضيقة، كانت نبض الحياة الوحيد، تتدفق من بئر عتيقة، تحيي خزانات السوق …»(ص23).
ففي هذا النص تتلاحق الاستعارات، فزوايا المخيم تكتظ بالهموم، والحنفيات تفيض بالحكايات، والشفاه تفيض بالشتائم والأوجاع، والبئر تحيي خزانات السوق..
هكذا تبدو لغة الزينكو، لغة تظهر حياة الناس الذين طردوا من وطنهم فلسطين، ليعيشوا في مخيمات اللجوء، وهي وإن كانت تعبر عن البؤس والشقاء فإنها تحمل في مواقع كثيرة الأمل في النصر والعودة. وستبقى حية رغم ما طرأ على المخيم من تغيرات. وأرى أن الذاكرة الجمعية ستحتفظ بها حتى بعد طمس المخيمات، بوصفها وصمة عار على جبين الإنسانية، وسيظل الأدباء يسترجعون تلك اللغة في إبداعاتهم على مر الزمن، عندما يكتبون عن المخيم.