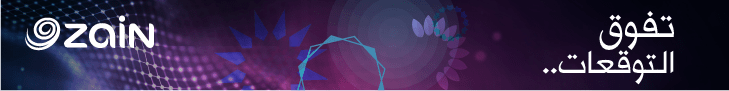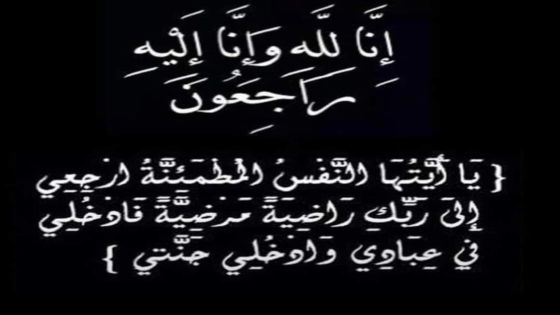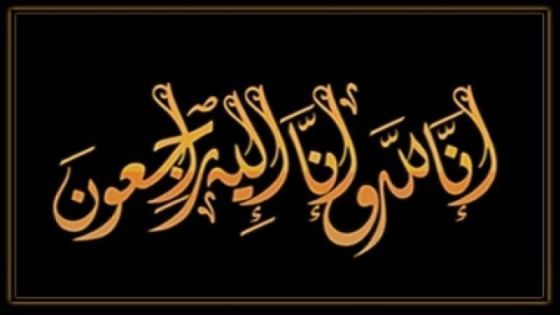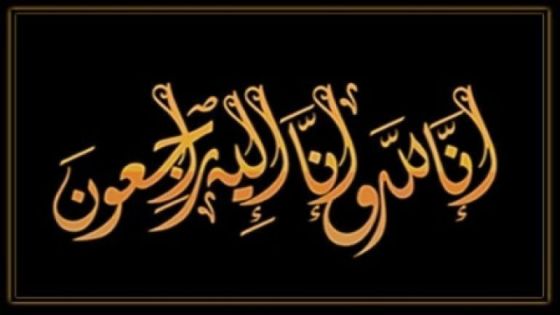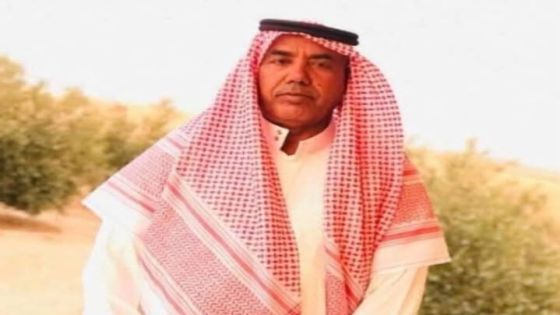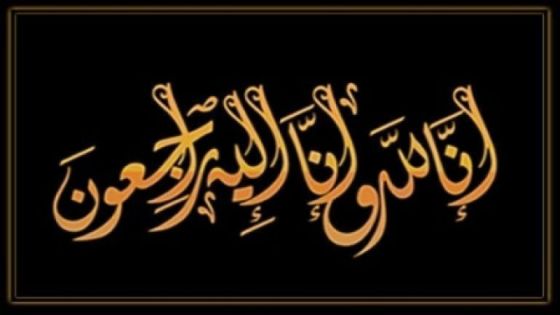“تقرير”
“نحن لم نخترع الأشياء، لكن آثارنا تدل علينا”
زيدان عبدالكافي الكفافي – أستاذ شرف – جامعة اليرموك
zeidan.kafafi@gmail.com
وطنا اليوم-عمّان في 20/9/ 2025م
الممالك العمونية والمؤآبية والأدومية (حوالي 1200-539 قبل الميلاد)
زيدان عبدالكافي الكفافي – أستاذ شرف -جامعة اليرموك
أكتب هذا التقرير وأضعه بين يدي القرّاء لبيان أن الأردن بحدوده الحالية كان على الدوام عصيٌّ على أعدائها، من خلال تقديم معلومات مختصرة حول الوحدات السياسية التي كانت موجودة على أرضه خلال الفترة بين حوالي 1200 – 332 قبل الميلاد، أي معاصرة لدويلات قامت على الضفة الأخرى من نهر الأردن في الوقت نفسه. وكما نرى من الخارطة (مرفقة وأصلها من الانترنت) والتي يبدو أن راسمها لا هوتي أن فلسطين لم يحكمها دويلة واحدة في تلك الفترة.
مقدمة تاريخية:
اختلف الباحثون حول البدايات الأولى للمالك العمونية والمؤآبية والأدومية، واستقر الأمر على رأيين، هما:
الرأي المرتكز على الروايات التوراتية وصاحب هذه المدرسة وليم أولبرايت W: Albright ومن مؤديه توماس ليفي Thomas Levy الذي عمل في فينان ،وحتى يتوافق رأيهم مع ما ذكرته نصوص العهد القديم يصرون على أن البدايات كانت في حوالي 1200 قبل الميلاد.
الرأي الذي يعتمد على نتائج الحفريات الأثرية والذي يذكر أن هذه الممالك ربما تأسست في القرن العاشر قبل الميلاد، لكنها ازدهرت في مرحلة لاحقة خاصة ابتداء من القرن الثامن قبل الميلاد، ومن مؤيدي هذه المدرسة Piotr Bienkowski وكاترينا شميدت Katharina Schmidt ، وأعتقد أنها انجليزية الهوى. إذ أنها تعتمد على نتائج حفريات كريستال بنت في بصيرة وطويلان وأم البيارة.
أما رأينا، واعتماداً على الحفريات الأثرية والوثائق الفرعونية المكتوبية، أن هذه الممالك المحلية تأسست بعد انتهاء السيطرة الفرعونية على بلاد الشام في حوالي 1200 قبل الميلاد، وهي امتداد للمدن التي كانت قائمة في البلاد في فترة العصر البرونزي الأخير (حوالي 1550 – 1200 قبل الميلاد).
خارطة توضح الممالك العمونية والمؤآبية والإدومية
يعزى السبب في تعدد الآراء حول البداية الدقيقة لهذه الممالك الثلاث لغياب وسكوت المصادر التاريخية والوثائق الأصلية عن الحديث حول جنوبي بلاد الشام في الفترة الواقعة بين حوالي 1200 – 900 قبل الميلاد. لذا فقد خلي الميدان للاهوتيين ولمصادرهم التوراتية فقط عند الحديث حول تأسيس دول في هذه المنطقة. وارتكزت دراساتهم حول خروج بني اسرائيل من مصر، وهجرة شعوب البحر للمنطقة، ونسوا أو تناسوا أن المنطقة كانت معمورة بالمدن والقرى والبدو، ومأهولة بالسكان حتى قبل 1200 قبل الميلاد وذلك بشهادة الوثائق الفرعونية والمحلية. ومن الأحداث الهامة خلال هذه المرحلة سقوط الامبراطوريات الثلاث المحيطة ببلاد الشام، وهي: الفرعونية في مصر، والكاشة (البابلية الوسطى) في وادي الرافدين، والحثية ببلاد الأناضول.
ماذا نتج عن هذه المعطيات التاريخية جميعها:
انهيار نظام دولة المدينة السياسي، ونشوء وحدات سياسية، أو تكتلات سياسية تقوم على أسس عرقية وجنسية كانت نواة لدولة الأمة، وهذا يعدُّ ثورة في النظام السياسي في بلاد الشام. وعلى هذا الأساس يعزو الباحثين التوراتيين انهيار نظام دولة المدينة لتدمير المدن الكنعانية نتيجة لهجوم العبرانيين الخارجين من مصر. وأثبتت انتائج الحفريات الأثرية في عدد من مواقع العصر البرونزي الأخير بطلان هذا الإدعاء، إذ استمر الناس بالسكنى في هذه المدن.
نتج عن انهيار الامبراطوريات الثلاث ظهور نظام اقتصادي غير مستقر، فعلى سبيل المثال انقطعت الخطوط التجارية البحرية بين بلاد المشرق والمغرب، ولم يعثر على أي فخار مستورد من مايسينيا كما كان الحال في الفترات السابقة، علماً أن صناعة الأواني الفخارية استمرت من العصر البرونزي الأخير للعصور الحديدية الأولى.
من أهم الوثائق الفرعونية التي تتحدث عن الأردن هي بردية اسمها “أناستاسي 6 Anastasi VI” التي تتحدث عن أن شيخ قبائل الشاسو التي تسكن منطقة جنوبي الأردن طلب الإذن من ضابط الحدود المصري للسماح لقبيلته للمرور بقطعانهم إلى داخل الأراضي المصرية، وكان هذا في زمن الفرعون المصري “مرنبتاح” الذي حكم في الفترة بين حوالي 1212 – 1202 قبل الميلاد. وهذا يعني أن البلاد كانت مأهولة وليست فارغة من السكان.
يجادل العالم الانجليزي Piotr Bienkowski أن الإسم (wrw) والذي يعني شيوخ قبائل (whwt) الكوشو (أطلقت بعدها على أدوم) ربما هم حكام (hq3w) “شوتو” وربما تكون لهم علاقة بمؤآب وعمون، وعثر على هذا الإسم في نصوص اللعن المصرية المؤرخة لحوالي 1800 قبل الميلاد. وقد صنّف بينكوفسكي العمونيين والمؤآبيين فلاحين (زرّاع ومربي المواشي) ، بينما الأدوميين رعاة/ أنصاف بدو.
أما بالنسبة للمصادر الرافدية فإن أول ذكر فيها كان لأدوم في وثيقة من زمن الملك الآشوري أدد- نيراري الثالث (810 – 783 قبل الميلاد). ومن الواضح أن أدوم لم تكن محتلة من الآشوريين إبّان حكم هذا الملك، لكن من المذكور في الوثائق الآشورية أن الممالك العمونية والمؤآبية والأدومية قد دفعت الجزية للملك الآشوري تيغلات – بلاسر الثالث (744 – 727 قبل الميلاد)، ولم يدخل الجيش الآشوري أراضي هذه الممالك إلاّ في عهد الملك آشور -بنيبال (حوالي 668 – 631 قبل الميلاد). على أي حال، فإن أراضي الممالك العمونية والمؤآبية والأدومية لم تدمج مع أراضي الامبراطورية الآشورية كغيرها من ممالك بلاد الشام الأخرى المعاصرة لها.
سيطرت الممالك الثلاث على الأراضي الواقعة للجنوب من نهر الزرقاء/سيل الزرقاء، لكن من كان موجوداً في شماله؟ وللإجابة على هذا السؤال اقترح الألماني سيغفريد متمان ,ايده زيدان كفافي أنه وخلال الفترة بين حوالي 1300 و 1000 قبل الميلاد تسربت مجموعة من القبائل الآرامية إلى هذه المنطقة وربما تبعت شكلت وحدة أو وحدات سياسية آرامية في هذه المنطقة. نستدل على صحة هذا المقترح من خلال نتائج الحفريات التي أجراها في ستينيات القرن الفائت الأمريكي (بول لاب Paul Lapp) الذي نقب في موقع “تل الرميث” القريب من الجهة الشرقية لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
يقترح العالم الهولندي آل شتروم (Ahlstroem) أن منطقة غور الأردن شهدت في حوالي 1200 قبل الميلاد زيادة سكانية نتيجة لقدوم مهاجرين إليها هروباً من شعوب البحر الذين قدموا من اليونان.
علاقات عمون ومؤآب وأدوم الداخلية والخارجية خلال العصر الحديدي:
بعد تمكن الأمبراطورية الآشورية السيطرة على المناطق الواقعة بين نهر الفرات وساحل البحر المتوسط، وقعت الممالك العمونية والمؤآبية والأدومية تحت حكمها، لكنها لم تحتلها بناء على تعهد هذه الممالك بدفع الجزية السنوية لآشور. ولكن وبعد سقوط آشور على يد التحالف الميدي-البابلي في عام 612 قبل الميلاد، وقعت جميع بلاد الشام تحت الحكم البابلي الحديث خلال الفترة بين 586 – 539 قبل الميلاد، ومن ثم الفارسي (536 – 332 قبل الميلاد).
كان للممالك العمونية والمؤآبية والأدومية علاقات حميمة وسلمية ، إذ لم تذكر المصادر التاريخية أو حتى الدينية أنها تعاركت مع بعضها بعضاً، مما يدل على أنها ربما شكلت مؤسسة فيدرالية سياسية واحدة، ومن أصل واحد. وعلماً أن التوراة تحاول الفصل بينها ، وتذكر أن العمونيين على سبيل المثال حلّوا محل شعب اسمتهم “الروفائيم” (التثنية 2: 20-21) إلاّ أننا نرى أنهم استمرارية لسكان مدن العصر البرونزي المتأخر من الكنعانيين والأمورين وبدو الشاسو بجنوبي البلاد.
لقد حكم على عمون سلالة ملكية وردت أسماء ملوكها على أكثر من شاهد تاريخي وأهمها “قارورة سيران” ، ودافع وقاتل أهلها دفاعاً عنها. ونضرب مثالاً هنا من النصوص التوراتية (صموئيل الأول 11: 1-12، وصموئيل الثاني: 10: 1-4) حيث تذكر حرب الملك العموني ناحاش مع شاؤول الاسرائيلي، وحانون العموني مع داود.
١” وَصَعِدَ نَاحَاشُ ٱلْعَمُّونِيُّ وَنَزَلَ عَلَى يَابِيشِ جِلْعَادَ. فَقَالَ جَمِيعُ أَهْلِ يَابِيشَ لِنَاحَاشَ: «ٱقْطَعْ لَنَا عَهْدًا فَنُسْتَعْبَدَ لَكَ». ٢ فَقَالَ لَهُمْ نَاحَاشُ ٱلْعَمُّونِيُّ: «بِهَذَا أَقْطَعُ لَكُمْ. بِتَقْوِيرِ كُلِّ عَيْنٍ يُمْنَى لَكُمْ وَجَعْلِ ذَلِكَ عَارًا عَلَى جَمِيعِ إِسْرَائِيلَ». ٣ فَقَالَ لَهُ شُيُوخُ يَابِيشَ: «ٱتْرُكْنَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَنُرْسِلَ رُسُلًا إِلَى جَمِيعِ تُخُومِ إِسْرَائِيلَ. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُخَلِّصُنَا نَخْرُجْ إِلَيْكَ ( صموئيل الأول 11: 1-4). ٤
١”” وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ مَلِكَ بَنِي عَمُّونَ مَاتَ، وَمَلَكَ حَانُونُ ٱبْنُهُ عِوَضًا عَنْهُ. ٢ فَقَالَ دَاوُدُ: «أَصْنَعُ مَعْرُوفًا مَعَ حَانُونَ بْنِ نَاحَاشَ كَمَا صَنَعَ أَبُوهُ مَعِي مَعْرُوفًا». فَأَرْسَلَ دَاوُدُ بِيَدِ عَبِيدِهِ يُعَزِّيهِ عَنْ أَبِيهِ. فَجَاءَ عَبِيدُ دَاوُدَ إِلَى أَرْضِ بَنِي عَمُّونَ. ٣ فَقَالَ رُؤَسَاءُ بَنِي عَمُّونَ لِحَانُونَ سَيِّدِهِمْ: «هَلْ يُكْرِمُ دَاوُدُ أَبَاكَ فِي عَيْنَيْكَ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيْكَ مُعَزِّينَ؟ أَلَيْسَ لِأَجْلِ فَحْصِ ٱلْمَدِينَةِ وَتَجَسُّسِهَا وَقَلْبِهَا، أَرْسَلَ دَاوُدُ عَبِيدَهُ إِلَيْكَ؟» ٤ فَأَخَذَ حَانُونُ عَبِيدَ دَاوُدَ وَحَلَقَ أَنْصَافَ لِحَاهُمْ، وَقَصَّ ثِيَابَهُمْ مِنَ ٱلْوَسَطِ إِلَى أَسْتَاهِهِمْ، ثُمَّ أَطْلَقَهُمْ. ٥ وَلَمَّا أَخْبَرُوا دَاوُدَ أَرْسَلَ لِلِقَائِهِمْ، لِأَنَّ ٱلرِّجَالَ كَانُوا خَجِلِينَ جِدًّا. وَقَالَ ٱلْمَلِكُ: «أَقِيمُوا فِي أَرِيحَا حَتَّى تَنْبُتَ لِحَاكُمْ ثُمَّ ٱرْجِعُوا” (صموئيل الثاني 10: 1-4).
وبناء على المعلومات الواردة في الكتاب المقدس أن “طوبيا” العموني ساءه جداً أن يسمح الفرس ببناء الهيكل الثاني (هذا إن وجد) وترميم أسوار مدينة “أورشليم” فتحالف مع مجموعة من القبائل العربية والفلسطينيين (الأشدوديين) ضد إعادة بناء هذه المدينة. كما أنه كان على تواصل مع بعض الأسر اليهودية النبيلة في المدينة والمعارضة “لنحميا” صديق الفرس في القرن الرابع قبل الميلاد.
أصل هذه الخارطة من الانترنت : الرجاء ملاحظة كيف أن راسمها قد مدد حدود مملكة اسرائيل لشرقي النهر
على الرغم من أن الحفريات الأثرية أثبتت امتداد مملكة عمون لنهر الأردن
أما بخصوص العلاقة بين مؤآب وجيرانها، فيذكر سفر العدد أن ملك “حشبون” الأموري واسمه “سيحون” قد دافع عن مدينته عند هجوم بني اسرائيل عليها، وأنه لم يسمح لهم بالمرور في مملكته أثناء خروجهم من مصر (العدد 21: 13، 26). ويظهر أن علاقة المؤآبيين مع الاسرائيليين كانت متذبذة، حسب التوراة، فخلال حكم القضاة في اسرائيل كانت اليد العليا عليهم للملك المؤآبي (عجلون Eglon )، علماً أن ذروة العداء بين المملكتين بلغت ذروتها في القرن العاشر قبل الميلاد، أي زمن حكم داود على اسرائيل. ويبدو أنها تحسنت في زمن الملك سليمان الذي تزوج من إمرأة مؤآبية وبنى معبداً للإله المؤآبي كموش في أورشليم (الملوك الأول 11: 7، 33).
تشير علينا المعلومات الواردة في مسلة الملك المؤآبي ميشع والتي تؤرخ لحوالي 850 قبل الميلاد بأن هذا الملك طرد المحتل الاسرائيلي من أرضه بأن هذا الاحتلال لم يدم طويلاً بين وفاة سليمان في حوالي 923 قبل الميلاد ونقش مسلة النصر المؤآبي في حوالي 850 قبل الميلاد. إضافة لهذا، فإن مملكة اسرائيل الموحدة انقسمت بعد وفاته إلى مملكتين، شمالية وجنوبية. إذن أطرح سؤالاً متى حصل احتلال اسرائيل لأدوم؟! وفي عهد من من الملوك الاسرائيليين؟ وإن جاز لنا أن نقدم طرحاً جديداً فإننا نعتقد ما يلي “أن اسرائيل لم تحتل مؤآب، وإنما حصلت معركة بين الطرفين انتصرت فيها مؤآب على اسرائيل”. وحاول التوراتيون تصوير الأمر على أنه احتلال حتى يتوائم ما ورد في المسلة مع القصة التوراتية. وللأسف يبدو لي أن كليرمونت-غانو الفرنسي وتشارلز وارن الانجليزي والذين رمموا مسلة ميشع قد عبثوا بالنص، والله أعلم. إذ أن اول من رآها وهو رحّالة ومستكشف ألماني (كلاين Klein) وهو أول من رأى المسلة ذكر في بحث منشور له أن أول ثلاثة أسطر غير مقرؤة، وهي التي تذكر احتلال اسرائيل لمؤآب.
تختلف علاقة أدوم عن مملكتي عمون ومؤآب من حيث موقعها الجغرافي وامتدادها على مناطق واسعة بجنوب فلسطين وشمال شبه الجزيرة العربية وصحراء سيناء المصرية. وبناء عليها ذكرت في العديد من المصادر التاريخية المصرية من عهد المملكة الحديثة. وقد أطلقت عليها الأسفار التوراتية اسم “سعير”، ولها سردية توراتية طويلة. كذلك كان لأدوم علاقة مع آشور خاصة بعد مهاجمة الملك الآشوري تيغلات بلاسر الثالث (734 قبل الميلاد) لهذه المنطقة، إذ دفع الملك الأدومي “قوس مالكو” الجزية كغيره من ملوك المنطقة. كما قدم الملك “عيار مالكو” الهدايا للملك الآشوري سنحاريب (701 قبل الميلاد).
وأما العلاقة بين أدوم واليهودية فقد كانت عدائية منذ تأسيس المملكة الموحدة، ونقدم معلومات ورد في نصوص التوراة (سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح 25: 12 – 13) والتي تفسر الحروب التي جرت بين الطرفين وإن كان فيها مبالغة شديد في عدد القتلى والأحياء، إذ تذكر ما يلي :
“واما امصيا فتشدد واقتاد شعبه وذهب الى وادي الملح وضرب من بني ساعير عشرة الاف. 12 وعشرة الاف احياء سباهم بنو يهوذا واتوا بهم الى راس سالع وطرحوهم عن راس سالع فتكسروا اجمعون. 13”
كما ترد نفس المعلومة في سفر الملوك الثاني 14: 7 على النحو الآتي:
” هو قتل من ادوم في وادي الملح عشرة الاف واخذ سالع بالحرب ودعا اسمها يقتئيل الى هذا اليوم 8 “
تشير المعلومات الواردة أعلاه بأن الممالك المحلية الثلاث “العمونية والمؤآبية والأدومية” كغيرها من الأمم فقد دافعت عن أراضيها أمام العدوان مهما كان بطشه مثل الآشوري والبابلي الجديد، أو مع من جاورها، فانتصرت وانهزمت لكنها بقيت واقفة شامخة .
ملخص حول الدراسات والأبحاث الميدانية في عمون ومؤآب وأدوم:
على الرغم من أن الهدف الأساس لقيام المدارس والمعاهد والمراكز الأجنبية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين هو إثبات صحة ما جاء في التوراة وذلك بالتنقيب في مواقع العصور البرونزية والحديدية، إلاّ أن أي منها لم يلتفت لدراسة تاريخ الوحدات السياسية التي كانت معاصرة لدولتي “بيت عمري/السامرة” و “اليهودية” في غربي نهر الأردن. وبقي الأمر على حاله في الأردن حتى بدأتكريستال بنت ( Christal Bennett) بالتنقيب في عدد من المواقع الأدومية (بصيرة، وطويلان، وأم البيارة). وبعد وفاة “بنت Bennett ” تابع عدد من زملائها وطلابها من أمثال بيوتر بينكوفسكي بالعمل على نتائج حفرياتها، والقيام بأعمال ميدانية أخرى. كذلك قام عدد من الباحثين الأمريكان من أمثال ميللر Miller، وتوماس ليفي Thomas Levyوالكنديين مثل Burton MaCdonald ، وميشيل دافيو Michele Davieu وراسل أدامز Russell Adams والألمان مثل أودو فورشيش Udo Worschech باجراء العديد من الحفريات والمسوحات الأثرية في مؤآب وأدوم.
أما البحث الموجه للدراسات العمونية فلم يجر فيها إلاّ عدد قليل جداً من الدراسات الموجهة لدراسة العمونيين، هذا مع العلم أنه وخلال نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين زار منطقة عمون عدد من الرحالة والمستكشفين ونذكر منها :
Ulrich Seetzen (1806), Johann Burkhardt (1812), James Buckingham (1816), Henry Tristram (1863-1864), Charles Warren (1867), Claude, R. Conder (1881), Howard Butler (1907) and Nelson Glueck (1930s’).
تبع هذه الاستكشافات حفريات أيطالية في جبل القلعة بعمان برئاسة G. Guidi في عام 1927م وفي الفترة بين أعوام 1929 – 1933 باشراف R. Bartoccini ورودلف دورنمان Rudolf Dornemann في عام 1969م. وفي عامي 1975-1976 باشراف كريستال بنت Crystal Bennett وفوزي زيادين وجون بابتست أمبير في عام 1979 لكن تركزت هذه الحفريات في أغلبها في أعلى مناطق جبل القلعة.
وكان فوزي زيادين وجون بابتست أمبير قد اكتشفا بناية في المنطقة السفلى من جبل القلعة وصفوها بأنها قصر عموني، ولمعرفة المزيد حول هذا القصر قامت بعثة أثرية من جامعة مونستر في عام 2024م باشراف كاترينا شميدت وزيدان كفافي بمتابعة التنقيب في منطقة القصر، ويخطط القائمون على هذا المشروع لمتابعة التنقيب في هذه المنطقة لمدة عشر مواسم تنقيبية على مدى عشر سنوات. لكن ما يعيق العمل في المنطقة وجود بعض المباني الحديثة التي أقيمت في المنطقة القريبة جداً منه.
ومن الواجب ذكره، أنه إضافة لجبل القلعة تم الكشف عن بقايا أثرية عمونية في عدد من المواقع المحيطة بعمان، وفي المناطق المحيطة بمجرى نهر الزرقاء. لكن الكشف عن هذه الآثار لم يكن بناء عن بحث مقصود عن الآثار العمونية بقدر ما كان للبحث عن آثار العصور الحديدية بشكل عام.
نحن لم نخترع الأشياء، لكن آثارنا تدل علينا.
زيدان عبد الكافي الكفافي – جامعة اليرموك