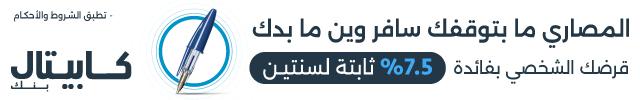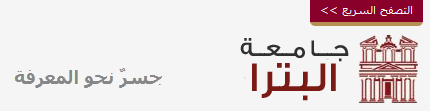نضال متصور
كلام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عيد ميلاده التاسع والخمسين، لوكالة الأنباء الأردنية، حرك مياه الإصلاح السياسي الراكدة في البلاد منذ سنوات.
الملك أعاد توجيه البوصلة للإصلاح السياسي الذي كان مجمدا ومسكوتا عنه، وظلت الحكومات تتجاهله ولا تحرز تقدما فيه. ورغم الأصوات الحقوقية والسياسية التي كانت تؤشر إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق ويتقدم دون أن يتزامن مع مسار تعزيز الحقوق والحريات، وبناء منظومة سياسية فاعلة، فإن الوضع كان “مكانك سر”، وقد يتحرك بشكل خجول خطوات للأمام ثم يتعرض لتراجع وانكسار.
كلام الملك عن الإصلاح الإداري وتكريس معايير واضحة للأداء، والتصدي للواسطة التي وصفها بالظلم والفساد، والدعوة لتعزيز أدوات رقابية، جاء متلازما مع الحديث عن أهمية سيادة القانون، والمطالبة بخطوات جادة للتنمية الشاملة لاسيما مشاركة جميع أطياف المجتمع في عملية صنع القرار. وأتبعها بالتأكيد على ضرورة زيادة مشاركة الأحزاب والشباب وإعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية كقانون الانتخاب، والأحزاب، والإدارة المحلية.
حالة من التماهي مع حديث الملك أصابت الحكومة التي بدأت بالحديث عن ضرورة تعديل التشريعات بعد أن كانت نسْيا، ولم تضعها على أجندة أعمالها.
لم تبدأ التوجهات الديمقراطية في الأردن اليوم، فلقد استعجل الملك الراحل الحسين خطواته بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، واندلاع ما سُميّ “هبة نيسان” عام 1989. ورغم تغير قواعد اللعبة وإلغاء الأحكام العرفية، فإن المسار الديمقراطي ظل متعثرا، ولم يُجدد الأردن في أدوات حكمه الديمقراطي.
مضى أكثر من عشرين عاما على حكم الملك عبد الله، والربيع الأردني الذي استهل في بدايات حكمه لم يستمر على سكته، واستطاعت القوى المسيطرة داخل الدولة أن تعيد تموضعها، وأن تجعل من الديمقراطية شكلا برّاقا لا يُغير في قواعد اللعبة السياسية.
حتى الأوراق السياسية التي أطلقها العاهل الأردني قبل سنوات وأعادت الاعتبار لمنظومة الحقوق وسيادة القانون حظيت بالنقاش، لكنها لم تأخذ حيزها في التنفيذ على أرض الواقع، وهو ما يستدعي طرح الأسئلة مجددا عن أسباب الإخفاق، وهل مطالبات الملك الجديدة في احتفالات الأردن بمئوية الدولة ستجد الروافع لتصبح واقعا، وليس كلاما احتفاليا ينساه المسؤولون في الدولة، ويُغلبون رؤيتهم بأن كلفة الإصلاح كبيرة على الأردن، وتبقى “الدولة العميقة” إن جازت التسمية، أو أصحاب المصالح يقودون البلاد بتكتيكات لا تفضي للتغيير.
التوقيت في تصريحات الملك كانت مدعاة عند الكثير من السياسيين إلى ربط هذا الخطاب بالإدارة الجديدة في البيت الأبيض بزعامة بايدن، والتي تولي قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان اهتماما لافتا، بعد أن سكتت وتواطأت أميركا في عهد ترامب عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأعطت مظلة شرعية للاستبداد.
تخلص الأردن من “كابوس” حكم ترامب، والانتقال إلى الحديث عن الأردن في عهد الرئيس بايدن كان محور نقاش مفعم بأسئلة المستقبل مع وزير البلاط الملكي ووزير خارجيته الأسبق مروان المعشر، والذي شغل من قبل سفير الأردن بالولايات المتحدة الأميركية.
المعشر الذي يتقلد حتى الآن منصب نائب الرئيس للسياسات في معهد كارينغي، أكثر الشخصيات الأردنية قربا ومعرفة بالإدارة الأميركية الجديدة، بدءا من الرئيس ومرورا بالفريق الرئاسي، ورغم حالة الاستبشار في عمّان فإنه لا يمضي في التهويل والمبالغة أن تغييرا كبيرا سيحدث، وأن الأردن سيكون أول من يقطف ثمار العهد الأميركي الجديد.
أول المرتكزات والقواعد التي يضعها المعشر على طاولة الحوار الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، أن العلاقات الشخصية شيء والتوجهات السياسية أمر آخر. ومع ذلك فهو يُقر أن دفء العلاقات الأردنية الأميركية سيعود، ولا يكشف سرا أن الرئيس ترامب لم يلتقِ العاهل الأردني منذ شهر حزيران عام 2018 وحتى رحيله عن البيت الأبيض. ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الرئيس بايدن والملك عبد الله تربطهما علاقات وثيقة. فالرئيس بادين منذ 38 عاماً في الكونغرس، وفي مواقع صنع القرار، ويتمتع بالخبرة السياسية التي كان يجهلها سلفه ترامب.
أسئلة كثيرة شهدها النقاش، وكان المعشر صريحاً أحياناً، ومتحفظاً وحذراً في الإجابات أحياناً أخرى، فهو يشعر أنه قد تعرض للغبن والحصار في السنوات الماضية مع أنه كان من أقرب الحلقات في الحكم لسنوات خلت، وما يشكو منه المعشر مشهد متكرر مع العديد من رجال السلطة في الأردن الذين يتحدثون عن خذلان “السيستم” لهم، ويجاهرون بقناعاتهم بفشل منظومة الإصلاح، وعبثيتها، وعدم جديتها.
من أسئلة المستقبل التي تبحث عن إجابات: هل سيحصد الأردن فوائد فوز بايدن بالرئاسة؟ هل هناك مزايا سيحصل عليها؟ هل ستعيد الإدارة الأميركية الاعتبار للدور الأردني كلاعب إقليمي بعد أن جرى القفز عنه في السنوات الماضية؟
ولا يمكن تجاهل أسئلة أخرى لا تقل أهمية: هل ستراعي إدارة بايدن المخاوف الأردنية، وتصون حقوقه السياسية خاصة ما يتعلق بعملية السلام والقضية الفلسطينية؟ وهل هناك حل سياسي قادم؟
وأيضا، ما هو المطلوب أردنياً حتى يقدم أوراق اعتماده للإدارة الجديدة؟ وهل هناك استحقاقات يجب أن يُنجزها داخلياً قبل أن يلوح له بها؟ وهل سيكون ملف الإصلاح مدخلاً لضغوط أميركية؟
المعشر يعود إلى طرح سردية النموذج الأردني في الخارج قبل الداخل، فيُعيد التذكير أن الأردن في الحقبة الماضية قُدم كنموذج مُلهم للسلام، وبعدها بسنوات قُدم كنموذج مختلف للإصلاح السياسي، وقُدم كنموذج متقدم في محاربة الإرهاب.
ويتساءل؛ ماذا يمكن أن نقول للعالم الآن عن هذه التجارب والنماذج، وإذا ما استثنينا -نموذج محاربة الإرهاب- فإن الإصلاح السياسي لم يعد أمراً يمكن تسويقه، وبعبارة أخرى (مش ماشي)، وبخصوص السلام فلا توجد عملية سلمية حتى نتحدث عن دور للأردن، وحل الدولتين مات على يد اليمين الإسرائيلي المتطرف وعلى رأسهم نتنياهو.
لا تبدو الصورة مبشرة، ولا يمكن الحديث عن دور وواقع جديد في ظل الأولويات الكثيرة على رأس الأجندة الأميركية والتي تسبق الاهتمام بالشرق الأوسط، وبالتأكيد الاهتمام بالأردن.
فالرئيس بايدن مُثقل بملفات صعبة، فهو يواجه انقساماً أميركياً مجتمعيا صنعه ترامب، وأزمة كورونا التي خلفت من الضحايا أضعافاً مضاعفة عمّا فعلته حرب فيتنام أو أي حروب خارجية، واقتصاد يئن من الصعوبات، وأزمات صنعها ترامب تبدأ من الصين مروراً بأوروبا ولا تنتهي بروسيا؛ ولهذا فإن كان من هوامش ذات أولوية، فإن إيران والاتفاق النووي هو الحاضر الأول على الطاولة في قضايا المنطقة.
رغم ذلك، فإن المعشر يرى أن علاقة الأردن عابرة للحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، والمساعدات الاقتصادية التي بلغت بحدود مليار ونصف المليار دولار ستستمر، ولكنها وصلت السقف ولن تزيد كثيراً، ولكن الأهم برأيه أن ضغوط صفقة القرن ولّت، وبايدن مؤمن بحل الدولتين، والمشكلة بترجمة ذلك لخطة عمل أكثر من التغني اللفظي، مذكراً أن الرئيس الأميركي لم يُعين مبعوثاً للسلام للشرق الأوسط، وبشكل مختلف عين مبعوثا لإيران.
لا يُراهن الخبير الدبلوماسي المعشر أن بايدن سيكون قادراً على وضع حد لسياسات نتنياهو، وللهجمة الإسرائيلية في ضم الأراضي؛ ولهذا فإن الخطر الذي يُهدد الأردن إسرائيليا مستمر. فالواقع أن الضفة الغربية مُسيطر عليها إسرائيلياً، وحين بدأت مفاوضات أوسلو كان هناك 250 ألف مستوطن، والآن أكثر من 750 ألف مستوطن يحتلون الأراضي الفلسطينية.
المتغير المهم أن إدارة ترامب أعطت مظلة لانتهاكات حقوق الإنسان، والرئيس بايدن لن يفعل ذلك، وهو سيتكلم عنها، ولن يعطيها غطاء وشرعية. وربما السؤال الذي يُقلق الكثير من الأنظمة المُتهمة؛ إلى أي درجة ستُمارس الإدارة الأميركية ضغوطاً في ملفات الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان؟ هل هذه أولويات، أم أن المصالح تتقدم على المبادئ في السياسة الخارجية؟
وليم بيرنز مدير المخابرات الأميركية (CIA) الجديد كان حاضراً في النقاش، فحين سُئل المعشر عن صداقته، لم يرَ في نزعة الاحتفاء والترويج لذلك أردنيا أمراً مفهوماً، وإن سرد المعشر تاريخاً طويلاً من الصداقة والعمل مع بيرنز الذي وصفه بـ “المحب للأردن”، ويحب أن يرى إصلاحاً سياسياً به، وما لفت الانتباه له أنه ولأول مرة يأتي مديراً لجهاز أمني يملك منظوراً وبعداً سياسياً، معتبراً أن ذلك سيُحدث نقلة نوعية.
الاستخلاصات المهمة أن الإصلاح السياسي قبل أن يكون تماهيا مع استحقاقات خارجية، يجب أن يكون قرارا للدولة والمجتمع، وله حواضن شعبية، وتدعمه إرادة سياسية ناجزة، وإن كان لا يمكن إنكار أن الضغوط الخارجية قد تكون مُنتجة أحيانا في عالمنا العربي.
الاستخلاص الآخر أن إدارة بايدن وإن خلقت أجواء من الاسترخاء، ورفعت قبضة ترامب التي خنقت الأردن، فإنها لن تضع الأردن تحت مجهرها، ولن تصنع المستحيلات لانتشاله من أزماته الداخلية والخارجية.
في اليوم الذي يتحدث الملك عن الإصلاح السياسي تخرج تقارير رقابية للانتخابات النيابية التي جرت في شهر نوفمبر الماضي ترصد وتوثق انتهاكات جسيمة عابت العملية الانتخابية، وعن تمدد ظاهرة شراء الأصوات على نطاق واسع، وهذا يُعيد طرح السؤال، إذن كيف سيُبنى طريقنا للإصلاح، وما هي الضمانات أن لا تتكرر سيناريوهات المراوحة في ذات المكان، وانتصار قوى الشد العكسي التي لا تريد للديمقراطية أن تزدهر في بلادنا لأنها تتعارض مع مصالحها، وسلطتها، ونفوذها، وفسادها؟
الملك اليوم بعد عقدين على تولي سلطاته الدستورية، ومع دخول الدولة مئويتها الثانية، في اختبار جديد ليُعيد ويُعزز ثقة الشعب بالحكم، وأن الكلام عن الإصلاح السياسي ليس بضاعة نبيعها للرئيس بايدن، وإنما حاجة مُلّحة لعبور الأردن للمستقبل بأدوات جديدة.