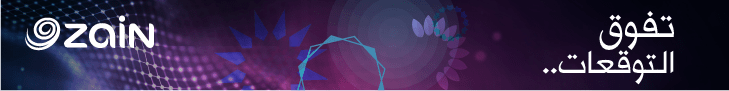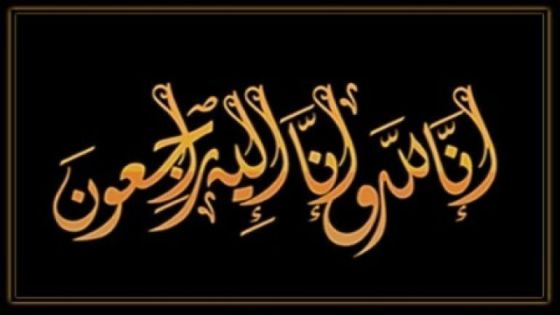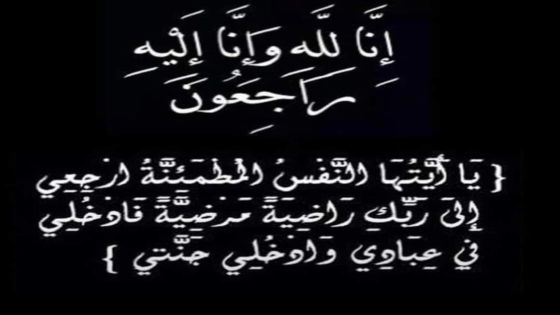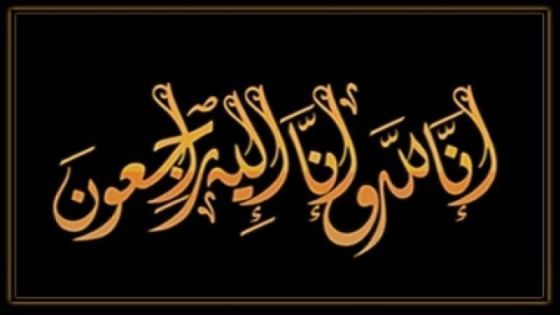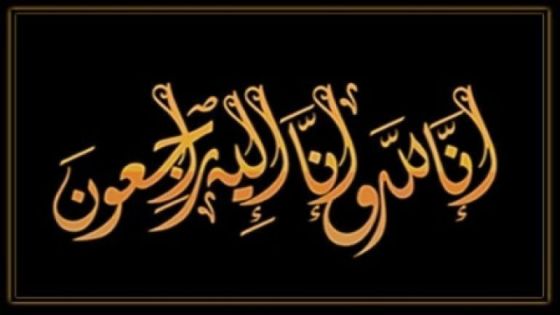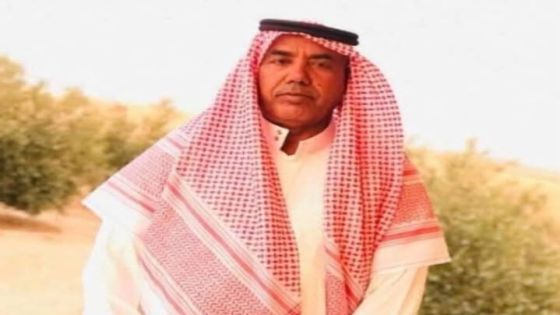بقلم إبراهيم السيوف
منذ مطلع القرن العشرين، خاض الشرق الأوسط مسارًا مضطربًا في محاولاته لبناء كيانات سياسية قائمة على أسس حزبية، فكانت الأحزاب السياسية بمختلف مشاربها أداة تُستخدم لتحقيق حلم الاستقلال والتغيير، ثم سرعان ما تحولت إلى بؤرٍ متصارعة تؤجج الفتن وتعصف بمقدرات الشعوب. هذه التجارب الحزبية، التي ولدت في سياقات من الصراع والتفكك، لم تقتصر على الخيبات السياسية فحسب، بل أظهرت هشاشة الهويات الوطنية وعمق التحديات التي تواجهها المنطقة في سعيها نحو الاستقرار السياسي.
في إطار انهيار الإمبراطوريات العثمانية والفارسية، واندلاع حروب التحرر الوطني، سعى الشرق الأوسط إلى تجديد نفسه عبر قوى حزبية متباينة. الأحزاب القومية كانت في صدارة المشهد السياسي، في محاولة لتوحيد العرب في إطار هوية قومية واحدة، واستعادة السيطرة على الأراضي التي كانت خاضعة للاستعمار. لكن سرعان ما تبين أن هذه الأحزاب لم تستطع أن تبتعد عن نزعات الإيديولوجيا المتناحرة، فبدل أن توحد شعوب المنطقة، غدت ساحة لمنازعات داخلية ومشاحنات، أدت إلى تفتيت تلك الرؤى الموحدة.
وفي موازاة ذلك، دخلت الأحزاب الإسلامية إلى الساحة السياسية، حاملة لواء “الإصلاح الديني” ومبشّرةً بتطبيق الشريعة كأساس للحكم والعدالة. إلا أن الواقع السياسي والاجتماعي كان أكثر تعقيدًا مما كانت هذه الأحزاب تتصور. فما كان يُتوقع أن يكون مصدرًا للنهضة، تحول في بعض الأحيان إلى آلية استبدادية، حيث تداخل الدين بالسياسة ليصبح أداة لتبرير القمع الاجتماعي والسياسي. وأصبح الحكم باسم الدين يحمل بين طياته تناقضًا عميقًا بين شعارات العدالة الاجتماعية وممارسات الهيمنة السياسية.
أما الأحزاب اليسارية، التي تأثرت بالأيديولوجيا الاشتراكية، فقد قدمت نفسها كبديلٍ للنظام الرأسمالي الذي اعتبرته السبب في استغلال شعوب المنطقة. ورغم النجاحات التي حققتها في بعض الفترات، كانت هذه الأحزاب في كثير من الأحيان ضحية لواقعها المعقد. فبدلاً من تحقيق المساواة والتنمية، وجدناها تُسهم في تعزيز الاستبداد السياسي، وتتحول إلى أداة في يد الأنظمة العسكرية التي ترفع شعار الثورة، ولكنها في النهاية تعيد إنتاج ذات الاستبداد الذي كانت تسعى لمقاومته.
لكن السؤال الأعمق والأكثر إلحاحًا يبقى: لماذا فشلت هذه الأحزاب في تحقيق التغيير السياسي الذي طالما حلمت به؟ الإجابة تكمن في التفكك الداخلي الذي عانت منه هذه الأحزاب، حيث غلبت الأيديولوجيا على المصلحة الوطنية، وتفوقت المصالح الشخصية والفئوية على القيم الكبرى التي كانت تحلم بها الشعوب. هذه الأحزاب فشلت في التوحد حول رؤية سياسية شاملة، وكانت في الكثير من الأحيان أدوات في يد الأنظمة الحاكمة التي كانت تستغلها لتوطيد سلطتها، لا لتطوير الدولة ومؤسساتها.
إلى جانب ذلك، لم يكن هناك أي اهتمام حقيقي بتطوير آليات ديمقراطية تسمح بوجود تداول حقيقي للسلطة أو بتأسيس دولة مؤسسات تتمتع بسيادة القانون. لقد تبين أن بناء الأحزاب في الشرق الأوسط كان دائمًا خاضعًا للظروف السياسية المتغيرة والمصالح المتشابكة، مما أضعف قدرتها على الاستمرار والنمو.
ختامًا، يبقى أن نقول إن التجارب الحزبية في الشرق الأوسط كشفت عن فشلٍ متكرر للعديد من المشاريع السياسية التي أُريد لها أن تكون أداة للتغيير. لم تنجح هذه التجارب في إرساء أسس الدولة الحديثة، بل كانت غالبًا ما تُقبر على مذبح الصراع الأيديولوجي والفوضى السياسية. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ستنجح الأجيال القادمة في التعلم من أخطاء الماضي، أم ستظل المنطقة محكومة بالتجريب الفاشل، الباحث عن هوية ضائعة وسط أمواج من الوعود الفارغة؟