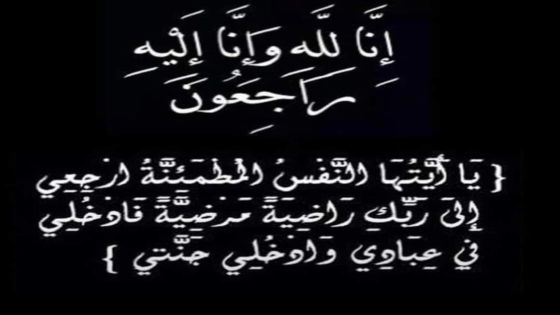بقلم: أ.د. خليل الرفوع
مئةُ عام مضت على ذكرى تأسيس الدولة الأردنية ، وفي هذه المساحة الزمنية أُسِّسَتْ وبُنِيت الدولة، وفي ظلالها بني الوعي الفكري والديني والقومي والسياسي للأردنيين .
فبين العامين : ١٥١٦م وفيه حدثت معركة مرج دابق قرب حلب بين الأتراك بقيادة السلطان سليم الأول( الذي انقلب على أبيه وقتل إخوته وأبناءَهم ) وبين المماليك بقيادة السلطان الأشرف قانصوه الغوري الشركسي الأصل ملك مصر والشام، وبسبب خيانة والي حلب خائر بك وحداثة المدافع التركية المتحركة التي حسمت المعركة انتصر العثمانيون بإعلان قتل قانصوه وقطع رأسه ، وعام ١٥١٧م وفيه حدثت معركة الريدانية قرب القاهرة بالهزيمة الثانية للمماليك وانتهت دولتهم بإعدام السلطان طومان باي ابن أخي قانصوه الغوري على باب زويلة .
بين تلكما المعركتين وقع الأردن تحت حكم السلطنة العثمانية، ومنذ ذاك التاريخ حتى أحداث الحرب العالمية الأولى والتفاف الأردنيين حول قادة الثورة العربية الكبرى تكريمًا للشرعية الدينية والجرأة السياسية الثورية أُخْضِعَ الأردن لحكم الدولة العثمانية بجبروتها العسكري الإقطاعي ، وكان العام ١٩١٧م لحظة فارقة في تاريخ بلاد الشام إذ أُخْرِج الأتراك الاتحاديون بالقوة من فلسطين بعد هزيمتهم في القدس على أيدي البريطانيين، ومن بلاد الشام عموما على أيدي جيش الثورة العربية الكبرى بقيادة أبناء الشريف الحسين بن علي ، وكان الأردنيون في دوائر الحرب وساحاتها فرسانًا ومقاتلين أشداء وشهداء.
لقد كانت الأحداث العسكرية العربية موجهةً لسياسات الدولة التركية التي خطط لها ونفذها آنذاك زعماء الحركة الطورانية القوميون الذين اغتصبوا الخلافة ، وهم من أسهم في كراهية العرب لهم وللدولة العثمانية، خاصة بعد انقلابهم على السلطان عبدالحميد الثاني وعزله سنة١٩٠٨م؛ وهو في حقيقته انقلاب على دين الدولة وتاريخها ورمزيتها ، فكان للسياسة القومية العلمانية العنصرية التركية النصيبُ الأكبر من ذلك الكره العربي المتنامي والبحث عن سبل التحرر من الاستبداد، وقد بادرت كل القوميات في البلقان وغيرها بالتمرد العسكري للخلاص من قيود القومية التركية وعنجهيتها البغيضة التي لم تنضبط بأخلاق الدين الإسلامي الذي تزعم تمثيله حيث الأغلبية من رعاياها ، أو تسامح المسيحية حيث الأقليات مضطهدة أو مهجّرة.
لقد كان هنالك أسباب متراكمة متوالية متداخلة لثورة أحرار العرب، ومنها: سياسة التتريك الشامل وبخاصة إقصاء اللغة العربية، وتغلغل الفقر والجوع والأمراض والفوضى الأمنية ، وتزايد فرض الضرائب والتجنيد الإجباري (السفر برلك) وإلقاء شباب العرب في حروب لا تعني لهم شيئا حتى أُطلِقَ عليها أيامُ الهلاك والضيم، والاستبداد السياسي والإعدامات الجماعية لعشرات من الأدباء والمفكرين في ساحات المرجة بدمشق، والشهداء ببيروت، والقدس، على أيدي جمال باشا السفاح الذي عُيِّنَ حاكمًا عاما على سوريا بعد فشله في قيادة الجيش العثماني الرابع الذي أبيد أكثره من البوارج البريطانية في حملته على مصر، والتخبط في التحالفات الدولية، ومن ذلك أن القائد العسكري أنور باشا أرسل قوة من الجيش التركي لقتال الروس بأسلحة بدائية فمات منهم أربعون ألف جندي من الجوع والبرد والثلج بين عامي ١٩١٤م و١٩١٥م ،كما قُتِلَ حوالي عشرين ألف عراقي جوعًا وعطشا ومرضًا جُنِّدُوا للحرب في القفقاس، وعدم استماع البشوات الثلاثة أنور وطلعت وجمال لمطالب العرب ونصائحهم، وخاصة شريف مكة بعدم دخول الحرب العالمية الأولى لجانب دول المحور بقيادة ألمانيا، ووقف سياسات جمعية الاتحاد والترقي العنصرية العلمانية ضد الدين الإسلامي، وفوضى الإعدامات.
إن تلك الأخطاء التاريخية وغيرها مجتمعةً كانت مخاضًا تراكميًّا يُفْهَمُ في سياقه الزمني وإطاره المكاني حينما يكون الحديث موضوعيا عن أسباب الثورة على انحرافات القوميين الذين تمكنوا من السلطة وأزاحوا هيبة الخلافة عن مسرح السياسة الداخلية والخارجية، التي وصفها في لحظات نزاعها الأخير القيصر الروسي نيكولاي الأول ١٨٥٣م لضعفها – بالرجل المريض- مما أغرى الأوروبيين بالتخطيط لتقاسم أراضيها وممتلكاتها بما سمي المسألة الشرقية.
لكن السؤال الذي ينبغي أن يُسْأل منذ مئة عام، لو لم يقم الأردنيون بالمشاركة في الثورة فأين هم الآن؟ أفي هوامش الدولة التركية العلمانية، أم في دائرة الاحتلال الصهيوني، أم مقسمون بين الدول العربية المحيطة، وفي كل الاحتمالات يبقى المسار الواقعي التاريخي الذي سار فيه الأردنيون هو خيارهم الحتمي الصحيح بناء على معطيات الأحداث في تلك الحقبة التي تكاثرت فيها الاجتهادات والمطامع والمؤامرات ؛ فكان التحرر والاستقلال هدفين مشروعين لمن بايعوا الأمير عبدالله بن الحسين أميرًا ليكون الأردن دولة معاصرة كان العلم فيها مفتاح الوعي الفكري والديني والقومي والسياسي ، وفي سياقات التطور والتنمية لا يتحمل الأردنيون تبعات مغامرات الآخرين ومؤامرات الطامعين وما لحق بالأمة من انكسارات وهزائم.
ولقد قام الأردنيون قبيل الحرب العالمية الأولى بسلسلة من الثورات على الأتراك تمثل في تمرد الشريدة بن رباع الحمّاد في الكورة، وأهل الشوبك، وثورة الكرك بقيادة قدر المجالي، وقد أعدم المشاركون فيها، كما قتل غيلةً بالسم قادتها ، لكن المقارنة بين أربعة قرون من الحكم التركي وبين قرن من الحكم الوطني هي مقارنة بين زمنين متنافرين، بين سياسة التجهيل والبطش والقتل والإعدام، وبين سياسة التعليم والبناء والتنمية، والمشاركة السياسية في أحيان كثيرة ، ولقد بُدِئَ ببناء الأردن من انهيار متوالٍ شامل عبر أربعة قرون في : البنية التحتية حيث انتشار الأمية والغزو والأتوات (الخاوات) والسُّخرة والفقر والأوبئة والقضاء العشائري الذي لا علاقة له بالدين، فلم يترك الأتراك عبر حكمهم أي أثر حضاري مادي أو فكري ؛ فما كان يهمهم من رعايا الدولة أمران هما : الدعاء للسلطان وتحصيل الضرائب ، فلا مدارس أو مساجد أو مستشفيات أو طرقا للمواصلات أو صحافة…؛ حتى وجودهم العسكري انحصر في القلاع التي لم يسهموا في بنائها أصلا، أو في سرايا عسكرية معزولة عن الناس، وكانت غاية الدولة تأمين قوافل الحج الشامي بإقامة الحصون والبِرك وتسيير الدوريات العسكرية المرافقة لها، ودفع الصُّرة السلطانية لشيوخ القبائل نظير حماية تلك القوافل من اعتداءات البدو أثناء مرورها، ومن هنا نستطيع القول : إن لحظة تأسيس الدولة الأردنية عام ١٩٢١م كانت ثورة علمية فارقة في مجالات الحياة كافة.
إن منجز بناء الدولة بمؤسساتها وجيشها وأنظمتها السياسية والتعليمية والصحية والاقتصادية يتطلب كل فترة مراجعات عبر مؤتمرات وطنية حوارية جذرية تبحث في تفاصيل عناوين مهمة كالحرية السياسية والحزبية والنقابية والصحفية والخطاب الإعلامي الرسمي والولاية العامة واستقلالية السلطات الثلاث وغيرها، ثم إن تجربة مئة عام تحتاج تقييمًا موضوعيا وتصحيحا تقويميًّا؛ فادعاء المثالية المطلقة ضرب من الوهم اللاعقلاني ، وامتلاك الدولة رؤية استراتيجة للمستقبل ضرورة يقتضيها تطور الوعي وجدلية العلاقات الدولية المكشوفة في زمن العولمة العلمية المرقمنة، البناء على ما تحقق وليس هدمه غاية كل عاقل، والمؤمّلُ بناء أنموذج ديمقراطي مستقر يعبر عن حالة الوعي .
*أستاذ الأدب العربي بجامعة مؤتة