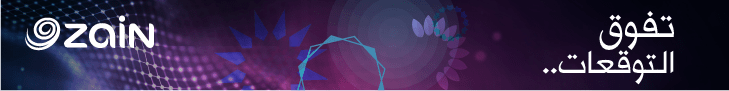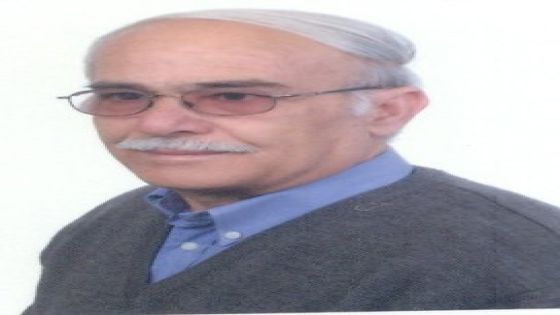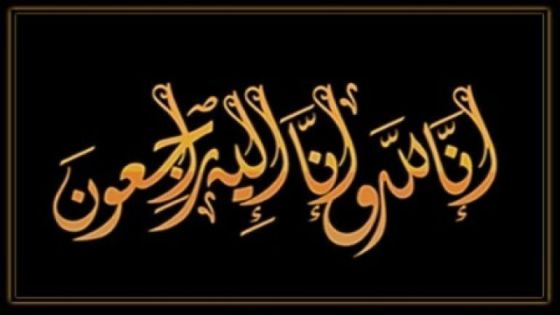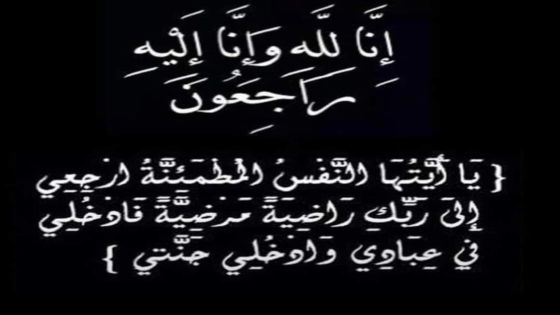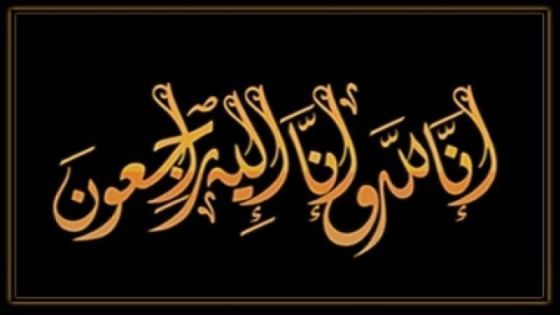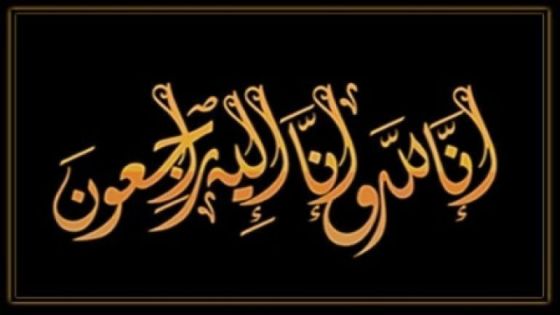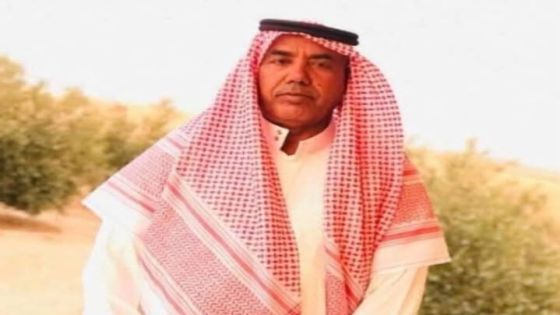د. محمد عبد الله القواسمة
يحتفظ الأدباء الذين عاشوا في المخيمات الفلسطينية بعد نكبة 48، أو بعد نكسة حزيران 67، بذكريات الطفولة التي قضوها في المخيمات سواء في فلسطين أم في البلاد العربية الأخرى. تغلغلت تلك الذكريات في أرواحهم، وسكنت عقولهم، وما فتئوا يوظفونها في إبداعاتهم من شعر ونثر. كان تأثير المخيم فيهم قويًّا، منحهم صفات الصبر والشجاعة والجرأة والقدرة على الإبداع والابتكار، وزادهم فهمًا للحياة والناس من خلال ما عانوا من فقر وجوع وحرمان وظلم. ملأ المخيم عقولهم بالقصص والحكايات، وساهم في صقل مواهبهم، وصارت تجربة المخيم من التجارب الغنية في الفكر والسياسة والفلسفة؛ لأن المخيم هو المكان الوحيد الذي يعيش فيه الناس رغم مساحته الصغيرة من مختلف البلدات والقرى والمدن الفلسطينية، ومختلف الطبقات الاجتماعية، فيه المدني والقروي والبدوي، والغني والفقير، إنه مجتمع وحدته المأساة، ووحده الأمل بالعودة إلى مدنه وقراه التي طرد منها.
لا عجب أن يعبر الأدباء في أعمالهم عن تلك الحياة التي خبروها في المخيم وهم صغار. المعروف أن مرحلة الطفولة من أهم المراحل التي تؤثر في الوعي والسلوك. نستطيع القول إننا لا نجد أديبًا من الأدباء الذين عاشوا في المخيم منذ منتصف القرن الماضي لم يذكر المخيم في أدبه سواء أكان شعرًا أم نثرًا بل إن بعض الأدباء تركزت معظم أعمالهم على ذكرياتهم في المخيم، كما في تجربة المرحوم محمد عارف مشة في قصصه القصيرة.
حمل أولئك الأدباء تجربة المخيم، فتردد في أدبهم الحديث عن صرة الملابس، وكرت المؤن، ومخفر المخيم، ومديره، وعيادة الوكالة ومطعمها ومدرستها، وعن المراحيض العامة التي لا أبواب لها، وحنفيات المياه، والنساء اللائي يردنها، وما كان يوزع على تلاميذ المدارس من الحليب، والدفاتر، والأقلام وحبوب السمك. وما جرى في المخيم من تظاهرات تجاوبًا مع أحداث محلية وعربية.
قدّم هذا الأدب تجربة المخيم نابضة بالحياة من خلال لغة أطلقت عليها في مقال سابق لغة الزينكو، التي ظهرت مع ظهور المخيم عندما أقيم في البداية من ألواح الصفيح والتنك، وتلك اللغة تقوم على ألفاظ ومفردات وتراكيب تعبر عن البؤس والفقر، ونجحت في رسم المكان بما يتحرك عليه من شخصيات، وما على أرضه من نبات وحيوان وجماد، وفي استرجاع الأحداث بإيقاعات ممزوجة بالألم والأمل.
رغم التطور الذي حدث على المخيمات الفلسطينية من النواحي الاجتماعية والسياسية والبنى التحتية، استعاد الأدباء تجربة المخيم في قصائد ومسرحيات وروايات وقصص قصيرة وغيرها من الأجناس الكتابية، ضمن تلك الظاهرة التي عرفت بأدب المخيم؛ فهذا الشاعر محمود درويش الذي هُجّر من البروة إلى لبنان ولما يتجاوز العاشرة يكتب عام 1982، عن جريمة مخيم صبرا:
صبرا- تغطي صدرها العاري بأغنية الوداع
وتعد كفيها وتخطيء
حين لا تجد الذراع
كم مرة ستسافرون
وإلى متى ستسافرون
ولأي حلم؟
وإذا رجعتم ذات يوم
فلأي منفى ترجعون
ثم ها هو الشاعر علي فوده، الذي هُجّر من حيفا، إلى مخيم جنزور قرب جنين، ثم انتقل منه إلى مخيم نور شمس في طولكرم، يقول وهو يصطف في طابور منتظرًا دوره للحصول من وكالة الغوث على طعام، أو حليب مجفف:
«واقف وكيس الخيش بين يدي. ومنذ الفجر واقف. وبين الصف من كانوا ذوي عز وجاه. وشرطي يصرخ: لا تخالف».
وفي مجال المسرح قدم مسرح الحرية، الذي تأسس عام 2006 في مخيم جنين على أطلال مسرح الحجر، الذي دمرته عام 2002 جرافة إسرائيلية خلال معركة جنين مسرحيات كثيرة، تعزز صمود المخيم، وتحث على المقاومة. من هذه المسرحيات تلك المسرحية التي انبثقت من رواية غسان كنفاني « رجال في الشمس»، التي تناولت معاناة اللاجئين في المنافي العربية ومثلت على المسرح عام 2010م. ولم تترك القوات المحتلة المسرح من شرها، ففي عام 2023، نهبه جيشها وشوه جدرانه بصور نجمة داوود، واعتقل مديره مصطفى شتا.
لعل أبرز تجليات تجربة المخيم كانت في الرواية والقصة القصيرة؛ لأنهما في طليعة الفنون القادرة على استيعاب تلك التجربة، وتقديمها بجمالية أدبية بما تنطوي عليه من قضايا وظواهر متعددة، وأظهر الفنّان غنى المخيم وأهميته في النضال العربي الفلسطيني، منذ بداية المأساة الفلسطينية، وظهور المخيمات.
من الروايات التي عاش مبدعوها في المخيم، وحملت تجربته رواية «حليب التين» 2010م لسامية عيسى، التي شكل مخيم عين الحلوة محط ذكريات مؤلفتها ومكان معظم أحداثها. ثم رواية «مخمل» 2016م لحزامة حبايب التي حازت على جائزة نجيب محفوظ للأدب عام 2017، التي تمنحها الجامعة الأمريكية في القاهرة. وتناولت الرواية قصص حب حزينة عاشتها مجموعة من النساء في مخيم البقعة، أكبر المخيمات الفلسطينية في الأردن. وإذا سمح لي أن أذكر روايتي: «أصوات في المخيم» 1993م، و»سلام على مخيم الفوار» 2025م اللتين تحدثتا عن مخيم الفوار في جنوبي مدينة الخليل.
أما القصة القصيرة فقدم القاصون الفلسطينيون تجربة المخيم في عدد من المجموعات، منها: مجموعة « فصول في توقيع الاتفاقية « 1979م لعادل الأسطة، التي تحدثت عن المخيمات في الضفة الغربية، التي خبرها المؤلف، ومنها مخيم عسكر الذي عاش فيه. ثم «ذاكرة المخيم» 2020لنبيل العريني الذي تناول فيه ذكريات المؤلف من الطفولة والشباب، ويضم عشرين قصة عن الحياة في المخيمات بغزة وغيرها. ثم المجموعة القصصية « الهندباء» 2020م لرشا فرحات تحكي فيها عن مخيمات غزة وتسترجع ذكريات الطفولة في المخيم.
في النهاية نقول: إن أدب المخيم متنوع وواسع، وما جاء في المقال ما هو إلا إشارات سريعة إلى بعض الأعمال التي ظهرت ضمن هذا الأدب؛ مما يجعلنا نتوسم من الآخرين أن يتناولوه بمزيد من البحث والتقصي؛ لأن أدب المخيم يستقي أهميته من المخيم نفسه؛ فهو المكان الغني بالحكايات والخرافات والأساطير، وسكانه متنوعو الأفكار والمشاعر والأحاسيس، ممتلئون بالأمل والصبر الممزوج بالبؤس والتعاسة. وسيظل الأدباء في البلاد العربية والعالم يذكرونه في كتاباتهم نموذجًا للبؤس الإنساني، والعزيمة القوية، والنفوس الصابرة.