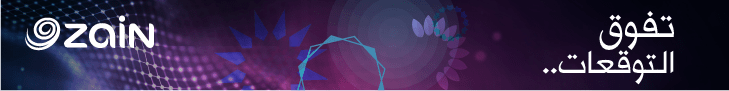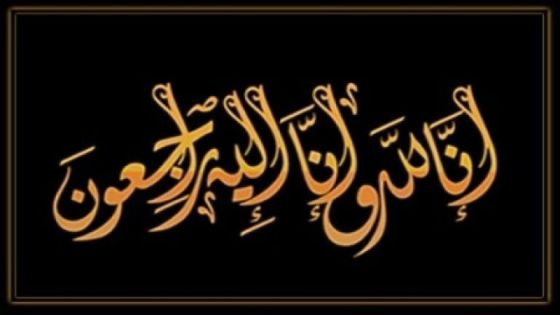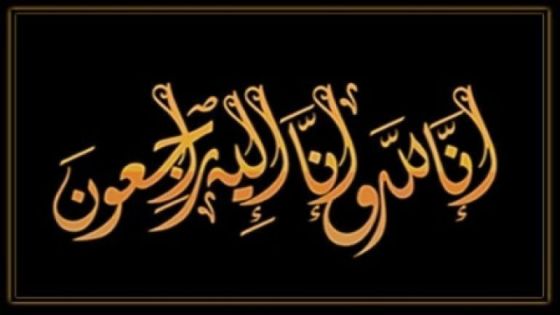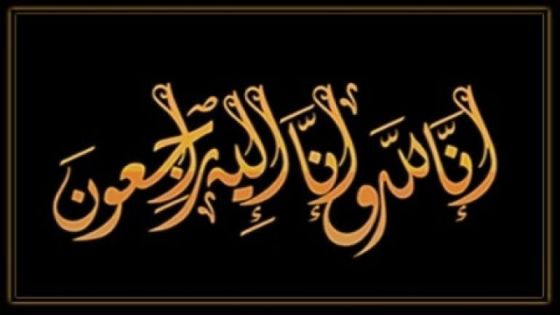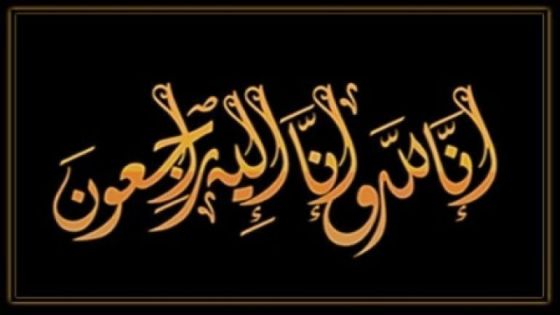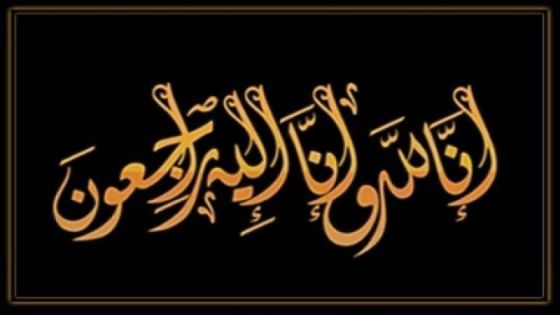كتب أ.د. محمد الفرجات
تعيش الجامعات الأردنية منذ سنوات ظاهرة متكررة ومؤسفة تتمثل في المشاجرات الطلابية الجماعية، والتي باتت تتكرر بشكل يكاد يهدد هيبة المؤسسة الأكاديمية ورسالتها التربوية. وعلى الرغم من تعدد القراءات لتفسير هذه الظاهرة — من قبل اجتماعيين وتربويين وإداريين — إلا أن التدقيق في تفاصيلها الميدانية يكشف عن نمط واضح طالما تم تجاهله: معظم هذه المشاجرات تحدث في الكليات الإنسانية وليس العلمية.
أولاً: تشخيص الواقع
إن المتتبع للأحداث التي تشهدها الجامعات الأردنية يجد أن أغلب المشاجرات تنشب في كليات مثل الآداب، والعلوم الاجتماعية، والتربية، والحقوق، والشريعة، والإدارة، أي ضمن التخصصات الإنسانية التي لا تتطلب من الطالب انخراطاً عميقاً في مختبرات أو مشاريع بحثية علمية مكثفة.
في المقابل، نادراً ما نسمع عن مشاجرة في كلية الهندسة أو الطب أو الصيدلة أو العلوم أو تكنولوجيا المعلومات.
ثانياً: لماذا الكليات الإنسانية بالذات؟
الجواب يرتبط بطبيعة المحتوى الأكاديمي ودرجة انشغال الطالب.
ففي الكليات الإنسانية، المواد غالباً وصفية وسهلة نسبياً، وتعتمد على الحفظ والتكرار أكثر من التفكير النقدي أو البحث التطبيقي. كما أن المشاريع والأبحاث الطلابية فيها سطحية في كثير من الأحيان، إذ يمكن للطالب إنجازها بسهولة عبر مصادر جاهزة أو من خلال إعادة صياغة محتوى متاح، دون الحاجة إلى جهد علمي أو ميداني حقيقي.
وهذا الواقع يؤدي إلى فراغ ذهني وزمني كبير لدى الطلبة، الذين يجدون أنفسهم متاحين للتفاعل الاجتماعي داخل الحرم الجامعي بشكل مفرط، وتشكيل تجمعات و”لوبيات” مناطقية أو عشائرية أو فئوية، تتحول أحياناً إلى منصات للخصومة والاستعراض والاصطفاف.
في المقابل، طلبة الكليات العلمية يعيشون في عالم آخر مختلف تماماً:
محاضرات طويلة، مختبرات، تقارير علمية، مشاريع تخرج تتطلب جهدًا بحثيًا، ساعات دراسية مضاعفة، وضغط أكاديمي متواصل. الطالب في هذه البيئة يعيش انشغالًا دائمًا في ما بين الكتب والأجهزة والتجارب، ما يترك هامشًا ضئيلًا جدًا لأي انخراط في صراعات جانبية.
كما أن البيئة العلمية تولّد تفكيراً عقلانياً ومنطقياً ومنهجياً يجعل الطالب أكثر ميلاً إلى الحوار والنقاش العلمي بدلاً من التصادم والانفعال.
ثالثاً: أثر البيئة الجامعية وثقافة الطالب:
إلى جانب الفروقات الأكاديمية، لا يمكن تجاهل أن الثقافة السائدة في بعض الكليات الإنسانية تشجع – دون قصد – على الانفعال والجدل والخطابة أكثر من التفكير العلمي المنهجي.
ويزداد الأمر سوءاً حين تضعف أنشطة البحث العلمي، وتتراجع قيم الحوار والاحترام داخل الحرم الجامعي، فيتحول الفضاء الأكاديمي إلى بيئة اجتماعية أكثر منه بيئة علمية.
كما أن ضعف ارتباط بعض هذه التخصصات بسوق العمل يزيد من شعور الطلبة بفقدان الجدوى والهدف، فيبحث بعضهم عن “أدوار بديلة” تمنحه شعوراً زائفاً بالقوة والهوية داخل الجامعة.
رابعاً: الحلول المقترحة
1. تطوير محتوى الكليات الإنسانية:
يجب أن تُعاد هيكلة المناهج لتصبح أكثر عمقاً وارتباطاً بالبحث العلمي الميداني والتحليل النقدي، لا مجرد الحفظ والتلقين.
تحويل الأبحاث إلى مشاريع حقيقية مرتبطة بقضايا المجتمع، مما يشغل الطالب ذهنياً ويمنحه هدفاً أسمى من الترف الفكري.
2. تطبيق نظام أنشطة علمية إلزامية:
بحيث يُكلف كل طالب بمشروع بحثي أو تطبيقي سنوي حقيقي، يشارك فيه بجهده الميداني والفكري.
هذا سيعيد توجيه طاقة الطلبة نحو الإبداع والعمل الجماعي المثمر بدلاً من التناحر.
3. تعزيز الرقابة الأكاديمية والتربوية:
على إدارات الجامعات أن تبني أنظمة إنذار مبكر لرصد التكتلات والمظاهر السلبية، وأن تفعّل دور المرشدين الأكاديميين والاجتماعيين بشكل يومي.
4. تشجيع الاندماج العلمي بين الكليات:
يمكن أن تشترك الكليات الإنسانية في مشاريع مع كليات علمية، مثل دراسات أثر السياحة على البيئة، أو البحوث السلوكية المرتبطة بالتكنولوجيا.
هذا يخلق بيئة تفاعلية تجمع بين الفكر العلمي والإنساني وتذيب الفوارق.
5. تحفيز ثقافة البحث والتفكير النقدي:
فالطالب الذي يتعلم أن يشك، ويبحث، ويحلل، لن يجد نفسه يوماً منخرطاً في نزاع فارغ أو عصبية مناطقية أو عشائرية.
إن المشاجرات الطلابية في الجامعات الأردنية ليست مجرد “سلوك فردي” أو “خلاف لحظي”، بل هي مؤشر على خلل هيكلي في بنية التعليم الجامعي الإنساني، حيث يُترك الطالب في فراغ فكري وزمني يجعله عرضة للتأثر والانجراف.
وحين نملأ هذا الفراغ بالبحث والمعرفة والمنافسة الأكاديمية الحقيقية، سنجد أن معظم هذه الظواهر ستتراجع تلقائياً، لأن الطالب الذي يعيش انشغال الفكر لا يملك وقتاً للفراغ أو الصراع.
فالجامعات تُبنى بالعقول، لا بالعصبيات؛ وبالمختبرات والمكتبات، لا بالساحات والجدالات.