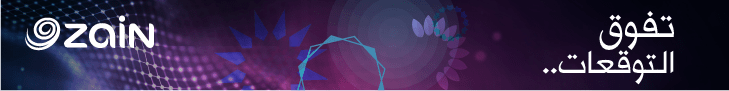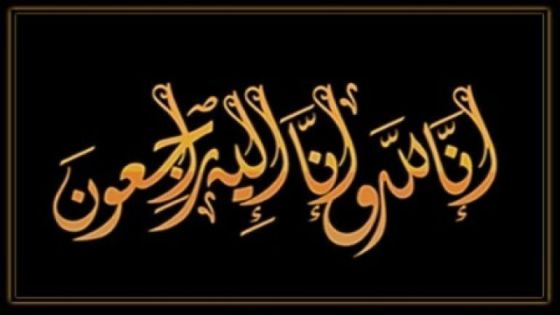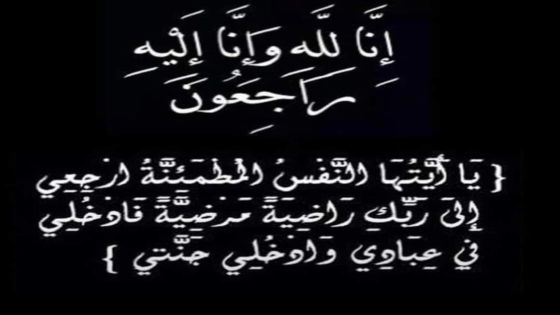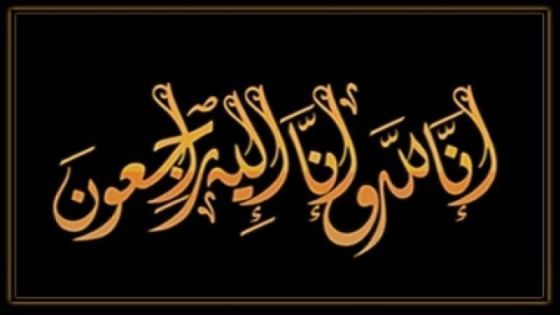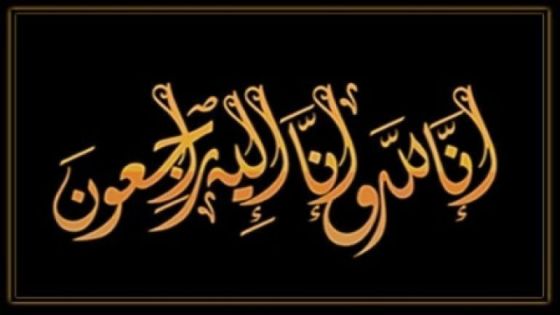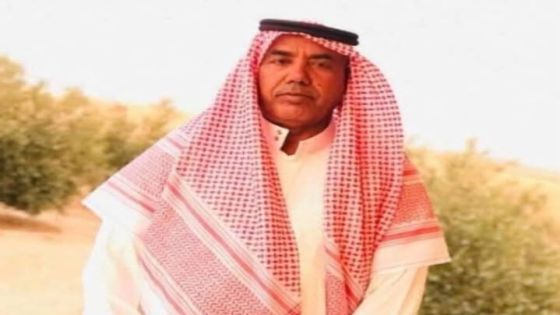د. محمد عبد الله القواسمة
لا شك أن الشعر العربي في مختلف عصوره، دون اهتمام بوصفه ديوان العرب، تناول هموم المجتمع العربي، وعبّر عن قضاياه السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وتحدث عن العلاقات بين أفراده بدءًا من العلاقة بين أفراد العائلة الواحدة، إلى العلاقة بين فئات المجتمع وطبقاته كافة.
ما يلفت انتباهنا في هذا المقام تناول هذا الشعر العلاقة بين الحماة والكنة، أي بين الأم وزوجة ابنها. فعلى الرغم من أهمية هذه العلاقة، وتجلّيها في الحياة العامة لم نجد -على حد علمنا- من الشعر ما يتحدث عنها إلا نتفًا مبثوثة في كتب الأدب والمعاجم اللغوية.
ففي كتاب «الحماسة» للمرزوقي (ت421ه) ترد أبيات لامرأة من بني هزان تدعى أمّ ثواب في ذم كنتها، وهي تقدم لذلك بالشكوى من عقوق ابنها، فهي مع أنها تولت تربيته، وهو كفرخ القطاة في صغره وضعفه، ومعدته (أم الطعام) أعظم شيءٍ فيه، ولم تزل ترعاه حتى كبر واشتد عوده، فصار كفحل النخل. وما إن بلغ هذا المبلغ حتى بدأ يضربها ويمزق ثيابها ليؤدبها، بعد أن علا الشيب رأسها، إنها تستنكر أفعاله، وتتعجب كيف تحول ابنها من ضعف الطفولة إلى قوة الشباب، التي بدت في استرسال شعره وتزيينه، وظهور لحيته.
ربّيتُه وهو مثلُ الفرخِ أعظمُه/ أمُّ الطعام ترى في جلده زَغَبا / حتى إذا آض كالفُحّال شذّبه/ أبّارُه ونفى عن مَتنه الكَرَبا / أنشا يمزق أثوابي يؤدبني/ أبعد شيبي عندي تبتغي الأدبا / إني لأبصر في ترجيل لِمّته/ وخطِّ لحيته في خده عجبا
ثم تنتقل أم ثواب إلى الحديث عن كنتها بأنها تتكلم كلامّا عذبًا حين تدعو ابنها إلى الكف عن إيذائها، وحين تقول إن وجودها في البيت يحقق الهدوء والسعادة، وهي في الحقيقة مراوغة وكاذبة ملقًا ومجاملة، فلو رأتها في نارٍ محرقةٍ، وقدرت على زيادة إضرامها لفعلت.
قالت له عِرسُه يوماً لتُسمعني/ مهلاً فإن لنا في أمنا أرَبا / ولو رأتني في نارٍ مسعّرةٍ/ ثم استطاعت لزادت فوقها حطبا
ونقرأ في «الأغاني» للشاعر أبي نجم العجلى(ت130ه) أبياتًا أوردها الباحث أحمد قبش في كتابه «مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي» 1979م يقدم فيها العجلي وصايا لبناته الثلاث في معاملة الحماة، ومن وصاياه لابنته الأولى بأن تعامل حماتها معاملة سيئة بخلاف معاملتها للكلب، وأن توسعها ضربًا وجرًا، حتى ترى حلاوة الحياة مرة:
أوصيتُ من برّة قلبًا حرا/ بالكلب خيرًا والحماة شرا/ لا تسأمي ضربًا لها وجرا/ حتى ترى حلو الحياة مرا
ويوصي الثانية بأن تتهم حماتها بالباطل، وضربها بالحجر الذي يملأ الكف على كل موضع من جسدها:
سبي الحماة وأبهتي عليها/ وإن دنت فازدلفي إليها/ وأوجعي بالفهر ركبتيها/ ومرفقيها واضربي جنبيها
ويوصي الثالثة بأن تنشب أظفارها الطويلة في وجه كنتها:
ولا تني أظفارك السلاهب/ منهن في وجه الحماة كاتب
وفي كتاب «الخصائص» لابن جني(ت392ه) نقرأ أبياتًا من الرجز مجهولة القائل، غريبة الألفاظ، معقدة المعاني، أوردها ابن جني في ذم الكنة، بأنها كثيرة الكلام وذات قدرة على أن تأتي بالعجائب، وأقرب إلى الذئب منها إلى الإنسان.
إن لنا لكنة/ مُبقّة مُفنّة/ كالذئب وسط القنة/ إلا تره تظنه
في مقابل قلة الشعر الذي قيل في العلاقة بين الحماة والكنة نلاحظ كثرة الأمثال في تراثنا الشعبي العربي التي تناولت تلك العلاقة، من مثل: بوس ايد حماتك ولا تبوس مراتك. حماتي بطبريا وصوتها واصل ليا. الحماية ما بتحب الكنة ولو كانت حورية من الجنة. قالوا للحماية ما كنت كنة قالت كنت ونسيت. الكلام الك يا جاره اسمعي يا كنة. بين الطنه والرنه ضاعت بين الحمايه والكنه. الحمايه الي بتحب الكنه الها كرسي بالجنه.
لعل أسباب ندرة الشعر في الحماة والكنة تعود إلى ترفع الشعراء عن الخوض في الموضوع؛ لأنه يتصل بالعامة وبالحياة الشعبية، فتركوه للأدب الشعبي، وبخاصة الأمثال الشعبية، وانشغلوا بموضوعات أكثر أهمية، مثل: الحب والغزل والمدح والهجاء، والحل والترحال، ووصف الأطلال والأماكن، والموت وضيق العيش، والسياسة والحرب. ثم إن الموضوع نفسه لا يحفز على قول الشعر، وإنما يجيء الاهتمام به ضمن الاهتمام بسيكولوجية المرأة والأسرة، وتربية الأولاد وحثهم على طاعة الوالدين والإحسان إليهما.
في النهاية تظل العلاقة المتوترة بين الحماة والكنة، على الرغم من تقدم الوعي واستخدام التكنولوجيا الرقمية موضوعًا يظهر من وقت لآخر في حياتنا الأدبية، وبخاصة في الأدب الشعبي، وهو يحتاج إلى الاهتمام من دارسي الأدب ونقاده؛ فضلًا عن الباحثين الاجتماعيين والنفسيين؛ لأن الأدب خير مصور لما يمور في المجتمع من عواطف ومشاعر بين أفراده.
#الحياة #الحماة #الكنة