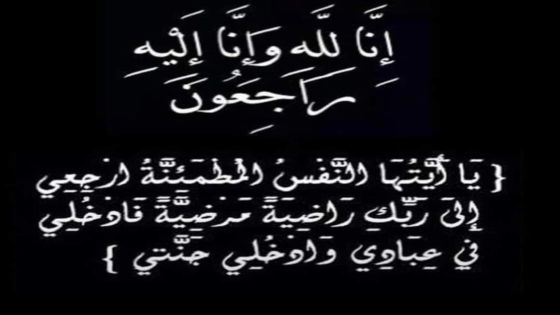حسين رواشدة
هل يشعر المسؤولون في بلدنا بالندم؟ واقعتان استدعتا هذا السؤال، الأولى: حوارات طويلة وعميقة مع مسؤولين، حول تجربتهم بالمواقع العليا التي تقلدوها، ما يُقال وما تسمعه، هنا، يختلف تماما عما تقرأه في التصريحات العلنية، أو المذكرات الشخصية، حيث تجتمع الصراحة مع عملية تطهير الذات، وأحيانا مع الأسى على تضييع الفرصة.أما الواقعة الثانية فهي قراءات مستفيضة، أمضيت فيها وقتا طويلا، حول صور الندامة ومدلولاتها في القرآن الكريم، ، «يا ليتني»، و» يَا وَيْلَتَنَا «، وعضّ الأيدي، و»يا حسرتا» على ما فرطت في جنب الله، وفي جنب الناس، والوطن أيضا.
أكيد، بعض المسؤولين يشعرون بالندم، لكن الأسباب متفاوتة، القليل من هؤلاء من يعترف بالخطأ ويندم عليه ؛ الندم هنا إيجابي ومطلوب، لكن الكثير منهم يضع الندم في جردة حسابات أخرى، خذ، مثلا، الوفاء والإخلاص والتفاني بالعمل، فيما النتيجة صادمة؛ لا تقدير ولا تكريم ولا مجرد كلمة شكرا، خذ، مثلا آخر، أحوال بعض الذين خرجوا من المناصب (عال العال)، فيما بعضهم الآخر لم يعرف ( من أين تؤكل الكتف)، فخرج من «المولد بلا حمص»، خذ، مثلا ثالثا، صدّقوا الوعود التي انهالت عليهم، والوصايات أيضا، للتوقيع على أي شيء، ثم اكتشفوا أن أحدا لم يرنّ على هواتفهم بعد أن خرجوا من مواقعهم، هؤلاء وغيرهم شعروا بالندم، ولكن ثمة فرق بين ندم وندم.
كثيرون، أيضا، لا يشعرون بالندم، أو لا يندمون على شيء، لديهم قناعة دائمة أنهم يفعلون الصواب، وأن المشكلة ليست فيهم، وإنما في الآخرين الذين لا يفهمونهم، ولا يقدرونهم، ولا يدركون حجم المسؤولية التي يتحملونها، والضغوطات التي تواجههم، والإنجازات التي حققوها، غالبا ما يكون هؤلاء فاسدون، او لم يحلموا، أصلا، بالوصول لما وصلوا اليه، او ( على الاقل) أسرى للوظيفة العامة، فما إن يخرجوا منها حتى يراودهم الأمل (الطمع) بالعودة إليها، وحين ييأسون من العودة، يُعبّرون بينهم وبين أنفسهم عن أشياء ندموا على أنهم لم يفعلوها، غالبا ما تتعلق بمنافع تخصهم، ولا علاقة لها بالشأن العام.
في معظم المذكرات التي قرأتها للسياسيين في بلدنا، لم أجد أي ندم على فعل أو قرار، فعلوه أو لم يفعلوه، صورة البطل المخلّص، ورجل الدولة الحريص على الصالح العام، غالبا ما تكون سمة عامة لروايات الماضي، لم يفكر أحد بإجراء تمرين «ندم سياسي»، أو الوقوف أمام امتحان الندم، واجتيازه بنجاح، ولماذا يندم ما دام أن سكة التغيير أو التصحيح مغلقة تماما، وما دام أن كلفة الاعتراف بالخطأ، أو الرجوع عنه «منقصة»، تسحب من رصيده السياسي والاجتماعي، وتسد أمامه أبواب اقتناص أي فرصة (غنيمة إن شئت ) قادمة.
أزمة غياب الندم الإيجابي هي التي أفرزت الحال الذي انتهينا إليه، فلا تصحيح ولا إصلاح بلا إحساس بالندم والحزن على الخطأ، ثم الإصرار على فتح صفحة جديدة، الطريق إلى التوبة يجب أن يكون معبدا بالندم، فإذا غاب الندم، أو اختفى، أصبح هذا الطريق موحشا وباتجاه واحد، اتجاه يرسخ الوضع القائم ويمجده، ويجتر الأفعال ويكررها، ويعيد الوجوه ذاتها إلى المنصات العامة ؛ وعندها لا يهتز الضمير العام أمام انتهاك حق لأحد، أو أمام أي انتقاص لمكانة، أو كرامة، أو إنجاز.
الأخطر من أزمة غياب الندم الإيجابي، هو بروز وتصاعد صور الندم السلبي، هؤلاء النادمون السلبيون لا يفكرون إلا بأنفسهم ومصالحهم، ولا يركبون موجة الندم إلا إذا فاتهم القطار، أو انتهت صلاحيتهم، وهم لا يصرفون هذا الندم إلا للشماتة والمناكفة، أو تعكير المزاج العام، وإغراقه في دوامة العجز والفشل واليأس، وهم بذلك يصطفون إلى جانب رفقائهم الذين لا يعرفون الندم على أي خطأ يرتكبونه، ويصرّون على أنهم على حق، حتى (بعد خراب مالطا ).