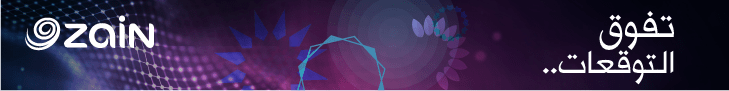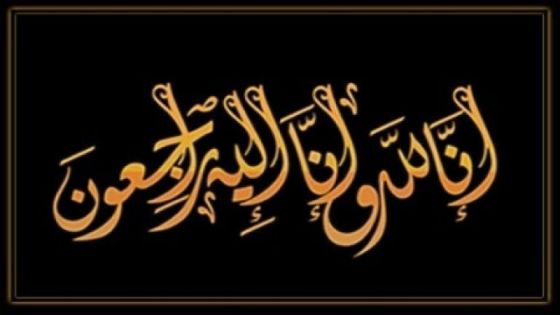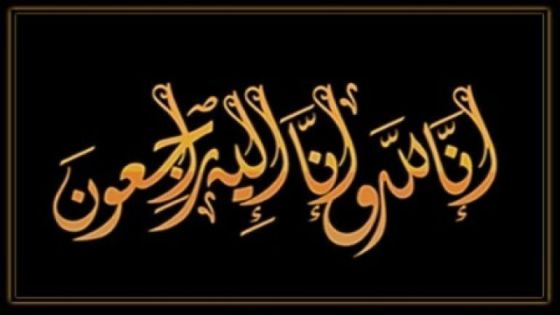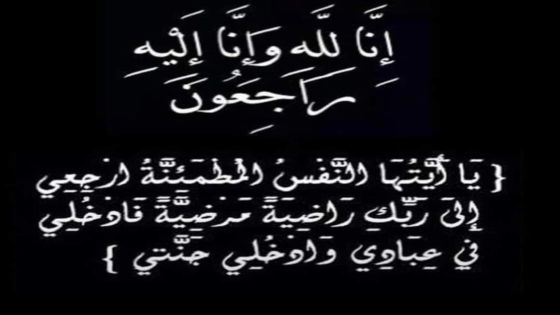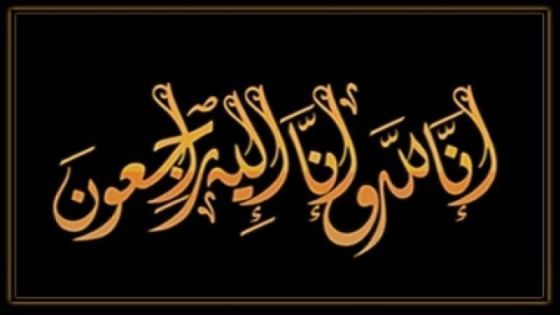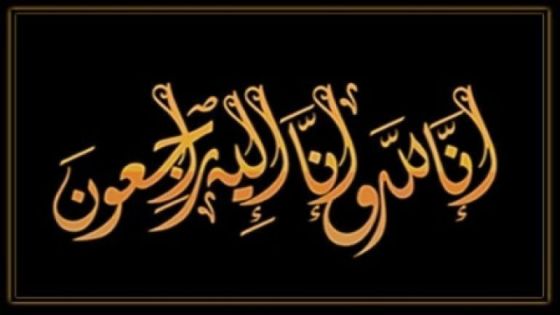وطنا اليوم – رد الدكتور مصطفى التل على مقال كتبه امس الاحد الدكتور ذوقان عبيدات حول تطوير خطة التعليم ونشرته وطنا اليوم ، وجاء في رد التل تحت عنوان :
كتب الخبير التربوي ذوقان عبيدات في مسألة ( خطة لتطوير التعليم ) :
(يمطرونك بأسئلة أبسطها يؤدي بك إلى التهلكة! أو أسئلة يصعب الإجابة عنها في نظام غير ديموقراطي، أو في نظام يضع أمامك مجموعة ضخمة من القيود والموانع المجتمعية، والسياسية، والأخلاقية، والثقافية والدينية!!…. المجتمع بنى المدارس؛ لكي ينقل حقائق ومعلومات أنتجها الأجداد؛ فالروايات مقدسة، والخلفاء مقدسون، وكل من ألف كتابًا في اللغة والتاريخ والدين مقدّس أيضًا! حتى قدّسوا بعض الشعراء! في ظل هذه القداسة لا يمكنك التحدث عن مهارات الشك، والتفكير الناقد، والإبداع ، والاقتصاد في اليقين، وحرية الرفض والقبول، وحرية التعبير!)
المتمعن بمثل هذه العبارات والنقولات ممن يدّعون انهم حريصون على التعليم والتعلّم وخطة تطوير عام , متلبسين بأنينهم على حال العلم والتعليم في بلادنا , تجدهم يضعون القواعد الدينية وكل ما هو مقدّس كعقبة في طريق التطوير , وحقيقة لا ثابت عندهم ولا يوجد قواعد ينطلقون منها , إلا قواعد الشك في كل ما هو موجود , وهذا مدخلهم إلى ما يسمى ( التفكير الناقد ) , وكأن التفكير الناقد هو ما انحصرا حصرا في فلسفة ( ديكارت ) , الذي هو يمثل القاعدة العامة الشمولية لهذا التفكير الناقد من وجهة نظرهم الحصرية , ولو في العقيدة والقرآن والسنة النبوية الشريفة وجميع الخلفاء الراشدين ومن قبلهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم , وكل ما تصدّر عنها من شروحات وقواعد وتوجيهات .
فإن انت شككت في قواعدها , فأنت مفكر ناقد , وان شككت في العقيدة , فأنت مفكر مبدع , وهذه بمجموعها تسمى عندهم ( عقبات التطوير العلمي والتربوي المنشود ) , وعند تخفيفهم لما يبثونه مما هو أوهن من بيت العنكبوت , يقولون أنهم لا يقدّسون الأشخاص , فالنقد متوجه للشخص لا للقاعدة العامة الدينية ..!
فلا يعجبهم شيء , وكل شيء ضدهم , يشكون في كل شيء , لا ثوابت ولا مقاربات ولا مقارنات , لا يوجد عندهم شيء مُعتبر إلا مبدأ ( الشك في كل شيء ) , بل يُهيأ للبعض أنهم يشكون في وجود أنفسهم في هذه الحياة .
لا تعرف ماذا يريدون , يقفزون قفزا من ميدان الى آخر , نتائجهم , مناهج ممزقة , لا تعرف للتكامل العلمي طريق , ولا للمنهجية العلمية سبيل , اجراءات مبتورة , ومنهج مجزوء , لا الطالب عارف ماذا يُراد به , ولا المعلم يثبت على وسيلة تعليمية من خلالها يُفدم المعرفة . كل نتائجهم , تراجع التعليم , تراجع الرصيد المعرفي , تراجع القيم التعليمية في الميدان والوسائل , يعبثون في كل شيء اسمه تربوي ومناهجه .
حقيقة لا ننكر أهمية تطوير المناهج العلمية والتعليمية , ولا ننكر أهمية البحث العلمي المتخصص الذي هو رافعة الأمة , ولا ننكر أهمية وجود علماء متخصصين في تطوير كل ما هو يمت للعلوم بمختلف انواعها , بل الاسلام أوجب وجوبا على الأمة ان تفرد علماء متخصصين في التطوير والبحث , واعتبره فرض كفاية على مجموع الأمة , تحاسب الأمة جمعاء وكل فرد فيها ان خلى عصر من العصور من هؤلاء العلماء .
ولكن الاسلام اعتبر أن التعلّق بشيء شريف هو مصدر انتاج المعرفة الإسلامية , ووجه الى وجوب استثمار البحث العلمي بمختلف صنوفه في مختلف الميادين في مجال انتاج المعرفة الاسلامية العلمية والانسانية , ولكن كل ذلك محصور في معرفة أصول ومنطلقات البحث العلمي الإسلامي التربوي والعلمي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي , وكيفية تعامل المنهجية الاسلامية مع مناطق الفلاسفة السابقين للإسلام في مختلف العلوم والصنوف .
اذن باختصار , لا يوجد في الاسلام معرفة من العدم , ولا يوجد في الاسلام شيء اسمه (وهدم كل ما مضى ) , ولا يوجد فيه شيء اسمه ( عدم وجود قواعد ثابتة ) .
هؤلاء المشككين بكل ما أنتجته الحضارة الإسلامية من انجازات , يغفلون عن قاعدة أساسية , وهي أن القفزة العلمية الجديدة التي شهدها العالم الإسلامي بعد تبنيه القواعد الاسلامية في البحث العلمي , انما حدثت نتيجة التغيير الحضاري الشامل الذي أحدثه الإسلام في البنية التفكيرية للعرب وفي البلاد التي فتحها المسلمون .
فالملاحظ أن القاعدة الرئيسية في تأسيس العقلية المنهجية الجديدة كانت الوحي , فالإضافات النوعية في العلوم والفلسفة والبحث العلمي وطرقه ومناهجه وتطبيقاته ومجالاته , والاسس التربوية الرئيسية نظريا وعمليا , قد تشكلت بفضل الوحي , فعن الوحي ( القرآن والسنة النبوية الشريفة ) صدرت مختلف الصياغات المنهجية العقلية للمعارف العلمية منذ لحظة التأسيس وهي بالإجمال : علوم الوحي ( التفسير والأصول والحديث الشريف ) , مع علوم الآلة ( اللغة والنحو ) , وما استتبعه الحال من علوم الحال اللازمة ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء وعلوم الطب والفلك والهندسة وغيرها) , حيث انبثقت جميع طرق الاستدلال بالتبعية عن هذه الصياغات المنهجية الخاصة في مرحلة التأسيس , وهنا تتجلى عملية التكامل والشمولية في البنية العلمية الاسلامية التفكيرية في جوانبها المتعددة .
يعترض أغلب هؤلاء المشككين حول جدوى ما أنتجته الحضارة الإسلامية من علوم مختلف بمختلف الميادين بمنهجيات اسلامية فكرية ومنهجية علمية خاصة , أن مختلف العلماء المسلمين , اخذوا عن غيرهم من الأمم هذه العلوم , منها اليونانية والهندية والفارسية , واكتفى المسلمين بالشرح والتعليق على هذه العلوم فقط , وبالتالي ان هم أخذوا بمبدأ ارسطو وغيرهم من الفلاسفة السابقين للعصر الاسلامي ومن بعده مبدأ ( ديكارت )الشكّي في مختلف العلوم , فإنهم يرجعون الشيء إلى أصله , وحقيقة هؤلاء يستهينون بالعلوم الاسلامية , وينظرون اليها نظرة الاستحقار والشك وتقليل منها .
حقيقة لا ننكر أن المسلمين أخذوا بالفعل عن باقي الحضارات والعلم تكاملي في طبعه ، غير أنّهم أخضعوا ما أخذوه إلى منهج ينبع من عقلانية جهوية خاصة.
التكامل في العقلانية الاسلامية والعلمية هي الجوهر الاصيل في مناهجها المختلفة , وليس طارئاَ عليها كما يريد البعض تصويره واسقاطه , فالعقل الذي شكّله الوحي بدايةَ كان هو العلم الدقيق وطرقه ومناهجه , وهذه العلوم المختلفة سواء الآلية أو ما يقتضيه الحال أو الأصيلة , هي ركن ومن أركان العلوم الاسلامية التي شكّلها الوحي بداية , لنأخذ علم الحساب مثالاً عليه , حتى لا يتهمنا البعض الذي يريد التشكيك في كل شيء بالمبالغة , عدّ بغض الفقهاء هذا العلم ركن من اركان الدين كتعلّم وعمل وتطوير , يقول الفقيه ابن هيدور التادلي الفاسي في كتابه ( التمحيص في شرح التلخيص ) :
(واعلم أن الحساب ركن من أركان الدين؛ به تؤخذ القبلة، وأوقات الصلاة، وبه حساب الأعوام والشهور والأيام، وجري الشمس في البروج، وحركات الكواكب، وحلول القمر في المنازل، ومعرفة الساعات النهارية والليلية، وأكثر مسائل العلم الشرعية يدخل فيها الحساب لا من العبادات ولا من غيرها، كالزكاة مثلاً… والتصرف أيضًا في الغنائم في الجهاد، وتعيين الخمس والأربعة أخماس، وقسمة ذلك على الغانمين، وكقسمة أيمان القسامة على أولياء الدم عند طلب القصاص، ومسائل القراض، والمساقاة والإجارة والتفليس…إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية ) .
اذن في المنهجية الاسلامية العلمية والتربوية والمنهج العقلي , يترتب عليه عدة نقاط من أهمها :
الأولى : وحدة العقل والنقل , حيث أنّ تعارض النص الصريح من الكتاب والسنة مع العقل الصحيح السليم غير متصور أصلاً، بل هو مستحيل , كما اتضح سابقا .
الثانية : الحقيقة العلمية مقدسة كقدسية الدين نفسه : وهذه القدسية تتّضح من خلال :
– جهة الاشتراك في حقيقة العلم كقيمة , اذ طلب العلم كيفما كان واينما كان هو أعلى درجات العبادة , فمحراب البحث العلمي في المنهجية الإسلامية لا يقل قدسية عن محراب العبادة نفسها , هو اعلى درجات العبادة في المنهج الإسلامي .
من جهة الوسيلة والمنهجية , قدسية نصوص الوحي بشقيه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والاستدلالات المختلفة للفقه وأصوله تشريعا بمختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية غيرها , دفعت علماء الاسلام إلى ضبط منهجية علمية في البحث والتوثيق لتأكيد صدقية المعلومة بدقة تامة , من جهة الرواية والدراية , سواء أكانت نقلاً أم نقداً , هذه المنهجية تم تعميمها على مختلف العلوم الأخرى , مما أضفى قدسية على الحقيقة العلمية التي تثبت , مما أدى الى تشاركية وتكاملية معرفية يندر وجودها في غير المنهاج الاسلامي العلمي , هذا التفاعل الخاص بين العلوم الدائرة على الوحي من نص مقدّس وحديث شريف وعلومه وعقيدة وفقه , وبين العلوم التربوية و الطبية والفلكية والصيدلانية والرياضيات والفلك , أدى الى تكامل الموضوعات والمناهج داخل العلوم الاسلامية .
بينما تكامل العلوم الاسلامية وتفاعلها داخل المنهجية الإسلامية العلمية الخاصة , تتضح من خلال :
– الشمول : وهو اتساع دائرة البحث العلمي في النظر بجميع العلوم بدون قيود , سواء اكانت علوم انسانية أم علمية , من باب تكامل العلوم لا تناقضها , لأن الحياة بكل مكوناتها هي مجال سعي الانسان المسلم , فهو مكلف بالسعي بكل طاقته لطلب العلم والمعرفة بما يدور حوله حتى يستطيع الريادة من جهة , ويؤمن من قناعة من جهة أخرى , فالسعي الجدّي والابداع هو مجال تكليفه الالهي , لا بد من الوصول الى الوسائل اللازمة لتسخير هذه الحياة وما هو متفاعل فيها لرعايتها وادارتها وتنظيم شؤونها , لآنها محور التكليف الالهي , وهذه هي اعلى درجات عبادته في تكليفه .
قد يرد اعتراض هنا أن العقائد لا ينبغي التوسع فيها إلا بقدر ما يوحد تصورات المسلمين عن الله تعالى والنبوات والغيبيات بشكل عام . هذا الاعتراض يمكن فهمه والجواب عليه , أن الاسلام يهتم بالعقل المنتج وصاحب المنهجية العلمية في الابداع , فكان الطلب في هذا المجال , كي يتم توجيه العقل الى منهج منتج علمي , وهنا نفهم ما قصده علماء المسلمين في الاعتراض على المتكلمين والمنشغلين بالكلام وعلومه الجدلية ,لآنها كانت تعرقل العقل عن الانتاج العلمي المنهجي
بالمحصلة ميادين المعرفة في المنهاج الاسلامي العلمي التربوي والعلمي التجريبي و التطبيقي , يتدرج من الخاص الى العام , فهو يبدأ من تكامل خاص على مستوى المادة العلمية الواحدة , الى تكامل على مستوى مادتين أو مجالين أوسع , ثم يرتقي الى تكامل عام بين جميع المواد العلمية التي تنتمي الى المجال الأوسع . حتى الوصول الى جميع المجالات العلمية , كوحدة واحدة متفاعلة بين الخاص والعام , فهو يرتقي من الفقه وأصوله على سبيل المثال إلى التفسير وعلومه , وصولا الى تفاعل مختلف العلوم العامة في هذه الحياة , ضمن وحدة واحدة تكاملية تفاعلية منطلقها الوحي بشقيه ( القرآن والسنة ) , وما ينتج عنهما من علوم مختلفة .
– التنوع : وملخصه تنويع الأدوات المنهجية التي تستعمل في العلوم على الصعيد التكاملي من خلال وسائل المعرفة المنهجية , وهذا يكون على مستويين :
أ – وسائل المنهج العلمي القويم : حيث تتنوع الوسائل العلمية في البحث والدراسة والاستنتاج والوصول الى المعلومة العلمية في مختلف اليادين , مثل التجريب ( الحس ) , وأساليب النظر ( التدبر ) , ووسائل الخبر والنقل ( النقل ) , فلا من أي وسيلة موصلة للحقيقة العلمية والنتيجة المرضية إلا وهي مطلوبة كتكليف الهي في المنهج الاسلامي التربوي والعلمي , يقول الدكتور عبد الحميد أحمد ابو سليمان في بحث بعنوان ( أزمة العقل الاسلامي ) نشره المعهد العالمي للفكر الاسلامي : (ما من وسيلة صالحة من وسائل البحث العلمي وطلب المعرفة إلا والعقل المسلم مكلف باستخدامها والإفادة منها في توليد المعرفة والقدرة على الأداء، تستوي في ذلك الوسائل المادية، والمعنوية، والكمية، والكيفية، كما تستوي في ذلك الوسائل الاستقرائية والاستنباطية والعلمية والتجريبية والتنظيرية والتحليلية ) .
ب- المصدر المنهجي المعتمد على الجهد الشخصي للعالم نفسه , من تنقيح أدلة وبناء واستدلال , مع طلب الاعانة من الله تعالى بالتوفيق , مما أعطى العلم ومناهجه في المنهج الإسلامي الصفة الأخلاقية وصبغها بقواعد أخلاقية صارمة .
التداخل و التقريب بين المناهج التكاملية في منظومة الفكر الاسلامي البنائي المنهجي , وملخصها وصل القديم بما هو جديد , ومتابعة كل جديد من الوسائل العلمية ومنهجيتها تحت ظل القواعد الرئيسية الثابتة . وهنا فيها أمرين :
أ – التداخل : هو من أهم مظاهر الشمول التي نُدرك بها حقيقة التكامل بين ما هو متوارث وبين ما هو محصّل من مختلف المعارف والعلوم , سواء أكان هذا التداخل بصورة ( تراتبية ) أو صورة ( تفاعلية ) بين مختلف العلوم التي تندرج تحت الشمولية العلمية الإسلامية من حيث المنهج العلمي وصولا لشمولية الحقائق العلمية التي نتجت عن هذا التداخل .
اذن الأمر يتعلق بشدة التكامل , بمعنى قوة الربط بين مكونات المنهج التي توضح شدته بشمولية , ومن هذه الطرق والانماط التي تتمتع بشدة الربط :
التناسق : وهو مبني على المصادرة والتسليم بين العلوم المختلفة , ويسميه البعض بــــ”آلية الخدمة” , ومفاده أن العلوم جميعها تخدم بعضها بعضاً في المنهجية الإسلامية العلمية والتربوية , حيث أن مختلف العلوم تتداخل مع بعضها البعض , والنتائج يتم تسليمها لبعضها البعض في مظهر فريد من التكاملية العلمية في المنهج , لتصبح في النهاية من المسلمات التي يتم البناء عليها , ويستعير بعضها آليات بعض من حيث المنهجية العلمية بحيث يتكون منظومة علمية منهجية يمكن من خلالها حل مسائل بعضها البعض , من هنا يتضح قصور البعض فيما ذهب اليه من أن مجال الفقه وأصوله هو أقرب العلوم الدينية الى القيام بمقتضيات أي من العصور السابقة والحاضرة واللاحقة في مجال التداول الاسلامي إلا جزئيا ,
نعم هو أحد المناهج الأساسية ولكنه ليس الوحيد لتأسيس منظومة علمية اسلامية معرفية , وذلك أن المنهج الأصولي الفقهي عبارة عن نسيج متكامل من الآليات المقررة والأدوات الاجرائية التي استمدت من علوم متعددة , ولكن بنفس الوقت هو مثال واضح على التداخل والتكامل في المعارف الإسلامية , بينما تاريخ العلوم الاسلامية ونظرية معرفتها أو ما يعرف باللفظ اللاتيني ( الأبستمولوجيا ) , هي ارحب بكثير من حصرها في علم واحد , لأنها ببساطة تناقض تكامل العلوم في المنهج الاسلامي العلمي , فنظرية المعرفة في المنهج الاسلامي العلمي , يُبيّن مدى التفاعل بين مختلف العلوم ومنهاهجا المختلفة.
وهذا يقودنا الى ما يعرف بــــ (نمط التداخل الجزئي ) بين العلوم المختلفة في لمنهج الاسلامي العلمي , إذ أن هناك تقاطعات معرفية ومنهجية بين مختلف العلوم , بحيث لو انعدمت الفواصل بينها كعلوم مختلفة , لأصبحت عبارة عن إدماج , وابتلاع علم لآخر , وهذا الأمر معيباً في المنهج الاسلامي العلمي , لأنه ضد التكامل العلمي وضد التكامل المعرفي مع حفظ لكل علم مجاله المستقل والدقيق .
ب0 العلوم العالمية السابقة والحالية واللاحقة هي علوم تكاملية في لمنظومة العلمية الاسلامية , فالتداخل بين العلوم المختلفة هو ما يميّز صفة تكامل العلوم في المنظومة الاسلامية المعرفية والعلمية , فما تم نقله اليها من مجالات كانت متداولة سابقا مثل ( العلوم اليونانية والهندية والفارسية ) , كان النهج الاسلامي العلمي هو المتمم لها من حيث صفة الصقل والنتائج والتطوير لها , فالمنهجية الاسلامية العلمية هي منهجية تقريبية بين العلوم المختلفة العالمية , لخصها الدكتور طه عبد الرحمن في كتابه ( فقه الفلسفة ) : (وصل المعرفة المنقولة بباقي المعارف الأصلية ….حيث لا سبيل إلى معرفة الممارسة التراثية بغير الوقوف على التقريب التداولي الذي يتميز عن غيره من طرق معاجلة المنقول، باستناده إلى شرائط مخصوصة يفضي عدم استيفائها إلى الإضرار بوظائف المجال التداولي الإسلامي، فضلاً عن استناده إلى آليات صورية محددة)
فأين هم من كل هذا ؟! وهل هم يعرفون ماذا يريدون تحديدا ؟!! يا ناطح الجبل ارفق بنفسك .
نكتفي الى هنا , ولنا وقفة قادمة أن شاء الله تعالى في مجال ( التفكير النقدي ) الذي يريدونه على شاكلة ( ديكارت ) ومنهجه في كل شيء , وكيف تعاملت المنظومة العلمية الاسلامية والمنهجية التربوية معه منذ قدم تشكيلها .