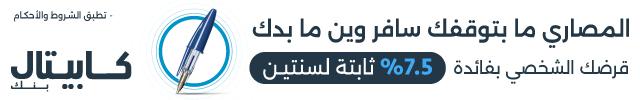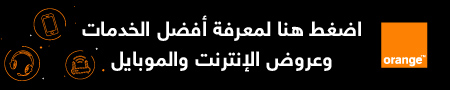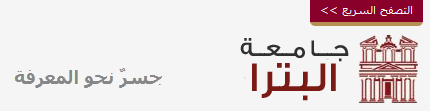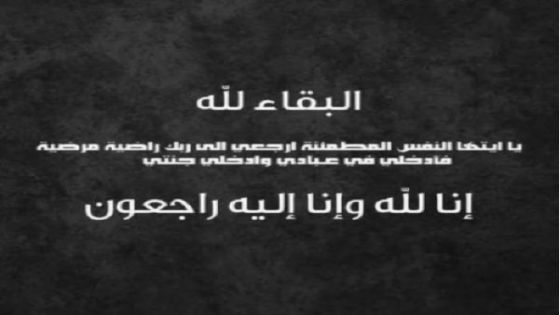محمودالسَّلمان
طيرة حيفا في فلسطين، هو اسم المكان الذي حفر في قلبي وعقلي ووجداني، وأصبح المكان الوحيد الذي طالما حاولت تخيّل شكله، وكيف كان واقعه، وكيف كانت الحياة في ثناياه، قبل أن يسرقه الغريب المحتلّ، ويعكّر براءته، ويحرق أجساد أصحابه الأصليّين الطّاهرة، ويبعثر أحلامهم وآمالهم، ويشرّدهم قهراً! مرّت سنون طويلة، وأنا محروم من رؤية هذا المكان الذي هو موطني وموطن أجدادي، مرّت سنون طويلة، وأنا لا أملك غير الحلم به وبالزلّاقة، تلك التلّة في جنوبيّ قريتنا التي ضمّت بيتنا وبيت جدّي وأقاربي، وبشجرة الخرّوب في فناء بيتنا، التي طالما ذرفت عيون أمّي دمعًا عند ذكرها. كان اسم القرية يمرّ كلّ صباح ومساء على سمعي، من خلال قصص آبائي وأجدادي الذين أمضوا أجمل سني عمرهم فيها، إلى أن حرمهم منها هذا الغريب.
أصبح هاجس رؤية هذا المكان الذي أملك يسكنني. بعد طول سنين وانتظار، سمحت ظروف هذا الزّمان القاسي لذلك الحلم أن يصبح حقيقة، أصبحت حقيقة، لكنّها حقيقة مبتورة، أشبه بالحلم، ولم تكن تمامًا كما أريد. كان عليَّ أن أدخلها غريبًا، عليه أن يطرق الباب، كان الباب يبتسم قهرًا؛ لأنّ الزّمن قد قلب تماما، كما قلب مكاني ومكان هذا الغريب منه. استقللت السّيّارة من عمّان إلى أغوار الأردنّ الشّماليّة، وصلت إلى جسر الشّيخ حسين الذي تقع فلسطين في طرفه الآخر، شعرت أنّ كلّ شيء في الجانب الآخر معتقل: القرية، والمدينة، والبحر، والجبل. أهناك في هذا العالم سجنكبير بهذا الشّكل؟! سجن يتّسع للمدن والبحار والجبال! شعرت أنْ لا شيء طليق، حتّى الهواء والسّماء والفضاء، شعرت -عندما اقتربت أكثر- أنّ كلّ فلسطين معتقلة، وأن لا هواء في المكان، وعندما رأيت أوّل الوجوه الغريبة أحسست – وهم يتحرّكون ويدقّقون ويفتّشون – أن لا جاذبيّة أرضيّة في المكان، أو أنّها تأبىأن تشتغل، وأنّ هؤلاء الغرباء يمشون في فراغ يفصلهم عن الأرض، فراغ يجعل من ارتباطهم بالأرض شيئًا لا يمكن أن يكون. تخيّلتهم يمشون على بنادق، وأنّ كلّ شيء في حياتهم بنادق، شعرتُ أنّهم يعتقلون الأرض، وأنّ العلاقة بينهم وبينها علاقة معتقِل بمعتَقل، علاقة لا يمكن أن تكون حميمة.
كنت أتمنّى أن أدخل فلسطين من حدودها الطّبيعيّة لا من فوّهة بندقيّة! أحسست أنّ كلّ فلسطين محشورة بفوّهة بندقيّة هذا الغريب؛ يعذّبها فوق سجنها بصوت سلاحه الذي لا يصمت ولا يقتات ولا ينام إلا على صوته. كلّ هذه البنايات التي حشرها في المكان الذي لا يملك؛ لتفرض أختام جوازات على القادمين، حتّى تكون ككلمة حبّ يطلبها مغتصب من فتاة؛ ليقنع مرضه أنّه لا يمارس الاغتصاب وإنّما الحبّ، محشورة – أيضا- بفوّهة هذا السّلاح. كلّ شيء سلاح، حتّى كلامهم الذي لا أفهمه، لكن من أجل عيون فلسطين تمنّيت أن أدخل هذه الفوّهة؛ لأعانقها وأنسى الحصار! وفعلًا دخلت، وختمت جواز سفري على باب الفوّهة، ودخلت عالمًا غريبًا.
ما إنْ رأيت شيئًا من فلسطين حتّى بدأت أستعيد الوعي وأرى الطّبيعة: ما هذا التّناقض الرّهيب؟!غور به لغة غير عربيّة ووجوه أجنبيّة! وما إن تواجهنا حتّى أصبح كلّ شيء منسوجًا بالألوان الطّبيعيّة، لوني كلون البحر والجبل والتّراب، وصوتي يألفه المكان، ولغتي عذبة، منها تتآلف أسماء كلّ جزء في هذا المكان، لا شيء غريب أو عجيب.
أوّل لقاء لي بهذه المحبوبة جاء بعد أعوام طويلة من الحرمان من رؤية المكان، أوّل اسم التقيت به واعتدت سماعه من فم والدتي العذب، مرج ابن عامر؛ لهذا اللحن الجميل وقع لم أشعر بمثله في حياتي، متعة أنستني كلّ شيء إلا منظر أمّي وهي تتحدّث عن المكان بكلّ طلاقة وبأدقّ التّفاصيل، مع أنّها المرأة التي عاشت في إربد خمسين عامًا، وما زالت لا تعرف أنّ هناك شيئًا اسمه شارع السّينما، وأنّ هناك شيئًا اسمه حيّ الماسورة والملعب البلديّ[1]. هذا الفرح أخافني وجعلني أريد أن أطير، حتّى قال لي مرافقي: إنّنا بدأنا نقترب من مدينتك حيفا. وكان لي ما كان.
بدأت حيفاتظهر، بحثت عن شيئين: البحر، والكرمل؛ فهذه الأماكن أكبر من أن يستطيع سارق حيفا إخفاءها، وحرماني من رؤية ما رآه أبي وأمّي وأقاربي كما هو. صرت كلّما رأيت جبلًاسألتُ: هل هذا “جبلي” الكرمل؟ وعلى كلّ الأحوال، كلّ ما رأيت هو لي، لكنّني كنت أبحث عن الكلمة التي تؤكّد الرّؤية والالتحام بيني وبين المكان، وعندما قال لي المرافق: هذا هو الكرمل. تحرّك كلّ شيء في جسدي، توقّف الحزن، وساد الفرح، وشعرت أنّني أولد من جديد.
أصبحت صورة أبي وأمّي تملك فكري، وصارت أكثر حضورا، زاد فرحي أكثر عندما ظهر البحر، ورأيت-أوّل مرّة-في حياتي ماء أنا أملكه؛ رأيت البحر الأبيض المتوسّط من مدينتي حيفا. كانت المرّة الأولى التي لا أخاف فيها من الماء والبحر؛ هذا البحر الذي تحدّث لي أبي عن “نوّه” وعن الملاّحات بقربه. بقي الكرمل يرافقني، لا يريد أن ينتهي أو يختفي، أحسست أنّ البحر حزين، وهديره تحوّل إلى نواح والجبل أكثر حزنًا. كانا كحال تلك العروس الجميلة التي فرض على جسدها الأب الظّالم شيئًا ثقيل الظّلّ لا تحتمل أنفاسه، لكنّ روحها بقيت مسكونة بعاشقها الطّبيعيّ، لا تحتمل غيره. تراه الآن يسير في المكان، انتفضت فرحًا برؤيته، وابتسم الحزن، وكانت تحرير لحظة من وراء ظهر المعتدي الجبان، وأصبح البحر أكثر فرحًا بلقائي، واستعاد الجبل شموخه وهيبته حين أحسّ بوجودي، أنا مالكه، كان كلّ جسد فلسطين يعاني الغربة مع هذا الغاصب، وما زال، وكانت كلّها تعاني: البحر، والجبل، والتّراب، والليل، والنَّهار. وصلت حيفا، وكانت الجملة الوحيدة التي كنت أردّدها: أريد أن أذهب إلى طيرة. لست مضطرًّا الآن إلى أن أقول: طيرة حيفا لأوّل مرّة؛ لأنّه لا يوجد هنا غيرها، وكلّما التصق جسدي بجسدها شعرت بالفرح والحزن والقهر، ولا أذكر إلا أمّي وأبي.
حاولت كلّ جهدي أن أجرّد المكان من أيّ شيء غريب، أصبحت في ذلك الحين شاعرًا؛ أجعل من فلانٍ من النّاس شجاعًا كالأسد، لكنّه في الوقت نفسه ليس كمثله حيوان؛ فنأيت بعيني عن كلّ عبارة عبريّة، وكلّ شيء يدلّ وجوده على تلك السّرقة التي حدثت في وضح النّهار، لا أريد أن أرى إلا ما رآه أبي وأمّي قبل أن يلوّث؛ فلا أرى إلا الشّجر القديم الذي لم يلوّث تلقائيّة شكله رجلٌ غريبٌ يدّعي أنّه فنّان ومهندس زراعيّ، لكنّه سارق، نأيت بنظري عن شجراتي التي بتر هذا المهندس الغريب أحد أعضائها؛ حتّى يزين – كما يعتقد- شكلها، تجنّبت النّظر إلى تلك الأشكال التّقليديّة لسارق المكان: جدائل أو قبّعة أو بندقيّة تتدلّى من على كتف فتى أو فتاة؛ خوفاً على نفسه من نفسه؛ فليس هناك سارق أو قاتل في مكان الجريمة المفتوح منذ زمن بعيد إلا هو، وما ورثه من المسروقات أصبحت في لحظات أخرى أجزاء من قصائد قرأتها ولم أفهمها، والآن أعيشها؛ إذ إنّني أحد بلابل هذا المكان الشّرعيّ التي قال عنها الشّاعر: إنّ دوحها قد أصبح محرّمًا عليه، وإنّ تلك الدَّوْح حلال للطّير من كلّ جنس! حتّى وأنا على دوحها لست طليقا، بل عليّ أن أبقى برفقة جواز سفري، محاصرا بقهري وحزني!
عندما التصق جسدي وروحي بجسدها وروحها شعرت بشيء غريب؛ حزن وفرح، كان عناقاً طويلًا بين فتى لم تره، لكنّها تعرفه جيّدًا، واسمه يدلّعلى أنّه منها وحفيدها وابن أحبابها. أريد أن أصل إلى الطّيرة، أريد أن أرى كلّ شيء. وبعد توقّف قصير في حيفا، بدأت رحلتي التي لم تستغرق بالسيّارة إلا وقتًا قصيرًا،لكنه مَرّ عليّ طويلًا،وخفتألا ينتهي.
وصلت مدخل قريتي الذي أراه لأوّل مرّة في عمري (شكل 1) .

شكل (1) يظهر مدخل الطّيرة من الجهة الشّماليّة، وفي الصّورة بعض دكاكين الطّيرة المهدّمة.
لم أستطع إلا التّريّث قليلا، والوقوف في مدخلها بعض الوقت؛ لأنظر إليها من بعيد؛ أردت أن أرى كيف كان أبي وأمّي وأقاربي يرونها عندما كانوا يدخلونها كلّ يوم! رأيت الطّيرة من بعيد، وبدأت بعدها أقترب منها ببطء وفرح وخوف! وفجأة وجدت نفسي في قلبها، شرعت أركض هنا وهناك؛ لأقترب من بيت والدي، وشجرة الخرّوب والزلاّقة، وفي الوقت نفسه لم أكن أعرف: أأقترب منها- عندما كنت أركض باتّجاه معيّن- أم أبتعد؟! لقد جعلني هذا الغريب غريبًا حتّى في عقر داري. كنت أتألّم؛ لأنّني تائه في أحبّ الأماكن إلى قلبي (الطّيرة)! أين الزّلّاقة؟ أين القفّ؟ (شكل 2)
شكل (2) يظهر مرتفع القفّ، وفي الصّورة بقايا مدرسة الإناث.

أَهذه مغارة التشتش؟ أم هذه المغارة جزء من لحف المغر؟ (شكل3)

(شكل3) لحف المغر، وهي عبارة عن مغر جنوبيّ البلد.
أم هي تلك التي اعتاد إخوتي أن يختبئوا بها؛ من هذا المحتلّ الذي أطلقه علينا (سايس وبيكو) وغادرا[2]؟ أهذا حريق معمر؟ أم المرقصة؟ كلّها أعرفها ولا أعرفها، لكنّني أحبّها كلّها. أأنا في الحارة القبليّة أم الشّماليّة؟ لا أعرف فربما عاث السّارق حتّى باتّجاهات المكان فهو على استعداد- من أجل دفن معالم الجريمة- أن يجعل من الجبل واديًا؛ فليس بينه وبين المكان ودّ حتّى يكون حريصًا على طبيعته أو المحافظة عليه.
عدت إلى الطّيرة، وكنت في حيرة: ماذا أقول عندما كنت آتي إليها كلّ يوم- مدّة أسبوع- من حيفا؟ أأقول: أريد أن أذهب إلى الطّيرة؟ أم أقول: أريد أن أزور الطّيرة؟ أأقول: أعاودها؟ أم أقول أن أعود إليها؟ أصبحت شديد الحساسية إزاء المصطلحات، هل فعلاً أنا غريب؟ وهل يكون الإنسان غريبا، إذا كان المكان نفسه غريبًا وليس له فيه شيء؟أم هل يكون غريبًا وإنْ كان له في المكان كلّ شيء، ولكنّه لا يعرف هذه الوجوه الغريبة التي تسير فيه؟! لا يمكن أن أكون غريبًا في الطّيرة؛ فأنا أملك المكان وكلّ شيء، إذًنْ لماذا أنا خائف، وهاجس ضرورة الاستئذان يسكنني، كلّما حاولت الاقتراب من مكان ما لأتأكّد أهو الزلاّقة أم لا؟ كم هو شيء قاسٍ أن تدخل بيتك المسروق غريبًا، والسّارق هو المقيم؟! كم هو مقيتٌ الشّعور بأنّ عليك الاستئذان في الدّخول إلى بيتك، وبأنّ اللصّ هو المضيف؟! كمهو هذا اللصّ غريب حتّى إنّه لَيمارس التّكاثر في بيت سرقه. كلّ الأماكن أعرف أسماءها، وروى لي والدي قصصًا حدثت فيها لا يعرف عنها هذا الغريب شيئًا، كلّ هذا أعرفه قبل أن يقتحم بحرها؛ فهي أكثر وأكبر وأوضح حقيقة في حياتي، هي المكان الذي فيه لا أحتاج إلى أن أتكلّم وأقول من أنا.
الطّيرة هي المكان الوحيد الذي ليس وراءه مكان آخر، هي اسمي واسم أبي وجدّي، واسم آخر الأسماء التي لي بها علاقة على مرّ تاريخ البشر، هي الطّبقة الصّخريّة من جذري التي ليس بعدها شيء، وطيرتنا هي مسقط رأس أبي وأجدادي. إنّ أسماءً كثيرة من سكاّنها الأصليّين المولودين هناك، ما زالت، وما زالوا أحياء يمشون ويتنفّسون، وما زالوا جزءًا من الحاضر وليس من التّاريخ. هؤلاء أحياء الحاضر، يستطيعون أن يحدّثوك عن الطّيرة بكلّ تفاصيلها، ليسوا كذلك الغريب الذي يُسمّى اليوم رئيس بلديّتها، ذلك لا يستطيع أن يحدّثك عنها. هم يعرفونها بالشّجر والمطر، وحبّات التّراب، وأجزاء الجبل الكرمليّ، والملاّحات، ونهيق الحمار، وساحل البحر، وفجرها وليلها، وبردها وصباحها، وخرّوبها. لا يمكن أن أكون أنا الغريب، وذاكرة أبي وجدّي تحمل كلّ هذه الذّكريات والقصص عن هذا المكان. حتّى تلك الأماكن التي تحيط بالطّيرة، حتّى تلك الأماكن، عندما أقرأ أسماءها أقرؤها بلهجة أبي وأمّي وعمّي وخالي؛فهم أوّل من علّمني أبجديّتها، ومنهم سمعت أسماءهاأوّل مرّة. فوادي النّسناس (شكل4) التقيت به في أحاديث أمّي منذ زمن بعيد، و الكبابير والهدّار[3].
شكل (4) وادي النّسناس في حيفا

حين كان هذا الشّعور ينتابني كنت أذهب إلى الطّيرة بمعنويّة عالية، وبفرحة الطّفل. لم يعرف مرافقي لِمَ كنت أصرّ على ألا أركب السيّارة، وأنا في داخل الطّيرة. أردت أن أركب الأرض التي هي أرضي، وأسير فيها، كما سار فيها أبي وجدي فبقوة دوسي على الأرض أريد أن أقول: إنّ هذه هي أرضي وأرض أقاربي من: السّلمان، والباشيّة، وعمّورة، و”أبو” راشد، والبدر، وعلوه، وحجير، والنّاجي، والأبطح، وغيرها من عائلات الطّيرة[4]. كنت أُسوّغ الاستئذان بالقول لنفسي: إنّني كنت سأستأذن حتّى لو دخلت منزل عمّي، لكن- في الحقيقة- شتّان ما بين المرّتين؛ فذاك اجتماعيّ، وهذا سياسيّ.
بعد طول جهد، وصلت الزّلاّقة، حيث بيتي وجذري وخرّوبتي، بدأت أصعد ذلك المرتفع الحبيب، أصبح الطّريق وعرًا، والأشواك تحيط بالمكان. سرت فيه، وكان إصراري ورغبتي وشوقي للوصول إلى المكان، كلّ ذلك يجعلني لا أشعر أو أعترف بوخز أشواكه. بذلت جهدي للوصول إلى مكان بيتنا؛ لكي أراه أو أرى أيّ شيء من بقاياه. كان اللقاء حميما بأرضي وطئت روحي ترابها لأوّل مرّة، شعرت أنّ التّراب تحت قدمي يبتسم، وحبّاته بدأت تتهامس فيما بينها، فرحة مستبشرة خيرا؛ أنّني ما زلت على قيد الحياة، وأنّني لن أنساها، حتّى حشرات الأرض المختلفة في المكان بدأت تقترب، وكان يوما غير عاديّ لها، كانت قدماي لا تقدران أن تدوسها كما يفعل هذا الغريب الغريب! بدأت أبحث عن بيتنا؛ذلك البيت العزيز الذي شهد دموع الفرح الأولى بعيون أمّي-يوم زواجها-وشهد دموع الحزن الأخيرة بهايوم إجبارها على مغادرة المكان.
أحسست أنّني أقترب، عندما ظهرت أمامي خرّوبتنا الحبيبة، في تلك اللحظة أصبح لي مرافق من عائلتي-الخرّوبة(شكل5).
شكل (5) الخرّوبة في مرتفع الزلاّقة

أصبحت الخرّوبة- التي ما زالت جذورها ضاربة في الأرض وثابتة بتاريخها كما نحن – دليلي وبوصلة تحرّكي ومعرفتي بالاتّجاهات. تخيّلتها تمسك بيدي وتهديني، حيث أشاء أن أذهب. أحسست أنّها تحدّثني عن أبي وأمّي وسميحة وزريفة وخليل ورومية وعيسى، الذين عاشوا في هذا المكان. أعادتني للتّاريخ، وأرجعت جغرافية المكان كما كانت قبل أن يلوّثها الغريب، أعادت الحقائق وجعلتها وقائع. بدأت بقايا بيتنا تظهر، هنا أبطأت المسير، شرعت أدوس في أعزّ الأماكن التي أملك، أخذت أخاف على الأرض من قدمي، تمنّيت أن تكون هي من يدوس على قدمي لأسير، وجدت مكان البيت وبقايا حجارة (شكل6). كان حزينًا قبل لحظات والآن يبتسم، لمست حجارته وترابه.
شكل (6) بقايا بيتنا في مرتفع الزلاّقة جنوبيّ الطّيرة.

بدأت أبحث عن أيّ شيء من بقاياه، قفز قلبي فرحًا وحزنًا، عندما التقطت يدي غال بابنا القديم والإطار الحديديّ لشبابيكه (شكل7).
شكل (7) يُظهر غالباب بيتنا وبعضًا من ترابه وحجارته العزيزة.

في تلك اللحظة القاسية، عزلت عن عالم اليوم، وسرت خارج المكان والزّمان، بدأت أرى أشياء حصلت قبل أن أولد، عاد البيت كما كان، وعادت جدرانه تضمّ من كانت تضمّهم قبل أعوام. ولم يعد هناك أثر لثقوب في الجدران سببها رصاص وشظايا، وضجّ المكان بأصوات الأطفال؛ هذا وجه أبي، وهذا وجه أمّي، ظهرا من جديد، ومياه وادٍ قريب كانت قد جفّت، بدأت تتدفّق من جديد، والآن أسمع صوته، وأوراق شجرة الخرّوب- التي كانت قد تجمّدت، وبقيت طائرة مع حركة الرّيح الأخيرة إلى جهة اليمين، ولم تعد إلى اليسار؛ لأنّها أبت أن تتفاعل مع الرّيح منذ غادرت عائلة أبي وأمّي المكان- رجعت إلى اليسار، وبدأت تتحرّك من جديد كما تشاء الرّيح، عاد الطّابون دافئًا، والرّماد نارًا. في ثنايا هذا البيت، عاش قبل أعوام، أحمد وزوجته آمنة وأولادهما وبناتهما: سميحة، وزريفة، وخليل، ورومية وعيسى.
كان أبي شابًّا نشيطًا يحبّ العمل، وكان-كحال الكثيرين- سعيدًا بأولاده وبناته، انتظرَ قدوم خليل طويلًا، كان خليل بالنّسبة إليه رجل البيت الثّاني، أعطاه من وقته ومن جهده، كذلك فعلت أم خليل، كان طموحًا يفوق التّصوّر في تلك الفترة القاسية من الزّمان، بذلا جهودًا جبّارة؛ حتّى يكبر أبناؤهما، ويصبحوا على أحسن حال، كان خليل ذكيًّا ويكبر عمره، وكان أبي سعيدًا بذلك؛ فهو توّاق ليرى خليلًا كبيرًا، كذلك الحال عند عيسى؛ لقد أعطته أم خليل كلّ وقتها، اعتادت مجالسته وتعليمه الكلام، وفَعلا الشّيء نفسه مع ابنتيهما؛ فلم يبخلا عليهما بوقت أو جهد.
فضّلت أم خليل أن يبقى أولادها قربها كلّ الوقت حتّى وهم يلعبون؛ كانتتخاف عليهم حتّى من الرّيح. اعتاد خليل ورومية أن يلعبا في فناء بيتهما الجميل، على مَرأى من عينَي أمّهما. في صباح يوم رمضانيّ حارٍّ، قرّرت فيه أم خليل أن تحمِّم أبناءها، بعد أيّام طويلة أمضوها مختبئين؛ خوفًا من القصف الصّهيونيّ، في مغارة قريبة من البيت، كان القصف أعمىكما هو ضمير المعتدي. اعتاد أبناء آمنة الطّيراويّة الطّيّبة أن يذهبوا إلى بيت جدّهم حسين- في وسط البلد، معظم الأوقات- لكنّ والدهم أحمد طلب من بيت جدّهم عدم السّماح لهم بالذّهاب إلى هناك في تلك الأيّام؛ لأنّ بيت جدّهم كان في وسط البلد، وكان أكثر عرضة للقصف.بعد ذلك الحمّام سمحت أم خليل لأبنائها بالّلعب- كالمعتاد قليلًا في فناء البيت- بِكُرَة خليل التي خاطتها له من قماش وجوارب قديمة.
كان كلّ شيء هادئًا، وكانت أصوات بريئة تخرج من هنا وهناك، لأطفال فرحين بالّلعب. خليل يبتسم ويركض ضاحكًا مع أخته رومية، يبادلها الضّحك والّلعب والفرح، وعيسى الطّفل الصّغير يسير ببطء حولهما، وبجواره قريبهم خالد هاني علوه. كان الهواء هادئا، ولا غبار في المكان، لا شيء يفوح سوى رائحة الورد وبراءة المكان، وأم خليل تحوم في بيتها، وتجمع ملابس أبنائها؛ لتغسلها. قرّرت- بعد ذلك- أن تخرج إلى فناء المنزل؛ لتطلب من أبنائها وابن الجيران الدّخول إلى المغارة؛ لأنّ المحتلّ لا يعرف الشّفقة، ولا يفهم فرح الأطفال. خرجت إلى فناء المنزل، وبدأت تنظر إلى أبنائها: خليل الذي كان يرتدي سروالًا بنيًّا وقميصًا أصفر، ورومية التي ربطت لها شعرها الذّهبيّ برباط أبيض، وعيسى الذي أرضعته وجبته من الحليب قبل قليل، بعد الاستحمام. كانت تهمّ بالطّلب منهم الدّخول إلى المغارة.
وفي لحظة قاسية مرّت كالجمرولم تنطفئ، قصفت عصابات الصّهاينة منزل أبي خليل وأبنائه الصّغار، في لحظة انتعاش، بعد حمّام أمّهم الأخير لهم، ولعبهم معاً في فناء المنزل، كانوا في أوج سعادتهم وضحكهم، وأمّهم تشاهدهم، وبقايا فطورهم ما تزال في “سدر” الأكل؛ السّدر الذي كان يعرفهم، ويميّز دقّات أكواب الشّاي عليه، وكانب منزلة إعلان عن إفراغ الكوب منه، وإعلان الرّغبة في المزيد من الشّاي. كان شَعرهم ما يزال مبتلًّا، وكانت أجسادهم البريئة نظيفة، وابتسامات عذبة ترتسم على وجوههم؛فرحًا بالسّماح لهم بالّلعب قليلًابعد حرمانهم؛ خوفًا عليهم من جنون المعتدي المريض. وفجأة، ودون إذن أو قرع على الباب، انفجرت القذيفة في أجسادهم النّاعمة، فالتهمت فرحتهم، واغتالت أحلامهم، فأسقطت خليلًا ابن خمس السّنوات شهيدًا، اغتالته قبل أن يعرف أين يذهب بابتسامته، واغتالت حقّه حتّى في البكاء، ارتكب العدوّ أبشع الفظائع: القتل، والتّعذيب، والحرق، وطمس معالم الجريمة. مات خليل وهو لا يستطيع أن يقول إنّه يتألّم،كان عليه أن يقول: إنّ هذا العدوّ يضحكه ولا يبكيه، تمامًا، كابتسامة المُختَطَف ومديحه لخاطفيه، على أنّه يُعامل بصورة لائقةٍ، عندما يُطْلَبُ منه ذلك، تحت وطأة التّهديد، في شريط مصوّر. استشهد وهو يبتسم، كان الموت أسرع من قدرته على تبديل معالم وجهه، من مبتسم فرح إلى باكٍ متألّم مندهش ممّا يحدث له، وربّما زاد من ألمه أنّه شاهد آلام أمّه وهو يتوارى. وتمزّق جسد عيسى ابن السّنة والنّصف، وتركته القذيفة ينزف، ويسبح في دمائه ساعة، قبل أن يستشهد. لم تستطع أمّه فعل شيء في تلك الَّلحظة؛لقد أصيبت إصابة بليغة، ولم ترحمها القذيفة، وبقي عيسى متشبّثًا بثوبها، ويصيح: يا دادا، يا دادا، قبل أن يلفظ أنفاسه الطّاهرة.لقد جعلته شدّة الألم ينسى أنّ من يمسك بثوبها، كان يقول لها قبل لحظات، في الحمّام: ماما. وليس دادا! طفل لم يصل عمره السَّنتين، يمرّ بهذه التّجربة القاسية!
وفي ركن آخر من البيت، سقطت رومية ابنة ثلاث السّنوات والنّصف، وهي تصيح، ودماء غزيرة تفيض من جسدها الطّاهر البريء، وسميحة البنت الكبرى، لم تتركها شظايا الشّيطان تفلت من الإصابة، فأنزفتها واخترقت رجليها. في تلك اللحظة احتارت أم خليل ماذا تفعل بدمائها؟! وصريخ أبنائها المصابين حولها جعلها لا تعرف ماذا عليها أن تنتظر أو ماذا عليها أن تفعل. خوف وهلع واندهاش وضعف، يجعل من الاستسلام للموت وانتظار الآخر لتقديم يد المساعدة، أسهل الحلول.
كان القرب من الموت يجعل التّفكير بالهرب منه شيئًا سخيفًا؛ فالغبار الذي سبّبه انفجار القذيفة، وما اختلط به من خوف وبقايا أجساد بريئة ودماء، وألم، وصراخ، وموت، ودهشة، وعدم مقدرة على استيعاب ما يحدث، ورغبة بالهروب أو النّجاة، والدّخول في عالم الموت، والاقتراب منه ومشاهدته، والدّخول في فمه بهذا الشكل…،كان ذلك كلّه أكبر من طفولة هؤلاء الأطفال، وأكبر شهادة على أنّ مسبّبها غاصبً محتلّ، جاء لتلويث هذا المكان وأصحابه، وتسميم فرحتهم وأحلامهم، تمامًا كما تفعل شظايا قذائفهم التي منحهم إيّاها هديّة مَنْ يدَّعي التّحضّر، والرُّقيّ، وانتسابه إلى لعالم الأوّل، وحرصه على السّلم العالميّ.
إنّ قذائفهم تدخل الآن أجساد هؤلاء الأطفال الأبرياء، وجسد أمّهم التي لا تعرف شيئًا سوى احترام الزّوج، والعناية بأطفالها الذين يصارعون الموت أمام عينيها.
لم ترحم القذيفة خالدًا أيضا، صديق خليل الذي كان يشاركه قبل قليل الّلعب، والآن يشاركه الموت، فاغتالت طفولته، وجعلته يسقط شهيدًا إلى جانب خليل.مات خالد قبل أن يستلم كرة خليل الأخيرة؛ فقد سبقتها شظيّة الغريب، بقيت الكرةُ تتدحرج بينهما دون أن تجد من يلتقطها.
لماذا على خليل أن يدخل عالم هذه القذيفة وما عليها من أرقام متسلسلة وحروف ومميّزات تتعلق بسعتها وعيارها وأشياء أخرى لا علاقة للطّفولة بها؟! لماذا لا تدخل كلّ هذه التّفاصيل في عالم أطفال صانعها؟ لماذا على أبنائه أن يروا والدهم بلباسه الأنيق بعد أن يعود من مصنع القذائف، ولا يروا ما تفعله منتجات والدهم بأطفال مثل خليل؟ لماذا يرون والدهم-وحده- بلباسه الأنيق وعطره الفوّاح، الذي يختلف كثيراً عن رائحة البارود التي استنشقها خليل؟!
لا يعرف أطفال مَنْ صنع القذيفة أنّ أباهم الغربيّ المتحضّر هذاقد أهدى- هو وعالمه الغربيّ-مجرمًاقذيفة بعد أن سمحوا له بالدّخول من البحر، بطريقة غير شرعيّةوفي جنح الظّلام، وتسلّل إلى أعماق أرض طيّبة من غير إذن، وتدرّب على أبشع الطّرق؛ لقتل أناس آمنين.لا يعلم أطفال الغرب أنّ أجدادهم قد سمحوا لأعداد كبيرة من عيّنة هذا المجرم- الذي استخدم قذيفة فتّاكة ضد جسد خليل البريء- بالدّخول؛ ليقضّ بها مضاجع أطفال أبرياء، ويوقف أحلامهم، ويبكي شجرهم، وينهي قصّتهم، ويشرّدهم عن أوطانهم.
وصل أهل أم خليل إلى مكان الكارثة بعد أن سمعوا الخبر من الجيران،، وكان من بين مَنْ وصل منهم والدة أم خليل الحاجّة سعاد التي هرعت إلى ابنتها آمنة أوّلا، وبعد أن اطمأنّت إلى أنّها ما زالت على قيد الحياة، بدأت تركض إلى الآخرين،ركضت إلى خليل الذي وجدته مستشهدًا وخطّ من الدّماء خلف أذنه، ورأت رومية ابنة ثلاث السّنوات تغرق بدمائها، ولا تستطيع الحراك. استشهدت رومية بعد ذلك بأسبوع خلال رحلة الهجرة القسريّة إلى الأردن، لقد فارقت الحياة – رحمها الله- في الطّريق، في بلدة اجزم القريبة من الطّيرة. وكان من بين المصابين سميحة، أختهم الكبيرة؛ أصيبت في رأسها ورجليها الّلتين ما تزالان تشهدان على هذه الجريمة.
في الطّرف الآخر، كان قاصف القذيفة ربّما يبتسم فرحًا، وسيجارته في زاوية فمه، وعبريّته المهجّنة باللغات الأوروبيّة تنطلق من الزّاوية الأخرى من فمه، بلا مبالاة وبطريقة أقرب إلى التمتمة منها إلى الكلام، تبشّر بخبر قدرته على قتل ثلاثة أطفال، وحرق والدتهم. كان يتحدّث وكأنّه يتحّدث عن دكّ من ورق اللعب، لعبه للتّوّ، مع ضابط أعطاه أمر القصف، بلغة عبريّة- أيضا- ملوّثة بإحدى اللغات الأوروبيّة، التي لربّما بأحرف إحداها قد كُتِب على تلك القذيفة مكان صنعها، وشيء من ميزاتها وقدرتها على الفتك والدّمار، وعيارها، وأشياء أخرى، لا دخل لخليل ولا لطفولته بها. كان القتل عند ذلك الغاصب شيئًا عاديًّا، لا يستدعي التّخلّص من سيجارته لثوانٍ لزفّ الخبر.
ترك هذا القاتل أهل القرية حيارى بما يفعلون، وماذا يفعلون مع هذا العدد من الإصابات والموت والحزن والحيرة؟! الموقف وحجم الإصابات ونوعها، أكبر من كلّ إمكانيات أهل القرية.
يعتقد معظم أهل البلدة أنّ تلك القذيفة قصفت على المنزل من مدفعيّة صهيونيّة تمركزت في مكان اسمه خوزه (اخوزه)؛ وربّما هذا هو السّبب الذي جعل أم خليل لا تحبّ هذا الاسم، وكلّما ذكر بحضورها قالتعبارتها الشّهيرة: “كان المقطوعون يضربوننا من هناك”.
أصرّ أبو خليل على البقاءفي قريته والصّمود فيها، كما فعل الكثير من سكّان القرية؛ فجاءت هذه القذيفة محاولةً لتحطيم هذا الصّمود. حتّى عندما حاول عمّ خليل الكبير، عليّ، أن يأخذ خليلًا معه إلى الأردنّ؛ذلك أنّه كان يحبّخليلًا كثيرًا ومتعلقًا به، رفض أبو خليل، وأنزله من سيّارة عمّه، وقال: أبقى أنا وأبنائي جميعا هنا، نموت معًا أو نحيا معًا.
قام أهل الطّيرة الطّيّبون-بعد أن بذلوا جهودًا جبّارة في مساعدة المصابين-بنقلهم إلىالمسجد. دُفن الشّهيدان: خليل، وعيسى، في مقبرة القرية الجنوبيّة،دُفنواعلى مقربة من قبر الشّيخ العبد المحمود شقيق جدّهم “محمّد سعيد”؛ ذلك لأنّ العبد المحمود كان شيخًا وجيهًا له مكانة في منطقة السّاحل الفلسطينيّ، كان قبره -رحمه الله- من طبقتين؛ لذلك اعتقد أقارب الشّهيدين أنّ دفنهمافي هذا المكان سيسهّل عليهم التّعرّف على قبورهم عندما يعودون إلى البلاد؛ لأنّ قبر الشّيخ العبد مميّز ومعروف.
الذي لم يُصب من هذه العائلة الطّيّبة أبو خليل، كان خارج البيت، وابنته زريفة. ربّما لم يُصَب جسد زريفة،لكنّ روحها تمزّقت ألمًا واعتصرت قهرًا، لم تتوقّف عن البكاء؛ حزنا على أختها الكبرى سميحة، وعلى أخويها الأصغرين خليل وعيسى، وأختها الصّغرى رومية، بكت على نفسها كأنّها مصابة؛لأنّ الكلّ مصاب،كانت المأساة كبيرة، ولم يكن يعلم هذا الرّجل الطّيّب وزوجته الصّابرة أنّ ثنائيّة كان اسمها(أحمد محمّد سعيد السّلمان، وآمنة حسين عمورة) لن تلتقي في بطاقة دعوة زواجهما أو وثيقة عقد قرانهما- عندما قرّر خطبة آمنة عام 1938- فحسب، بل إنّ اسمه واسم زوجته سيكونان معًا-أيضا-عنوانًاكبيرًالهذه الجريمة النّكراء، التي ارتكبتها العصابات برعما بريئا. الصّهيونيّة بحقهما بعد عشر سنوات من زواجهما، عام 1948. لم يكن يعلم أحمد أنّ فرحتهبكلّ طفل رزقه الله إيّاه سيقابلها نهر من دموع الحزن على فراقهوقتله بأيدي هذه العصابات الآثمة، وهو ما يزال لم تعلم آمنة أنّألم الولادة الذي صبرت عليه سيكون نتاجه طفلًا جميلًا طالما حلمت به، وأنّه سيكون مجرّد رحلة في عالم الألم الذي سيسبّبه لها عصابات الصّهاينة، سواء لها أو لأطفالها الثّلاثة الشّهداء. لم تعلم أنّ هناك من كان يتربّص لهذا الزّواج، وينتظر ثماره من الأطفال؛حتّى يفتك بهم ويمزّق أجسادهم وأحلامهم، قبل أن تكتمل.
لم يعلم الكرمل ولا البحر المجاور ولا الزلّاقة، ولم تعلم السّماء ولا الغيومالتيقسم لها الله أن تكون فيذلك اليوم من يحوم في سماء الطّيرة، ولا شمس ذلك اليوم ولا الوقت ولا الخرّوب، أنّ جريمة بشعة جبانة ستقترفهاعصابات الصّهاينة بحقّ أطفال ثلاثة ووالدتهم.لم تعلم شجرة الخرّوب القريبة من منزل أبي خليل، التي شاهدت أطفاله الثلاثة يلعبون ويضحكون، أنّها ستكون أقرب شاهد من مكان الجريمة، وبأنّها ستكون أوّل شاهد في الطّبيعة، يشهد على أنّ دولة الصّهاينةكيان غير طبيعيّ. وأنّ خليل ورومية وعيسى لا يلعبون هذه المرّة، بل يموتون. لو علمت أم خليل أنّ حمّام ابنها خليل أو عيسى أو رومية سيكون الأخير، ربّما ألغت فكرته في ذلك اليوم؛لتكسب وقتًا أطول معهم قبل الوداع، ولتعفيهم من بعض الدّموع المنهمرة؛ من فكرة الحمّام والصّابون في العيون عند الأطفال. لم تعلم أنّ المكان الذي كانت تسيِر فوقه ليفة الحمّام على أجساد أطفالها، سيسير عليه بعد لحظات شيء غريب مؤلم اسمه شظايا،لم يعرف نوبل أنّ خليلاً ورومية وعيسى سيكونون من ضحاياه؛إذ يبدو أنّه لم يخطر في باله أنّ هناك أناسًا سيستغلّون اختراعه لتفجير فرحة طفل، وتمزيق أحشائه أمام عيني والدته، والتّدخّل في حياة رجل فلسطينيّ طيّب كسائر أفراد القرية، وتحويل حياته إلى مأساة لم تنته، وحزن لم يفارقه حتّى عندما ناهز عمره الثّمانين.
بقي بعض أهل البلدة والمصابون أسبوعًا في المسجد، بعد ذلك بدأ مشوارهم مع التّشرّد عن الدّيار،لم يعد لأم خليل شيء تأخذه معها سوى جراحها وألمها، لن يرافقها خليل الطّفل كما كان يفعل دائمًا، أو عيسى الرّضيع، وهماالّلذان كانا معها كلّ الوقت قبل أيّام، حمّامها لهم آخر حدث جمعهم أحياء دون ألم ودماء.
قامت متثاقلة وهي لا تريد؛ خافت إذا ما فارقت وبدأ المشوار أن يصبح موت خليل وعيسى حقيقة من الصّعب أن يتحوّل إلى حلم ثقيل، اعتادت أن تخاف الأحلام، لكنّها الآن تتمنّاها، لا تريد أن تفارق القبر والإنسان الحيّ الذي فيه. كلّ شيء لا يمكن أن يكون حقيقة، حقيقة أكبر من أن تكون حقيقة دفعهً واحدة. يقولون إنّ مثل ذلك لا يحدث إلا في الأحلام، فلماذا لا تكون حلمًا؟!
ذهبوا إلى اجزم حيث فارقت رومية الحياة، ودفنت هناك، ثمّ إلى عارة وعرعرة. تذكر سميحة المصابة أنّ خالها محمّدًا حملها على ظهره طيلة الطّريق،وتذكر- أيضا- أنّها فقدت وعيها أكثر من مرّة؛من شدّة النّزيف؛لأن إصابة رأسها بالغة. كذلك لم تكن أم خليل في وعيها معظم الوقت، كان جرحها عميقًا، وحزنها أعمق، كان الجرح يفقدها الوعي، والحزن يوقظها منه. أصبحت محاصرة بالجراح بكلّ أنواعها. أم خليل عاطفيّة ورقيقة دون جراح، فماذا يمكن أن يحدث لهذا النّوع من البشر الرّقيق الحسّاس الهادئ بعد هذه التّجربة المريرة مع الدّم، وفراق أطفالها دون وداع، ومع الألم والدّموع والاستشهاد؟! عواطفها أرقّ من أن تحتمل هذه القسوة. ربّما كان سلاحها الوحيد في تلك اللحظات الاستسلام للموت الذي لم يأت، أو الحزن على أنّه قدر.
عواطفها تقاسمت الأدوار:جزء للجرح النّازف، وجزء لعيسى، وآخر لخليل، وآخر لرومية، وآخر لزوجها المقهور، وآخر حزنًا على حزن الآخرين. ماذا على الإنسان أن يفعل إذا نفدت منه مادّة الحزن والعاطفة ولم تعد تكفي؟ماذا عليه أن يفعل إذا أصبح إنتاج الحزن أسرع وأكبر من إنتاج الدّمع والعواطف؟ ماذا عليه أن يفعل؟أيبكي بشدة؟! وهل البكاء وسيلة لقتل العاطفة، وتقسية القلب مؤقّتًا، حتّى يتمّ تجاوز المحنة، ولكي نحمي أنفسنا من الهلاك؟! وهل نصف الشّخص الذي لا يبكي أنّه قاسٍ؛لأنّ قلبه من القسوة بمكان؛بحيث إنّه ليس بحاجة للدّمع ليزيده قسوة.
آلام أم خليل وصمتها الحَيِيّ، وهدوؤها وخجلها، واختلاط الدّمع بالدّم، اختلاطا حقيقيّا وليس شعرا أو مجازا، وانتهاء فكرة الجوع أو الشّعور به في ثنايا هذا العذاب والألموالحزن -كلّ ذلك يشكّل منابع لفهمفلسفة البكاء والعاطفة والقسوة.
لم أفهم كيف تحمّلت أم خليل كلّهذه الآلام، وهي المرأة التي أعرفها،ولا أعرف مخلوقًا على الأرض أعرفها كما أعرفها. لا بدّ من آليّة معيّنة يعين الله بها الإنسان – من أمثال أم خليل- إذا ما داهمه سوء الأرض بهذا الشّكل، أو هذا النّوع من البشر الذي يقتل وهو يدخّن. هل هو نوع جديد من الموت لم نعرفه من قبل؟! لا يمكن أن يكون شيئًا أقلّ ألمًا من الموت! كيف تحمّلت آمنةالتي أعرفها رقيقةً كنسمةٍ، كلّ هذا الألم والحزن والقسوة والرّيح والبعد والفراق؟!كيف تستطيع هذه الرّقّة مواجهة كلّ هذا الحزن والقسوةوالألم؟!
بعد هذا السّفر الشّاقّ مشيًا على الأقدام، بدأت رحلتهم إلى نابلس بالشّاحنات. في نابلس استقبل عائلة أبي خليلصديقه وشريكه صدقي العاصي. مكثوا عنده يومين، ثمّ بدأ رحيلهم إلى الأردنّ بسيّارة عَلِيّ، شقيق أبي خليل، حيث قابلهم هناك؛فقد غادر عليّ إلى الأردنّ قبل القصف،ثمّ عاد إلى نابلس؛ للبحث عن عائلة أخيه، بعد أن سمعبالمأساة التي حلّت بها.
وصلوا إلى الأردنّ، فذهبوا فورًا إلى قرية سال القريبة من مدينة إربد، حيث استأجر شقيق أبي خليل، عليّ، بيتًا. صاحب البيت – كباقي أبناء شرقيّ الأردنّ- كان كريمًاسخيًّا؛استقبل هؤلاء المنكوبين على أحسن وجه، بدأت أم خليل وابنتها سميحة رحلة العلاج الصّعبة في الأردنّ،في منطقة اسمها ظهر التّلّ في مدينة إربد، وجد مستشفى ميدانيّ تلقّتفيه أم خليل وسميحة علاجهما. عالجهما في هذا المستشفى طبيب عراقيّ اسمه عليّ، بعد ذلك تلقّتا العلاج في المستشفى المعمدانيّ في عجلون،ثمّ عند أطبّاء في مدينةإربد. من تبقّى من العائلة- أبو خليل وأم خليلوابنتاهما سميحة وزريفة-عاشوا أوضاعا نفسيّة شديدة القسوة، في جوّ جديد ووجوه جديدة، وتشرّد وقلّة مال، وجراح وأحزان؛ لفراق خليل وعيسى ورومية. ذكرت أم خليل أنّ أبا خليل بقي بعد استشهاد أبنائه شهرين دون أن يبدّل ملابسه.أمّا أم خليل فقد جفّت مآقيها، ولم يبق هناك إلا الصّبر علاجًا للألم والحزنوقسوة فراق أحبّتها؛أبنائها الثّلاثة الذين استشهدوا قبل الأوان. أصبح عمر أبنائها الشّهداء هاجسًا لا ينتهي في حياتها؛ذلك عندما رزقها الله بأبناء جدد، كانت تراقب أعمارهم، وكلّما اقترب أحدهم من عمر أحد أبنائها الشّهداء أحسّت بخوف شديد، وشعرت بأنّ هذا عمر الفراق، شعرت بأنّ هذه مرحلة حرجة من العمر؛فهي تخاف أن يفارقها ابنها الجديد كما حصل مع أخيه وأخته؛ فما إن يقترب أحد أبنائها من السّنتين أو أقلّ قليلًا-وهو عمر عيسى عندما استشهد-حتّى تبدأ دوّامة الخوف بالظّهور، وما إن تنتهي حتّى يبدأ هاجس الخوف هذا بالظّهور ثانيهً عند الاقتراب من عمر ثلاثالسّنوات والنّصف تقريبًا، وهو عمر الشّهيدة رومية.وما يكاد هذا العمر ينتهي حتّى يخالجها من جديد، عندما يقترب أحد أبنائها الجدد من عمر خمسالسّنين. وهكذا عمل هؤلاء القتلة؛ استطاعوا أن يجعلوا هذه المرأة الطّيّبة تعيش مأساة فراق أبنائها الشّهداء الأطفال،وألم هذا الفراقمع كلّ طفل جديد رزقها اللهإيّاه. لوّثوا فرحتها بالدّموع وبالخوف من الفراق،لوّثوا ألم الولادة الذي يبعث فرحًا بألم الفراق والموت الذي عانت منه أم خليل.
وأصبحت تشعر بالإحباط، حتّى في أشدّ مراحل الولادة؛ بسبب تذكّرها أنّها في يوم من الأيّام قد عانت هذا الألم، إلا أنّ ثمار ذلك الألم خطفه الغريب في لحظة.
فكرة الطّفل والطّفولة أصبحت عند أم خليل مقترنة أكثر ما يمكن بالموت والفراق المبكّر، من غير ذنب، أصبحت ضريبة لا بدّ من دفعها في مرحلة ما من العمر؛حزنٌ لا مفرّ منه؛ وربّما هذا ما يفسّر خوفها الشّديد على أبنائها، حتّى من الماء وهي ابنة البحر؛ فالطّيرة لا تبعد إلا ثلاثة كيلومترات عن البحر الأبيض المتوسّط؛ إنّه بحرها وبحر أجدادها، ومياهها الطّبيعيّة، ولا يمكن أن يكون إلا كذلك؛ فقد ولدت وهي لا تبعد عنه؛ وهذه حقيقة طبيعيّة أكثر ثباتًا من كلّ الخرائط الجديدة والأساطيل والقرارات التي لم ير متّخذوها الزّلاّقة يومًا، ولا يعرفون من البحر إلا أكثر الأماكن ملاءمة لرسوّ حاملات طائراتهم.
الذي يملك أدوات القتل هذه لا يعرف شيئًا عن أيّام البحر البريئة التي عاشها مع أصحابه الطّيّبين، لا يعلم أنّ البحر تمنّى لو يستطيع إغلاق ذاته عندما داهموه، وأنّ موجه تمنّى أن يعكس ذاته، وأنّ المدّ تمنّى أن يصبح جزرًا؛ حتّى لا يرى أصحابه هذه الوجوه الغريبة، تمنّت الرّياح ألّا تسير كما تشتهي السّفن؛ فأصحابها وأصحاب البحر الشّرعيّون لا يملكون السّفن.
هاجس الفراق هذا توارثه أبناء أم خليل الذين لاموها لخوفها الشّديد عليهم؛ فقد أصبح عُمر الشّهداء خليل ورومية وعيسى محطّة خوف، تسكنهم كلّما اقترب عمر أحد أبنائها منها؛ حتّى إنّ أبا خليل لم يجرؤ على تسمية المولود الأوّل له بعد الهجرة باسم خليل، على اسم الشهيد خليل،فسمّى ابنه الجديد صالحًا،إلا أنّه ولكونه يكنّى بأبي خليل، بقي النّاس ينادون المولود الجديد: خليل. وبعد مرور وقت من الزّمن تجرّأ وسمّى المولود الجديد الثّاني عيسى، على اسم الشّهيد عيسى،وأطلق اسم رومية على اسم ابنته الجديدة.
لقد تشكّل وجداني في بيئة الحزن هذه، واستشهاد ثلاثة من إخوتي أمام عيني أمي؛ نتيجة للقصف الهمجيّمن العصابات الصهيونيّة لقرية طيرة حيفا عام 1948.كلّ صباح ومساء أرى أثر هذه المأساة في عيني والدتي، وفيما تبقّى من أثر لهذا القصف في جانبها الأيسر، وفي أقدام أختي سميحة التي نجت بأعجوبة من هذا الاعتداء. لقد تفتّحت عيناي على ترحّم والدتي على أرواح أبنائها الثلاثة الذين فقدتهم في لحظة واحدة، وكلّما ترحّمت عليهمأو أقسمت بأرواحهم، لا بُدّ لها أن تضيف عبارة “الذين فقدتهم في لحظة واحدة”. يبدو أنّ فكرة فقدان الأحباب بهذا الشكل الجماعيّ شيء مؤلم، لا يمكن إلا الشّعور بوخزه عند اليمين.
أتذكّر والدي، في يوم من الأياّم القليلة التي تجرّأ فيها بالحديث عن قصّة استشهادهم؛ إذْ كان ذكرهم شيئًا مؤلمًا وقاسيًا جدًّا، أتذكّر أنّه قال: ” كانت أختك الشّهيدة الطّفلة رومية شقراء ذات عينين ملوّنتين، لقد تألّمت كثيرًا قبل أن تفارق الحياة، لقد كانت جراحها…”. وقبل أن يكمل حديثه بدأ يبكي بكاء شديدا، وهو الشّيء الذي فاجأني فوالدي معروف بالصّلابة، ودمعته لم أرها يوما. لم أعلم أنّ أبي يحمل كلّ هذا الحزن إلا في ذلك اليوم، لم أعلم أنّ لأبي دموعًا؛ لأنّني لم أرها من قبل؛ فالرّجال لا يبكون، هكذا كان إدراكيّ الطّفوليّ.
لقد كان أبي-رحمه الله-يتجنّب الحديث عن ذلك؛ فاستشهاد أبنائه الأطفال، قتلاً وحرقًا وألمًا، يبدو أنّه كان شيئًا لا يمكن التّطرّق إليه والحديث عنه. ما زلت أعتقد أنّ أبي عندما تحدّث في تلك المرّة النّادرة عن أحدهم، كان يتحدّث إلى نفسه. لقد كنت معه، نجلس وحدنا؛ يبدو أنّ وجودي وحدي معه في تلك اللحظة- وعمري قريب من عمر خليل عندما استشهد، وفي ذلك المكان القريب من مدارس الوكالة، الذي يرمز بكلّ تفاصيله إلى تلك المأساة، حيث بنيت هذه المدارس لضحايا الإرهاب الصّهيونيّ وأبنائهم، وقرب شجرة تشبه الخرّوب، وكنت قبلها بقليل ألعب بقربه- جعله يتخيّل أنّه جالس في الزلاّقة، قريبًا من خرّوبة البيت التي شهدت الجريمة، وكانت شاهدا على خطف إخوتي من فرحتهم وهم يلعبون، وأنّه يراهم الآن هم من يلعبون بلعبي.
تلك الخرّوبة التي هي الشّاهد غير المحايد، طيراويّة صادقة؛ فالطّبيعة لا تكذب، وربّما تكون الوحيدة-إلى جانب شظايا القذيفة والشّمس والعشبوالتّراب وغباره- من رأى تألّمهم قبل استشهادهم. لقد كانوا أربعة يتألّمون في اللحظة نفسها، وأمّي مصابة قربهم لا تستطيع إلا النّواح والتّألم والصّراخ. وربّما أحسّت خرّوبتنا بألم إخوتي، الذين تمزّقت أجسادهم بشظايا قذيفة المحتلّ.
استشهد إخوتي وهم بكلّ شيء طيراويّون؛ بقافهم طيراويّون، وبمداركهم طيراويّون أيضا. فهم لا يعرفون إلا الزّلاقة والقفّ والمرقصة.
رجعت إلى البيت في ذلك اليوم، وأنا أحمل دموع أبي معي، حائرا:أأنكرها، أم أخبر أمّي بما حصل؟ بدأت منذ ذلك اليوم أحاول أن أعرف كلّ شيء عن إخوتي، وكيف خطفهم الغريب؟ بدأ دعاء أمّي لهموالتّرحّم عليهم، يشكّل معنًى جديدا في نفسي، أصبحت أحسّ به أكثر، وألتزم الصّمت أكثر عندما تبدأ به، وأبتعد عن شقاوة الطّفولة لحظات،وأشعر أنّ احترامًا وصمتًا يجب أن يكونا في المكان، عندما تذكر أمّي أرواحهم. لقد أنضجني الموت كثيرًا؛فاغتالت إسرائيل بذلك طفولتي أنا أيضا، ولكن بطريقة أخرى. ربّما كان ترتيبي العمريّ بين إخوتي سببًا مباشرًا لقربي من أبي وأمّي -رحمهما الله- فأنا أصغر إخوتي سنًّا.وقد كنت أنا أيضا -بطبعي- أميل لطباعه وعاداته، وأحبّها، وما زلت أذكر كيف كنت رفيقه الوحيد في جولاته أيّام العيد، مشيًا على الأقدام إلى جميع بيوت أقاربه وأحبابه في مدينة إربد الجميلة. جعلت من تلك الأيّام فرصة للانفراد به، اعتدنا أن نبدأ رحلتنا أيّام العيد من شارع حكما شماليّ إربد الحبيبة لنصل إلى أقصى جنوبِيِّها في شارع أيدون، اعتاد أن يحدّثني عن حبّه للطّيرة وأهلها. وقد يكون الهَمّ النّفسيّهذا، المتعلّق بالبعد القصريّ والانسلاخ عن الجذر الموجود في الطّيرة، السّبب المباشر في رغبته الدّائمة بالحديث عن الطّيرة وأيّامها، وعن بابورها وقرقعته والقصص الجميلة التي كان الحيفاويّون يداعبون بها أهل الطّيرة، وعن مداعبتهم لهم بالقول:إنّهم من قوّسوا البحر.
كنت قريبًا من والدتيأيضا، كانت -رحمها الله- مثالاً للزّوجة الصّابرة؛ فقد وقفت مع والدي في محنته.
أصبحت هذه القرية- بكلّ تفاصيلها وأحلامها قبل أن يقتحم بحرها هذا الغريب-أكثر الأحلام التي تسكنني، أصبحت مشاهدتها الحلم الذي لا يفارقني، هي وشجرة الخرّوب التي أضمّها الآن في فناء بيتنا، وأراها تبتسم، وهي تبكي من شدّة الفرح؛ لرؤيتي والحزن على إخوتي، والإصرار على ألّا تكون إلا لنا. قبّلت خرّوبتنا لوفائها، وتواعدنا أن نبقى وفيّين لبعضنا بعضا، وألّا يكون هناك مجال للنّسيان بيننا، مهما طال الزّمان. شعرت أنّ المكان حيّ من جديد، بدأت أفتّش فيه؛ لعلّي أجد أيّ شيء من ذكريات أحبّائي.كنت أريدأن آخذ كلّ شيء معي إلا الخرّوبة؛ فقد كانت هي راية بلادي الطّبيعيّة، ترفرف، وما تزال في المكانتؤكّد هويّته الحقيقيّة،كانت أبهى من كلّ راياتهم المصطنعة.ركضت إلى فناء بيتنا،كنت كلّما اقتربتُ من شيءأكثر،اقتربتْ من ذهني صورة أبى وأمّي أكثر، وتصبح أكثر وضوحا. جلست على بعض بقايا حجارة بيتنا المطلّة على الباحة حيث سقط خليل، لا أتخيّل ألّا أرى خليلًا وعيسى ورومية.
أتخيّلهم الآن أمامي في هذه الباحة، بين الخرّوبة وتلك المغارة، وأتخيّل الزّمان يعود ليسير بشكله الطّبيعيّ، شعرت أنّ خيط الدّماء الذي كان خلف أذن خليل يعود لجسده، ويلتحم ثانية مع باقي دمائه بجسده كما كان، وتخرج الشّظيّة من عرق أذنه، وفي نفس اللحظة تخرج كلّ أجزاء القذيفة من أجساد إخوتي، فتعود أحشاء عيسى التي خرجت إلى موضعها، وكذلك باقي الأجزاء في جسد أمّي وسميحةورومية، وترجع دماؤهم إلى أجسادهم، وتجتمع أجزاء القذيفة ثانيهً، وتصبح قذيفة مكتملة، وبعد أن تتجمّع أجزاؤها كاملة تغادر من حيث أتت إلى فوّهة المدفع، ويعود وجه خليل ليكمل ابتسامته، ويعود شَعرهم مبتلًّا تماما كما كان، وفستان أمّي كما كان، خالياً من الثّقوب التي سبّبتها القذيفة، وسروال خليل بنيًّا، وقميصه أصفر دون غبار، ويعود كلّ شيء كما كان؛ حتّى أبعث أنا بينهم أخًا جديدًالهم، اسمه محمود، لم يعرفوه، وهو -أيضا- لا يعرفهم.أكبر منهم سنّاً، لكنّه أصغرهم! فهم إخوته الكبار الصّغار الذين ولدوا قبله! لقد جمّد الغريب أعمارهم. أخوهم الكبير الذي ولد بعدهم بسنين عدّة! كيف أتعامل مع أخي الكبير الذي يصغرني بسنين، إذا ما تمّ اللقاء؟! لقد خرّب هذا الغريب دورة حياة هذه العائلة، ومفاهيم الزّمن، وعاث في حياة أبناء هذه القرية جميعًا، وجعلهم ينامون في الوحل،بعد أن اعتادوا النّوم في مزارعهم الخضراء، وعلى روائح ورود حدائقهم. هؤلاء الذين اعتادوا أن يحبّوا الزّيتون؛لأنّ الزّيتون طبع ضارب في جذورهم وطبيعتهم، قديم بهم كقدم تلك الشَّجرات التي ما زالت ضاربة بجذورها جنوبيّ قريتنا الطّيرة، لكنّ المشكلة ليست فينا، بل في ذلك الغريب الذي جاءنا من مناطق باردة جدًّا، أو حارّة جدًّا، ولا يعرف شيئًا عن الوسط أو الزّيتون. أمّا نحن فأبناء هذا البحر الحقيقيّون، الذي هو متوسّط وأبيض، ولا نعرف شيئًا أكثر من الزّيتون الذي لا يكون إلا أخضر ومعتدلا كالطّقس الذي ينمو فيه. لقد شكّلنا اعتدال هذا البحر وصفَّى نوايانا، كرمله.
قبّلت خليل وعيسى ورومية، وودّعتهم، وأودعتهم هناك؛فهم أكبر شهادة على الحقيقة والجذر الذي لا بدّ يومًا أن ينبت من جديد.تركتهم في قبورهم؛تلك القبور التي حمتهم من البرد والتّشرّد والقهر؛تلك القبور التي أبقتهم طيراويّين، وأبقت صوت القاف بلهجتهم قافًا،صافحت التّراب والأشجار وكلّ كائنات المكان،غادرت، وبقيت أيدينا متصافحة!
[1]شارع السينما وحي الماسورة والملعب البلدي: أسماء أماكن في مدينة إربد في الأردن.
[2]الزلاقة ولحف المغر ومغارة التشتش والقف وحر يق معمر والمرقصة:أسماء أماكن في طيرة حيفا. سايس: اسم للدلالة على معاهدة سايسبيكو التي قسمت الوطن العربي
[3]وادي النسناس والهدار: أسماء أماكن في حيفا. صوت القاف هو أحد أصوات حرف القاف الأربعة: وكان الصوت المستخدم في لهجة طيرة حيفا العربية. لمعرفة تفاصيل أكثر عن لهجة القرية يمكن الرجوع إلى مرجع آخر لنفس المؤلف
El Salman، mahmoud (2003). The (q) variable in the Arabic dialect of Tirat Haifa. Anthropological Linguistic Journal Vol 45. Indiana University- America
لمزيد من المعرفة حول عائلات الطيرة بالتفصيل (إذ إن العائلات التي ذكرت هنا ذكرت فقط على سبيل المثال لا الحصر). يمكن الرجوع إلى نفس المؤلف في كتابه (طيرة حيفا ما بين 1900 – 1948، دار قدسية، إربد، 1991).