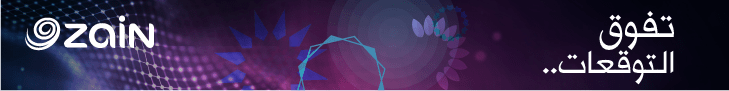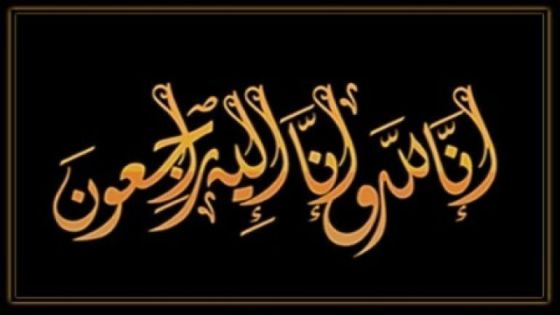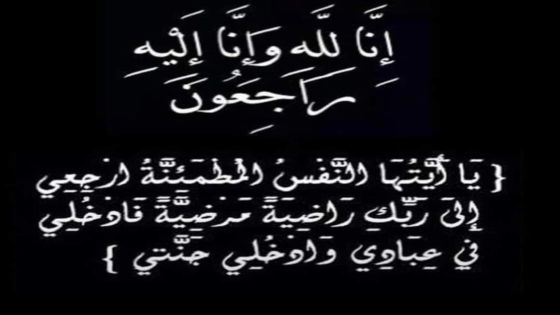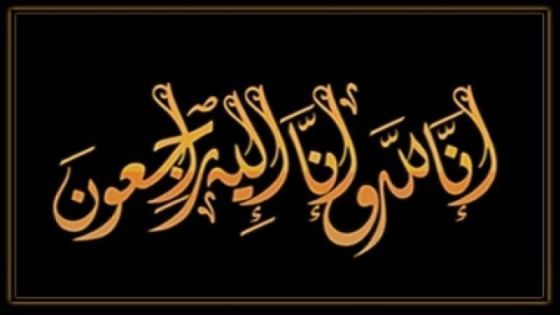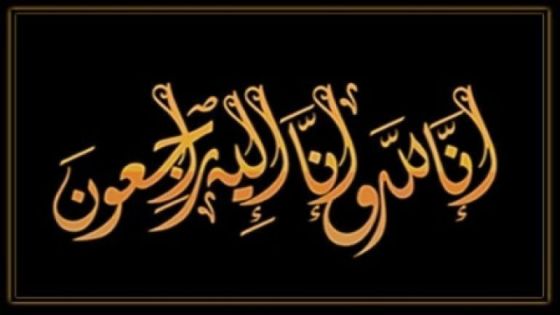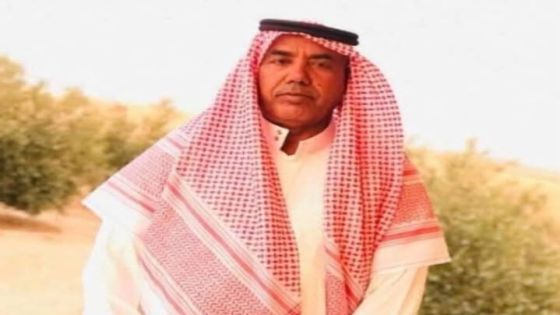المهندس سعيد بهاء المصري
يشكّل فهم العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص في الأردن مدخلًا أساسيًا لتحليل مسار الدولة والمجتمع عبر قرن من الزمن. فمنذ تأسيس الإمارة، احتفظ القطاع العام بموقعه كمركز للسلطة السياسية والإدارية، في حين ظل القطاع الخاص يتحرك ضمن هوامش مرسومة بدقة، متأثرًا بمعادلة الأمن والاستقرار السياسي التي توفرها الدولة. هذه البنية التاريخية أنتجت صورة متوارثة عن رأس المال الوطني بوصفه مترددًا في المخاطرة، ومرتبطًا إلى حد بعيد بالمناخ السياسي أكثر من ارتباطه بآليات السوق الحر.
تكرست عبر العقود ثقافة ضمنية يمكن تلخيصها بمقولة “شاورهم وخالفهم”، حيث اتخذت اللقاءات بين ممثلي القطاعين طابعًا بروتوكوليًا أكثر من كونها حوارات منتجة. إذ غالبًا ما جرى الاكتفاء بالاستماع إلى آراء الفاعلين الاقتصاديين دون تبنيها في عملية صنع القرار، الأمر الذي عمّق الفجوة وحوّل الحوار إلى تواصل غير متكافئ. وترافق ذلك مع مظاهر من المحاباة والمزاجية في إدارة العلاقة، إذ حظيت بعض الشركات أو الأفراد بامتيازات استثنائية بفعل الولاء السياسي أو القرب من دوائر صنع القرار، على حساب مبدأ المنافسة العادلة.
كما ارتبط نجاح القطاع الخاص في مراحل تاريخية محددة بمدى إظهار التقرّب من الحكومات أو المنظومة السياسية القائمة، وهو ما قلّص من مساحة الابتكار والاستقلالية، وجعل العديد من الفاعلين الاقتصاديين أسرى لمنظومة التبعية أكثر من كونهم شركاء فاعلين في التنمية.
ورغم هذه التحديات البنيوية، فإن السردية الأوسع التي حكمت التجربة الأردنية تمثلت في وحدة الشعب ومؤسسة العرش، حيث شكّلا عبر التاريخ صنوانًا لا يفترقان. هذه الصيغة الوجودية أسست لاستقرار سياسي واجتماعي استثنائي في محيط إقليمي مضطرب، وأتاحت للدولة المحافظة على تماسكها في مواجهة تحولات كبرى، وهو ما يُعد من أبرز عناصر الخصوصية الأردنية التي حظيت باهتمام المقاربات المقارنة.
وعليه، فإن التحول المطلوب اليوم يتجسد في الانتقال من ثقافة “شاورهم وخالفهم” إلى “شاورهم واشركهم”، بما يعزز من قدرة الدولة على أن تكون منظمًا محايدًا لا وصيًا متعاليًا، ويحفّز القطاع الخاص على التحول من رأسمال متحفظ إلى رأسمال مبادر ومبتكر. ويقتضي ذلك وضع أطر مؤسسية واضحة للشراكة، قائمة على مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يضمن تكامل الأدوار بدلًا من تداخلها أو تناقضها.
وفي ضوء هذه القراءة، يمكن صياغة مجموعة من التوصيات العملية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أسس مستدامة:
– تحويل مجالس الشراكة إلى منصات حقيقية لصناعة القرار من خلال جداول أعمال محددة، مع إلزام الوزارات بمتابعة تنفيذ ما يصدر عنها.
– تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وإنهاء المحاباة عبر اعتماد معايير موضوعية وشفافة في منح الامتيازات والدعم.
– إشراك القطاع الخاص في عملية صياغة السياسات العامة بصورة مؤسسية لا شكلية، بحيث تُبنى القرارات على التشاور الفعلي لا على الإملاء.
– إعادة تحديد دور الدولة ليتركز على التشريع والرقابة وضمان عدالة السوق، بدلًا من التدخل المباشر في الأنشطة الاقتصادية.
– تحفيز رأس المال الوطني عبر سياسات ضريبية وتشريعية تشجع المخاطرة المدروسة والابتكار.
– بناء آليات ثقة مؤسسية ومساءلة مشتركة تضمن استمرارية الحوار وتراكم نتائجه.
– تطوير الاستثمارات المشتركة بين القطاعين بما يساهم في الاقتصاد الوطني دون احتكار، على أن تستهدف هذه الاستثمارات أسواق التصدير بالدرجة الأولى لحماية صغار المستثمرين في السوق المحلي.
– امتناع قيام الدولة من منافسة القطاع الخاص عبر إنشاء شركات عامة مملوكة بالكامل، حفاظًا على التوازن بين الدور التنظيمي للدولة والدور الإنتاجي للقطاع الخاص.