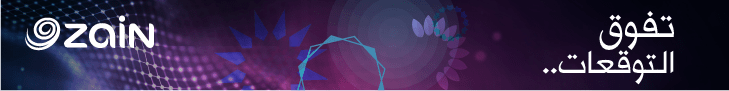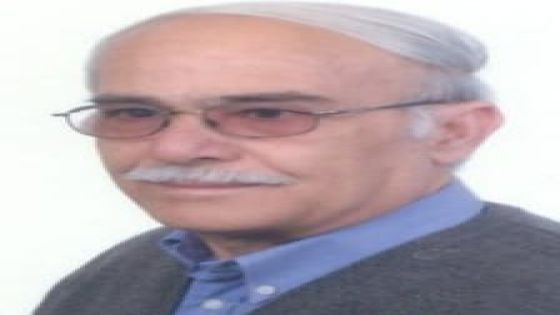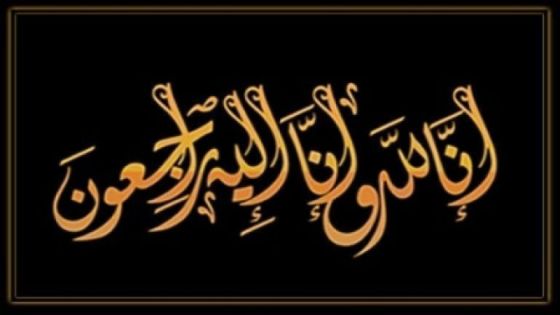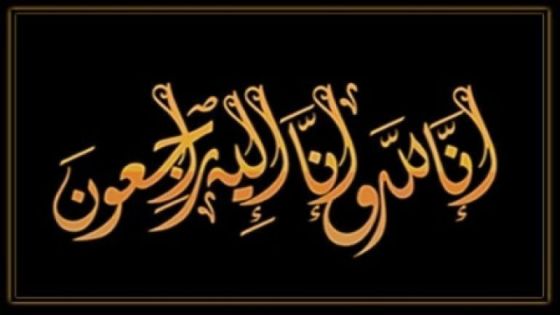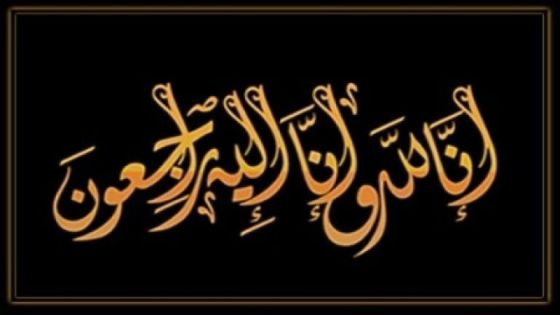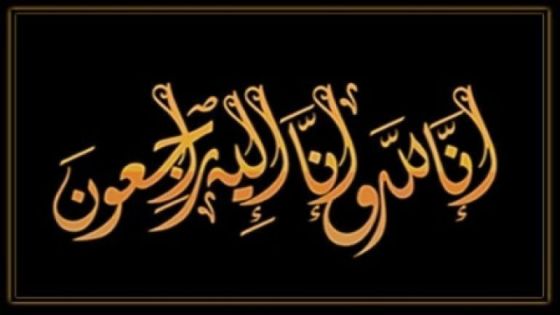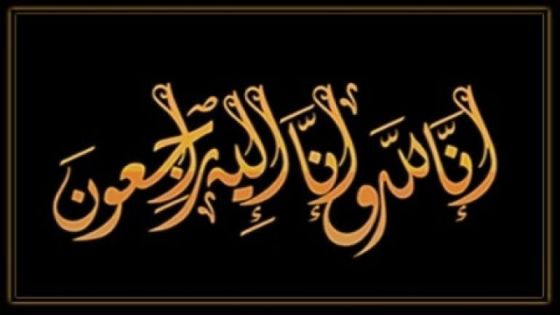كتب د. محمد عبدالله القواسمة
من أكثر المفردات المستخدمة في الشعر العربي مفردة الرحيل، وما يتعلق بها من مترادفات، وألفاظ ذات المعاني القريبة، مثل: السفر والتنقل والذهاب، والترحال والرواح والنفي، والمغادرة والهجرة والتهجير، والترحيل والرحلة، وما يقابلها من المفردات التي ينتهي إليها الرحيل، مثل: الحل والإقامة، والتوطين والتخييم وغيرها.
فمن الواضح أن الإنسان يقضي حياته في رحيل دائم، يرتحل من مكان إلى آخر غصبًا وإجبارًا، أو طوعًا واختيارًا. فهو يبدأ الرحيل الإجباري وهو في بطن أمه، فبعد أن يمضى في بطنها تسعة أشهر منعمًا مكرمًا، يُطرد من ذلك الفردوس إلى عالم الناس.
وفي عالم الناس يكابد الإنسان الحياة، ويواجه أثقالها ومصائبها حتى ينتهي به المطاف إلى رحيل آخر، وهو الرحيل الأبدي أي الموت. فالبداية تشبه النهاية وإن كانت النهاية أشد قسوة وآلامًا. وبين الرحيلين قد يستمر تعرض الإنسان إلى أصناف من الرحيل الإجباري.
وقد عبّر الشعراء العرب عن هذا النوع من الرحيل في كثير من قصائدهم: ففي معلقة زهير بن أبي سلمى، يرتحل القوم من عبس وذبيان من ديارهما في حومانة الدراج والمتثلم؛ بسبب الحرب التي نشبت بينهم، بعد سباق بين الحصان داحس والفرس الغبراء. يتناول الشاعر زهير هذا الصراع الذي دار أربعين سنة بين أبناء عشيرة غطفان، التي تنتمي إليها القبيلتان. يقول إنه رأى أطلال حبيبته أم أوفى في الرقمتين، بعد عشرين سنة من الحرب كأنها والظباء تسرح بينها بقايا الوشم في المعصم:
أَمِنْ أُمِّ أَوْفَى دِمْنَـةٌ لَمْ تَكَلَّـمِ بِحَـوْمَانَةِ الـدُّرَّاجِ فَالمُتَثَلَّـمِ
ودَارٌ لَهَـا بِالرَّقْمَتَيْـنِ كَأَنَّهَـا مَرَاجِيْعُ وَشْمٍ فِي نَوَاشِرِ مِعْصَـمِ
بِهَا العِيْنُ وَالأَرْآمُ يَمْشِينَ خِلْفَـةً وَأَطْلاؤُهَا يَنْهَضْنَ مِنْ كُلِّ مَجْثَمِ
وَقَفْتُ بِهَا مِنْ بَعْدِ عِشْرِينَ حِجَّةً فَـلأيَاً عَرَفْتُ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهُّـمِ
وإن كان الشعراء القدماء قد أبدعوا في تناول الرحيل الإجباري ضمن ظاهرة الأطلال وفراق الأحبة، فإنهم أبدعوا في وصف الرحيل الاختياري أيضًا. فهذا الشاعر الجاهلي المثقب العبدي يؤنسن ناقته في وجعها من الرحيل حين يقول:
إذا ما قمتُ أرحلها بليلٍ تأوَّهُ آهة َ الرَّجلِ الحزينِ
تقولُ إذا دَرأْتُ لها وَضِيني أهذا دينهُ أبدًا ودينى؟
أكلَّ الدَّهرِ حلٌّ وارتحالٌ أما يبقى عليَّ وما بقينى !
إنه يحس بوجع ناقته وحزنها إذا رحل بها ليلًا، فهي تتأوه كما الرجل الحزين. وتحاوره وتشكو إليه همها حين يزيل حزام الرحل عنها، وتسأله: هل العمر كله إقامة وارتحال؟ أهذا حاله دائمًا وحالها؟ لماذا لا يحافظ عليها ويبعدها عن متاعب التنقل والسفر؟
وهذا الشاعر العباسي ابن زريق البغدادي يختار الرحيل، وفراق زوجته أو حبيبته في بغداد، ويشد الرحال إلى بلاد الأندلس ليعود إليها بالمال، الذي يظن أنه سيناله من مدح الأمير أبي الخير عبد الرحمان، لكنه لا يظفر منه إلا القليل، فيمرض ويموت في الغربة، تاركًا تلك القصيدة الخالدة التي مطلعها:
لا تعذليه فإن العذل يولعه قَد قَلتِ حَقًا وَلَكِن لَيسَ يَسمَعُهُ
يقول منها:
يَكفِيهِ مِن لَوعَةِ التَشتِيتِ أَنَّ لَهُ مِنَ النَوى كُلَّ يَومٍ ما يُروعُهُ
ما آبَ مِن سَفَرٍ إِلّا وَأَزعَجَهُ رَأيُ إِلى سَفَرٍ بِالعَزمِ يَزمَعُهُ
كَأَنَّما هُوَ فِي حِلِّ وَمُرتحلٍ مُوَكَّلٍ بِفَضاءِ اللَهِ يَذرَعُهُ
إِنَّ الزَمانَ أَراهُ في الرَحِيلِ غِنًى وَلَو إِلى السِّندِ أَضحى وَهُوَ يُزمَعُهُ
فتظهر هذه الأبيات أن الشاعر ينتابه الحزن على فراق الحبيبة، التي كانت تلومه على رحيله عنها. لقد اعتاد الترحال، فما ينتهي من سفر حتى يتهيأ إلى سفر آخر، كأنّما قدره أن يظل على تلك الحالة من الحل والترحال. إنه تعلم من الزمان بان الغنى في الرحيل، وأن الرزق ينتظره حتى لو كان رحيله إلى السند.
يلاحظ في خضم الحديث عن الرحيل الاختياري أن بعض الشعراء لا يقر بأنه من اختار الرحيل، فهذا المتنبي يرى أن سيف الدولة هو من ترحل عنه عندما لم ينصفه في الخلاف الذي دار بينه وبين قريبه ابن خالويه. يقول:
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم
ونجد الشاعر المهجري رشيد الخوري (القروي) يرى رحيله عن بلاده لم يكن بيده، بل تحت وطأة الفقر والعوز. يقول:
أروم إلى ربى لبنان عودًا فيمسكني عن العود افتقار
ولو خيرت لم أهجر بلادي ولكن ليس في العيش اختيار
وبعد،
فإن الحديث ليطول عن الرحيل في الشعر العربي، ولكن نكتفي بما قلنا للتأكيد أن الشعر خير معبر عن حل الانسان وترحاله في الحياة ومكابدته من جراء ذلك بما تفرضه عليه الظروف البيئية والاجتماعية والسياسية. وسيظل موضوع الرحيل من الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة، ليس في الشعر وحده، بل في أجناس الأدب كلها أيضًا. ولعل هذا المقال يكون حافزًا على ذلك