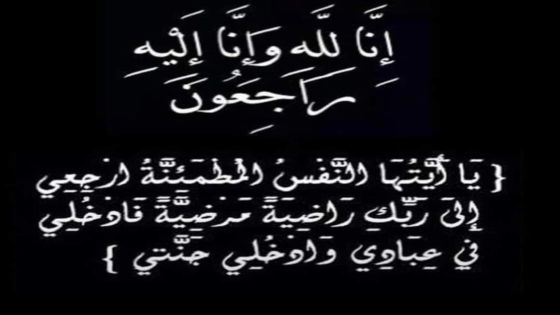كتبت – سارة طالب السهيل
سطعت شمس الدراما الأردنية سابقًا، وغزت البيوت العربية بنكهات فنية متميزة عكستها عبقرية في اختيار الموضوعات البدوية والتاريخية وتراثها القيمي والأخلاقي والفكري، وحبكتها وأداء ممثليها المتميز بجدارة وقدرة لفتت نظر متابعي الدراما العربية، بجانب عبقرية الدراما الاجتماعية الكوميدية الممتعة وأعمال الكرتون للأطفال، والتي لا تزال حية في ذاكرة الجمهور العربي والأردني على حد سواء، لأصالتها ولتعبيرها عنا كشعوب شرق أوسطية بكافة مكوناتها، فتهافتت المحطات العربية على هذه الأعمال
النجاح المدوي للدراما الأردنية للأسف الشديد بدأ من العلو، ولكنه تراجع حين حاول الانتقال من هذه الأعمال الفنية القديرة الهادفة والرائعة التي انطلقت من قلب المجتمع الأردني وعبرت عن أطيافه من بدو وحضر وفلاحين، حيث البدواة والجذور والقيم التراثية الأصيلة التي بعضها ترفيهي فكاهي بسيط ومسلٍ وبعضها علمي تنويري تعليمي هادف، وبعضها اجتماعي يحمل قضايا تنموية فكرية وسلوكية تساعد المجتمع على النهوض والتطور وترك بعض العادات والموروثات غير المفيدة وبنفس الوقت التشبث بالأرض والعرض والوطن والقيم الإنسانية والاجتماعية والث?افية والأخلاقية التي تعمر بها الأرض.
وانتقلت الدراما إلى عالم آخر ربما القائمون عليها تصوروا انهم انتقلوا إلى مجتمع ما بعد الحداثة، فأتوا بأعمال فنية لا تشبهنا ولا تعبر عن واقعنا ولا عن أفكارنا وطبيعة مجتمعاتنا، ولا عن رؤيتنا لأنفسنا والعالم.
فنحن مع التطور ومع الحداثة ومواكبة العصر والتعبير عن واقعنا الحالي ليس فقط التاريخ والبداوة والجذور بل أيضا تقديم كل ماهو معاصر ولكن،
هو شيء عجيب فعلا أن تأتي محاولات الناس في بلادنا العربية نحو التطور والتحديث المستمر والتطلع نحو الحضارة والمستقبل في إطار نظرة أحادية الجانب تنظر بعين واحدة للتحرر من القيود ومن الضوابط التي نشأنا عليها، في حين أن التحرر هو في الأساس فكر ورأي وعمل وبناء لا ينطلق دون وجود ثوابت.
ما نراه في الدراما الجديدة غير موجود على ارض الواقع وان وجد فهو قليل جدا، ومن ثم لا يمكن اعتباره ظاهره تدفعنا لتكريسها ودفع ثمن تبعاتها، فلماذا نركز عليه ونجعله ظاهرة؟
المنظور الثقافي في تحليل العمل الفني ينطلق من اتجاهين أولهما يرى ضرورة قيام الدراما بتسليط الضوء على المشكله الاجتماعية أو الفكرية من قبح أخلاقي أو تسلط ديني جاهل أو موروث ثقافي قاد إلى الجهل أو الانفلات السلوكي والقيمي تحت ذرائع الجشع الإنساني أو التمتع واللهو على حساب القيم الدينية والأخلاقية وغيرها، للتوعية بمخاطرها والعمل على إيجاد حلول عملية لها.
والاتجاه الثاني يرى أن نقوم بتسليط الضوء على السلوك الاجتماعي السوي والحث عليه، وتعويد العين والسمع والبصر والقلب على رؤيته ومعايشته وتذوق أخلاقياته، وبهذا نروج للقيم السلوكية الاجتماعية السوية، وننشره ونرسخه في العقول والوجدان.
وأنا مع المدرسة الثانية، لأن الأولى ستعلم الناس فنون الانتقام مثلا أو القتل أوالسرقة والانفلات السلوكي والأخلاقي والتعاليم غير الإنسانية أو تفكك الأسرة التي هي عماد المجتمع وأساس قوامه الصحي أو التعري المبتذل الفاضح وغيرها، وتعودهم على هذه المناظر والأحداث المؤلمة والمشاهد القبيحة وأن تحل المشكله بتعميمها والترويج لها، خاصة أنه عندما يتم عرضها لا يتم تجريمها، فالأحداث تعرض كأمر عادي أو مقبول.
أتصور أن الأعمال الدرامية التي سعت للخروج من التزمت الفكري والديني قد ضلت طريقها في توصيل رسالتها الفنية، فالعمل الفني أدب وذوق وارتقاء بالإنسان يسمو بمشاعره ويعمل على تهذيبها وإسعادها بالجمال وليس بالقبح، فليس مقبولا أن نسعى لتغيير المجتمع من الأفكار المتشددة التي تخنق المرأة والمجتمع بالانفتاح الذي يقود إلى الانفلات بعيدا عن الوسطية التي هي المنقذ للمجتمع والأسرة، فالوسطية هي العمود الذي نستند عليه، فنضرب به التطرف البغيض أو الانفلات الشبيه بغابة الحيوانات المفترسة، بل العكس تماما يمكنك أن تثبت للمتزمت و?لمتطرف فكريا، أن الأخلاق والأدب ليسا حكرا على طبقة أو طائفة معينة، بل هي مغروسة في فطرتنا الإنسانية التي فطرنا الله عليها، وأي عمل فني يخالف هذه الفطرة لابد وأن يجني ثمار الرفض والانتقاد والعداء أيضا
شمس الدراما الأردنية.. بين الماضي والحاضر