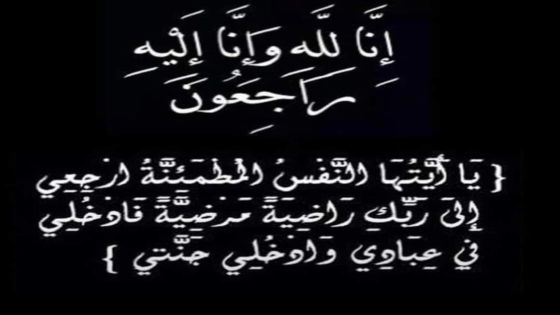ترجمة: علاء الدين أبو زينة
مقال للكاتب جون جينكينز (ذانيوستيتسمان)
في منتصف نيسان (أبريل) 2011، تلقيت، على غير توقع، مكالمة هاتفية من وزارة الخارجية في السفارة البريطانية في بغداد: هل يمكنني أن أنتقل في أسرع وقت ممكن من العراق، حيث كنت أعمل سفيرا، إلى ليبيا؟ كان العراق يتجه إلى صراع طائفي متجدد، مدفوعا بتصرفات رئيس الوزراء آنذاك، نوري المالكي. وقد اتهم المالكي -وهو إسلامي شيعي- بالتآمر لسرقة انتخابات العام 2010 من منافسه إياد علاوي. وكان علاوي أيضا شيعيا، وإنما علمانيا وقوميا يتمتع بدعم واسع عبر الانقسامات الدينية والعرقية. وقد مثل بديلا جمهوريا للعراق على أساس المواطنة والمساواة، وليس الطائفية الظلامية المخيفة التي تروج لها الأحزاب الدينية، الشيعية والسنية على حد سواء.
كان علاوي قد فاز بمقاعد أكثر في جميع أنحاء البلاد. لكن المالكي كان مدعوما من إيران والولايات المتحدة معا. وأرهب الكثير من الطبقة السياسية العراقية وقمع المتظاهرين -إما باعتقال المنتقدين أو طردهم إلى خارج البلاد. وقيل أنه كان لديه سجن خاص وجيش خاص. وكان يعقد صفقات سياسية مع السفاحين القتلة، مثل الصدري السابق الذي تحول إلى زعيم فرقة موت مستقلة، قيس الخزعلي. لكن الحكومة البريطانية لم تكن مهتمة: كانت الكوارث العسكرية في الجنوب، حيث فشلنا في تزويد الناس العاديين بالأمن الذي وعدناهم به في العام 2003، قد ألقت بظل سياسي طويل جدا، وأراد الوزراء البريطانيون نسيان أمر العراق فحسب. وكان الفرنسيون يطاردون حلم اكتشاف الكنوز القديمة في العقود التجارية من خلال حلفاء المالكي. وفي واشنطن، اعتقد صناع السياسة أن المالكي هو “رجلهم”. واعتقدت أن هذه كانت حماقة تدفع إلى الوراء فحسب. لم يكن هذا يعمل. وهكذا، قلت “نعم” لليبيا. وبعد ثلاثة أسابيع لاحقا، طرت إلى بنغازي.
كانت ليبيا دولة غنية بالطاقة والأصول، بعدد سكان يبلغ نحو ستة ملايين نسمة، ولديها إمكانيات اقتصادية كبيرة، ومناخ معتدل نسبيا، وساحل متوسطي مثير للإعجاب، وبعض من أفضل المواقع القديمة في العالم. وكان المتمردون الذين يقاتلون القذافي منظمين في ميليشيات محلية صغيرة. ولم تكن ليبيا من نفس نوع مستنقع العراق الطائفي. واعتقدت أن الانتفاضة، التي كانت قد بدأت قبل شهرين في شباط (فبراير)، قد تنجح في بناء نظام سياسي دائم يتوافق مع التطلعات الشعبية الواضحة في جميع أنحاء المنطقة إلى تحقيق الكرامة، والحكم الرشيد، وحصة في الرخاء، وصوت سياسي.
وكنت مخطئا -ولكن ليس لأنني أخطأت في فهم الأسباب. كان غياب الشرعية والحكم الرشيد حاضرا في قلب فشل الدولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمدة قرن من الزمان. وإذا فحصنا الأدلة التي تعرضها الانتخابات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والاستطلاعات الاجتماعية واستطلاعات الرأي الأخرى في جميع أنحاء المنطقة منذ العام 2011، سيكون واضحا أن العديد من الذين يعيشون هناك، إن لم يكن معظمهم، يرغبون في حياة أفضل، ودولة أكثر حداثة ونظاما أكثر عدالة. لماذا لا يستطيعون تحقيق ذلك؟
الثورات مثيرة للحماسة والعواطف. لكنها تدمر. يأمل البعض في أن المسار اللاحق عند الإطاحة بنظام سيئ يجب أن يكون تقدميا. لكن التجربة تقترح العكس. إن السلطوية لا تضعف في مثل هذه الظروف: إنها تتكرر وتعيد نفسها. هناك، بالطبع، كل أنواع الثورات: من أعلى؛ من أسفل؛ عسكرية؛ ثورة فقراء؛ ومجيدة، وشريرة. وقد انقسمت الثورات في العالم العربي، تاريخيا، على أساس خطوط القسمة القومية والعرقية والدينية. لكن هناك شيئا واحدا مؤكدا بشأنها: إنها لا ينتهي أبدا بالطريقة التي يأملها المرء.
***
تصارَع كارل ماركس مع هذه المشكلة بعد فشل الثورات الأوروبية في العام 1848، خائب الأمل من إذعان البرجوازية الفرنسية لتدمير الجمهورية الثانية عن طريق انقلاب لويس نابليون في العام 1851. وبعد مائة عام، في منتصف الستينيات، لاحظت مفكرة ألمانية عظيمة أخرى، حنة أرندت Hannah Arendt: “لا ثورة، مهما فتحت أبوابها للجماهير والمضطهدين… كانوا هم الذين بدأوها أبدا”.
يشير هذا إلى حقيقة أخرى عبرت عنها أرندت: “الحريات، بمعنى الحقوق المدنية، هي نتائج التحرير، لكنها ليست بأي حال المضمون الحقيقي للحرية التي يتمثل جوهرها في قبول الجماهير وإدخالهم في المجال العام والمشاركة في الشؤون العامة”.
ولا ينفي هذا أن الخير يمكن أن يأتي من الثورة. ولكن، يبدو أن هذا يحدث فقط إذا كانت هناك مسبقاً ثقافة مدنية وسياسية قوية، كما حدث في حالة إنجلترا بعد العام 1688، أو الولايات المتحدة بعد العام 1783؛ وإذا كان هناك مسار مؤسسي للتغيير المستدام، كما حدث في الفلبين بعد العام 1986؛ أو، في حالة الانقلاب، وجود سبب محدد يجعل الجيش يفضل الديمقراطية على بدائلها، كما حدث في البرتغال في العام 1974. ومع ذلك، يظل ذلك يستغرق وقتا.
في مصر في العام 2011، ربما كان الذين قادوا الانتفاضة أول الأمر هم المصريون العاديون الذين كانت قد ضللتهم الأنظمة المتعاقبة التي قالت لهم أن النمو الاقتصادي سوف يتقطّر بالتدريج بينما لم يفعل في الحقيقة. لكنهم لم يكونوا هم الذين أنهوها بأكثر مما أنهى الثورة الإيرانية الطلاب والعمال والبازاريون واليساريون والليبراليون ورجال الدين الذين قادوا مراحلها الأولى في العام 1979. ومنذ العام 2011، لم يتم في أي من مصر أو إيران -ولا في ليبيا والسودان والجزائر وسورية ولبنان والعراق- القبول بدخول الجماهير إلى المجال العام، وهو الشرط الأساسي لدولة القانون والعدالة.
لا ينبغي أن نحتاج إلى ماركس، أو أرندت، أو الفلاسفة الليبراليين من أمثال جون راولز John Rawls أو يورغن هابرماس Jürgen Habermas لشرح هذا. بعد كل شيء، أنتجت الثورة الإنجليزية في الأربعينيات من القرن الماضي الاستبداد العسكري والثورة الملكية المضادة في العام 1660. وولدت الثورة الفرنسية الحرب الأهلية، والإرهاب، ونابليون، وسلسلة من المعارك وسفك الدماء في جميع أنحاء أوروبا. كما أعقبتها أيضا ثورة مضادة وما يقرب من قرن من عدم الاستقرار السياسي المحلي والصراع. وأنتجت الثورة الروسية في العام 1917 ستالين، ومجاعة كارثية، وملايين الوفيات غير الضرورية في الكولاغ. وأنتجت الثورة الصينية الطويلة، التي بدأت في العام 1911، ماو، و”القفزة العظيمة للأمام”، وملايين القتلى و”الثورة الثقافية”. وأدت الانتفاضات الألمانية في 1918-1919 إلى جمهورية فايمار -وإنما أيضًا إلى “الرايخ الثالث”.
في الشرق الأوسط الحديث، تسببت موجة الانقلابات والثورات التي بدأت مع الجنرال بكر صدقي في العراق في العام 1936، وتكثفت بعد الحرب العالمية الثانية، وانتهت بشكل غير متماثل مع قطر الصغيرة والسودان الشاسع في التسعينيات، في خلق الاضطرابات من دون إحراز تقدم. وأنتجت هذه التمردات آل الأسد، وصدام حسين، والقذافي والبشير، وعصابة غامضة من الجنرالات في الجزائر، والكثير من المذابح، والإفقار، والاضطرابات المستمرة والقمع الشرس. وأنتجت الثورة الإيرانية في العام 1979 آية الله الخميني وثيوقراطية قاتلة رعت التخريب الذي تشيعه الميليشيات في جميع أنحاء المنطقة لمدة 40 عامًا.
لم يؤد أي من هذه الانقلابات والثورات إلى توسيع المشاركة العامة أو تعزيز الحقوق المدنية. فلماذا تنتهي انتفاضات 2011 بشكل مختلف؟ حذر العديد من حكام المنطقة أوباما، وكاميرون وساركوزي وآخرين، من أنها لن تفعل. كنا نميل إلى تجاهلهم باعتبارهم مستبدين معنيين بالمصلحة الذاتية. وهناك بعض الحقيقة في هذا الوصف. لكن المؤرخ القديم ثيوسيديدس Thucydides، والفيلسوف توماس هوبز Thomas Hobbes من القرن السابع عشر، وعالم الاجتماع الألماني ماكس ويبر Max Weber، الذين عاشوا جميعًا في فترة شهدت نوبات الإطاحة المتشنجة بالأنظمة القديمة، كانوا يعرفون مدى السوء الذي قد تذهب إليه الثورات. فلماذا نسينا نحن ذلك؟
***
إحدى الإجابات هي شعور بالاستثنائية وجهل مطبق. كان الحلم المحموم نفسه هو الذي قاد الغرب إلى العراق في العام 2003: سراب تأسيس سياسة جديدة، شاملة وديمقراطية، شبيهة بطائر فينيق ينهض من رماد الاستبداد.
لكن السياسة في الشرق الأوسط مصممة لكي تُقصي. وقد تعرضت المؤسسات المستقلة والمجتمع المدني للقمع طوال 70 عامًا. وليس المقصود من الانتخابات هناك أن تعكس إرادة الشعب؛ إنها فرص للنخب المفترسة لكي تستولي على السلطة وتمارس النهب. وعندما تكون لديك ثورة، فإن الشيء الوحيد الذي يتغير حقًا -كما ذكر المؤرخ العربي العظيم ابن خلدون منذ ما يقرب من 700 عام -هو هوية النخبة.
إذا نظرتَ إلى الانتخابات في العراق منذ العام 2003، أو في مصر، أو تونس، أو ليبيا، أو لبنان منذ العام 2011، فإنك سترى تجسيداً لملاحظة أنطونيو غرامشي Antonio Gramsci الحاضرة دائماً بأن الجديد لا يمكن أن يولد، والقديم يُحتضر، والنتيجة هي الاعتلال السياسي. وسوف ترى أيضاً القبضة المستمرة لتصنيفات القبيلة، والعشيرة، والتقسيمات العرقية، والدينية والطائفية وغيرها من انتماءات المجموعات، على المنطقة. ولم تسفر الانتخابات الأخيرة عن طبقة نفاذة وقابلة للتغيير من السياسيين الذين يمثلون مصالح الشعب أو الأمة. إنها تضع في المناصب، بدلاً من ذلك، مجموعة من النخب التي لا تستمد قوتها من صندوق الاقتراع، وإنما من تراكم رأس المال الاجتماعي والمحسوبية والإنشاء المقصود للحدود العرقية أو الطائفية أو المجتمعية.
وقد رأينا ذلك أوضح ما يكون في لبنان، الذي لديه منذ العام 1943 الخبرة الأطول في العالم العربي كله في “التوافقية”، وهو نظام يسعى إلى تعزيز تمثيل أو رفاهية -ليس الأفراد وإنما الجماعات التي تعرف نفسها بنفسها وقادتها الذين يصفون أنفسهم بأنفسهم. وليس هذا النظام مقتصراً على لبنان؛ لقد تم استيراده بطريقة كارثية إلى العراق في العام 2003. وفي كلا المكانين، شجعت مجموعات من السياسيين الطائفيين المحترفين الذين يتخذون قراراتهم -ليس على أساس إرادة الناخبين كما يتم الكشف عنها من خلال الانتخابات، وإنما في مفاوضات سرية مع مجموعات النخبة الأخرى. والهدف الأساسي لهذه المجموعات هو الحفاظ على سلطتها ووصولها إلى موارد الدولة -والتي تولِّد بدورها الرعاية والمحسوبية وبقية الممارسات التي يعتمد عليها مثل هذا النظام.
وكانت هناك نسخة أكثر فجاجة من هذا النظام في كل من ليبيا وسورية قبل العام 2011، مع وجود عائلتي الأسد والقذافي في السلطة مدى الحياة فعلياً، وحريتهما في استخدام الدولة كإقطاعية خاصة. في ليبيا، أظهرت الانتخابات من العام 2012 فصاعدا أن معظم الناس يريدون الأمن والاستقرار، والنمو الاقتصادي والتعليم ومعاودة الانخراط مع العالم. وعندما شارك أكثر من 60 في المائة من الليبيين المسجلين في الانتخابات في العام 2012، فإنهم لم يتوقعوا حكما تديره الميليشيات. لكن هذا كان ما حصلوا عليه. وقد صوّتت قائمة انتخابية أصغر، بنسبة 45 في المائة من الناخبين المسجلين فقط في الانتخابات الثانية التي أجريت في العام 2014 -مرة أخرى ليس للميليشيات، لكن النتائج أُلغيت. والآن لدينا المحاولة الرابعة في سلسلة من المحاولات اليائسة التي تبذلها الأمم المتحدة لإصلاح حكومات “الوحدة” و”المؤقتة” المتضاربة والمقسمة، والمصممة كلها للتوفيق بين مزيج من الرعاة المحليين والخارجيين غير القابلين للتوفيق بينهم.
في مصر، تواصلت الانتخابات المزورة، المصممة لترسيخ سلطة الجيش وقوات الأمن وأعوانهما السياسيين والاقتصاديين، على مدى 70 عامًا. وفي ميدان التحرير في العام 2011، كان الليبراليون، والعمال العاديون والطلاب ومشجعو كرة القدم هم الذين ظنوا أنهم يحرِّرون مصر من الاستبداد. وكانت جماعة “الإخوان المسلمين” -التي سمحت لها الحكومات المتعاقبة بالتجنيد والتنظيم مقابل الإبقاء على الليبراليين والعلمانيين واليساريين ضعفاء وغير قادرين على تهديد المصالح الأساسية للدولة العميقة- غائبة إلى حد كبير عن الاحتجاجات الأصلية الأولى. ولكن، بحلول الوقت الذي أُجريت فيه الانتخابات الحرة في 2011-2012، كانت الجماعة قد دخلت في تحالف ضمني مع الجيش بهدف إخراج غير الإسلاميين من أي أرض وسطى ربما يكونون قد احتلوها. وفاز مرشحو “التحالف الديمقراطي من أجل مصر” المرتبط بجماعة الإخوان بحوالي 20 في المائة فقط من إجمالي الأصوات المتاحة في الانتخابات البرلمانية (و37 في المائة من الأصوات المدلى بها بالفعل)، لكن الحركة فهمت هذا الفوز، والفوز الضيق اللاحق لمحمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، على أنهما ولاية تفوضها بتعديل الدستور وتشكيل الدولة على صورتها هي. وعندما أظهرت استطلاعات الرأي أن المصريين العاديين انقلبوا على الجماعة، ومع وجود الجيش في وضع مضطرب بوضوح، ظلت الحركة على قناعة بأن العناية الإلهية ستنقذها. لكنها لم تفعل.
في جميع الانتخابات التي جرت منذ العام 2011، نشهد انحسار الثقة الشعبية بصناديق الاقتراع. في العراق، كانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية للعام 2018 هي الأدنى منذ الإطاحة بصدام حسين. ومن بين الـ45 في المائة الذين شاركوا في الاقتراع، صوتت الأغلبية لرجل دين -مقتدى الصدر- الذي تعهد بإنهاء الفساد وتشكيل حكومة تعالج إخفاقات أسلافها. لكن الصدر يبدو على نحو متزايد مثل موسوليني، الكارزمي، وإنما الصاخب، الذي زحف إلى روما العام 1922، متظاهراً بأنه مُخلِّص إيطاليا -ودمرها. وستسعى إيران كعادتها إلى الحفاظ على هيمنة حلفائها داخل النظام.
في الانتخابات اللبنانية للعام 2018، كانت نسبة المشاركة منخفضة بالمثل، وكانت الحكومة التي أنتجتها في الأساس نفس سابقتها، التي كانت بدورها مثل سابقتها، وهكذا دواليك. وكان التغيير الوحيد هو أن حزب الله -الميليشيا المدعومة من إيران- ظل يراكم المزيد من السلطة. ولا يُحاسب أحد في البلد على الإطلاق، حتى مع نفاد الأموال من البنوك، وتحطيم جزء كبير من غرب بيروت بسبب الفشل في إدارة 2.750 طنا من نترات الأمونيوم. وحتى في تونس -الضوء الساطع للربيع العربي- بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية للعام 2019 مجرد 41 في المائة. كما ذهب عدد غير متناسب من الشباب التونسي للانضمام إلى تنظيم “داعش”. وما تزال القسمة الاقتصادية بين الساحل الفرنكوفوني والمنطقة الداخلية الناطقة بالعربية هائلاً، بينما تتصارع النخبة السياسية لما- بعد- الثورة على الامتيازات.
لا عجب أن الناس محبطون. كانوا يعتقدون أن الربيع العربي سينتج الحرية. لكنه جلب، بدلاً من ذلك، انعدام الأمن، والصراع، ونخباً جديدة فاسدة لا تختلف عن النخب القديمة، حتى لو زعمت، كما كان الحال مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أنها الصوت الأصيل والموثوق لثورة موحدة.
***
كان استيلاء ثورة طليعية على السلطة هو النموذج الذي طبقه لينين في العام 1917، وتبناه ناصر في العام 1952، والقذافي في العام 1969، وحافظ الأسد في العام 1970، والخميني وخلفاؤه بعد العام 1979. وكانت النتيجة في كل حالة هي بريتورية على مستوى الدولة، كان السكان بموجبها أسرى وتم استخدام ديمقراطية إجرائية -مدعومة بالقوة- لصرف الانتباه عن المظالم والترويج لصورة للشرعية. وقد نجح ذلك أيضا.
وعلى النقيض من ذلك، فإن الديمقراطية الانتخابية عملية وليست نتيجة. إنها نتاج -وليست سبب- أيديولوجية سياسية. والليبرالية السياسية في أوروبا هي استثناء ليتم تفسيره أكثر من كونها قاعدة ليتم تصديرها. والممارسات الانتخابية التي ندافع عنها مشروطة. وهي مشروطة بتجربة تاريخية مخصوصة وتدعمها أيديولوجية استطرادية للحقوق والحريات الفردية. ويمكن إرجاع أصولها إلى القانون الروماني والجرماني المتأثر باللاهوت السياسي المستمد من الجمهورياتية المعادية للإمبريالية أو المناهضة للبابا في المدن-الدول الإيطالية المبكرة.
وفي أوروبا كانت الحداثة مشروعا ثقافيا قبل أن يكون مشروعا سياسيا، مبنيا على “الارتباطية”، والتوسع الاقتصادي، ونمو الفضاء المدني وانتشار الفلسفة والعلوم والفن، التي أصبحت كلها “التنوير”.(1) وتتطلب الديمقراطية الانتخابية الناجحة تطوير عادات مستدامة للعقل والممارسات الاجتماعية، وإحساس مشترك بالماضي والمستقبل. وهي بحاجة إلى القبول بإمكانية انتقالية السلطة، وذاكرة حية لسلوك دولة غير قمعية ومجتمع مدني غير مدجّن. وهي بحاجة إلى فهم مشترك للعدالة وسيادة القانون. وهي بحاجة إلى مؤسسات قوية ومستقلة ومحايدة لتضطلع بمهمة التحكيم.
إذا كنا نعتقد أن الحكومة المختصة والعادلة والشرعية هي شيء مرغوب فيه (وأنا أعتقد ذلك)، فكيف نعتقد أنها يمكن أن تنشأ وتستمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ثمة القليل من هذه الشروط المسبقة؟ وهذا سؤال غير مريح. إنك إذا نظرت إلى الدول في المنطقة التي يُعجب بها عدد كبير من الشباب العرب ويرغبون في الاقتداء بها، فإنها ذات أنظمة ملَكية أو شيخية، ما يزال الكثيرون يصنفونها على أنها استبدادية.
يكمن وراء كل هذا الإندفاع إلى الأمن، الذي ربما رأيناه أولاً في مصر بعد العام 2011 -حيث ظل الجيش، بأغلبية ساحقة، هو المؤسسة التي تحظى بأكبر قدر من الثقة- والذي تسارع بعد ذلك في أماكن أخرى، إذا صدقنا استطلاعات الرأي، ردًا على الفوضى التي أطلقها الربيع العربي. والأمن شرط مسبق لأي نوع من التقدم. وكانت الدول الخليجية الغنية على وجه الخصوص، حيث فشل الربيع العربي في الانطلاق (باستثناء فترة قصيرة في البحرين وواحدة أطول في عُمان) ناجحة على وجه التحديد لأنها توفر الأمن والفرص الاقتصادية مقابل الهدوء السياسي.
لكن هذا لا يجعل تلك الصفقة –بين الأمن واللامبالاة السياسية- النهاية الحتمية للتطور السياسي العربي. لا يمكن لكل شخص أن يقيم ويجد عملاً في دبي أو نيوم، أو أن يرغب الجميع في ذلك. وعندما يكشف المتظاهرون في إيران عن ازدراء لشعارات الجمهورية الإسلامية المستهلكة؛ وعندما يهتف نظراؤهم في شوارع البصرة والناصرية وبغداد “نريد دولة فقط”. عندما يهتف آخرون في بيروت أو طرابلس أو صيدا، “كلن يعني كلن”؛ عندما يعلنون دعمهم لبعضهم البعض عبر الانقسامات العرقية أو المذهبية؛ عندما يخاطرون بحياتهم لإظهار غضبهم على النخب الفاسدة التي سرقت مستقبلهم، فإننا نشهد على الأرجح ظهور شيء جديد: حركة لا مركزية وشابة بشكل ساحق، تعلق أهمية على Gesellschaft (المجتمع والدولة) وليس Gemeinschaft (المجتمع والقبيلة)، ويريد المشاركون فيها شيئًا أفضل بكثير مما كان لآبائهم وأمهاتهم. وتشير جميع استطلاعات الرأي إلى أنهم أقل انجذاباً إلى الإغراءات الرخيصة التي يعرضها المتجولون الإسلاميون أو الديماغوجيون القوميون. لقد جعلتهم الفضائيات والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يرون العالم. وهم يريدون حصة منه.
لكنك تظل في حاجة إلى خطة، مع ذلك. إنك في حاجة إلى قادة. وأنت في حاجة إلى إقناع الآخرين. ولم يحدث هذا بعد. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه عندما يظهر أشخاص بليغون ومقنِعون في أماكن مثل لبنان أو العراق، فإن شخصاً غامضاً ما يأتي على دراجة نارية في الليل ويقتلهم بالرصاص. وفي سورية يختفون. وفي إيران يتعرضون للتهديد والاعتقال والتعذيب والسجن والإعدام. لكنك لا تستطيع أن تقتل أو تعتقل أو تخيف الجميع وإلى الأبد. وإذا لم يتغير شيء ما قريبًا، فلن يكون الربيع العربي للعام 2011 هو الأخير.
وعندما تنفجر الموجة التالية، لا يجب علينا نحن في الغرب أن نحاول بناء دولة. وينبغي أن نقلل من المكافآت التي تُمنح عن تدمير دولة. ليس الفساد علة في النظام: إنه النظام نفسه. وعندما تريد النخب الفاسدة أن تخبئ ما نهبته، فإنها تلجأ إلى لندن وزيورخ وباريس ونيويورك وفرانكفورت وكاراكاس وأنقرة ونيقوسيا. هذا هو المكان الذي تجري فيه خطوط وقود التدمير. اقطعوها.
*John Jenkins: سفير بريطاني سابق في ليبيا والمملكة العربية السعودية.
*نشر هذا المقال تحت عنوان:
The lights that failed: Why the cause of liberal democracy collapsed in the Middle East.
ِ