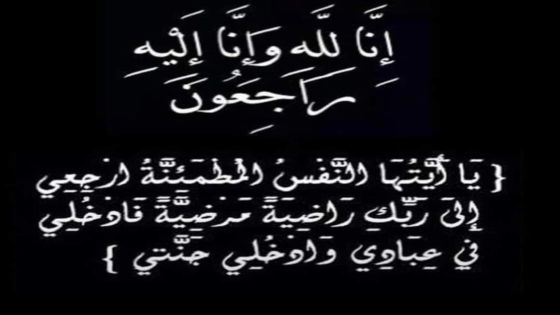بقلم الدكتور منذر الحوارات
تشاركت هذه الذكرى مع شهر آذار/ مارس منذ عشر سنوات حتى الآن، كانت تمر حيناً بشكل عابر وأحياناً بتجمعات محدودة في غير مكان، وقد يُذكّر الناس بها تجمهر القوات الأمنية على الدواوير والطرقات المهمة. وبعض من علقت تلك الذكرى في أذهانهم إما لأنهم شاركوا فيها ولا زال لديهم بعض من الأمل في عودة الروح اليها، أو عايشوها وتركت لديهم مخاوف بأن الأمور كانت على حافة الانفلات.
لكن منذ ذلك الحين جرت مياه كثيرة في أنهار المنطقة، رسخت في الذهنية العامة بأن التحولات في المنطقة بابها الوحيد هو الدم والخراب، لذلك أُخمد أي إحساس أو رغبة في التغيير وذَبُل أمام المخاوف من اللا إستقرار والفوضى التي اصبحت عالقة في أذهان الجميع. رافق ذلك تشتت القوى التي شاركت في هذه الحركة وانقسامها؛ إما على بعضها أو تمزق كل منها في داخلها، فأصبحت كل جهة عبارة عن شخصيات مفردة قد تكون فاعلة على صعيد التواصل الاجتماعي، لكنها على الأرض تفتقد القدرة على الحشد المؤثر.
فالحركات والتيارات، سواء الإسلامية أو اليسارية أو القومية، كل منها أصبحت لديه همومه وانقساماته. فلا التيار الاسلامي بقي على حاله بعد ما حصل في الإقليم، من تراجع لمده الذهبي، وما حصل في الداخل من انقسامات عديدة إضافة للتضييق الحكومي عليه، ففقد بذلك الكثير من إمكانياته اللوجستية في دعم وإسناد أي تحرك فعال.
أما اليسار فقد أصبح جزء منه في جعبة الحكومة والجزء الآخر يفتقد القدرة على بلورة خطاب يستعيد الثقة التي فقدها. والتيار القومي ليس بأحسن حالاً، فهو فقد الإمكانية على بلورة خطاب يتقنع به الناس، فهو يلام في كل مرة يخرج فيها للمطالبة بالإصلاح على دعمه لأنظمة لا تؤمن أبداً بأي حقوق للإنسان. أما التيار العشائري فهو منقسم على نفسه بسبب عوامل عديدة أضعفت هذه الشريحة.
إذا كانت الأمور مع ٢٤ آذار/ مارس هي كذلك، فلماذا إذاً كل هذا الاهتمام الرسمي بهذه الذكرى في هذا العام؟
للإجابة على هذا السؤال يجب طرح سؤال آخر: هل فعلاً كانت هناك مخاوف حقيقية من تحرك جماهيري كبير يدعو إلى إسقاط النظام؟ وهل كانت هذه المخاوف مبنية على معرفة بأن العوامل المتراكمة من فقر وبطالة وفساد، وغياب مساحة مقبولة من حرية التعبير.. الخ؛ أصبحت قادرة على تحفيز حالة غضب شعبية، تذهب باتجاه مطالب بالتغيير الجذري؟ وإن كنت أجزم بأن هذه الحالة لم تتكون بعد، وعلى فرض أنها موجودة، فحتى تتبلور وتصبح مؤثرة داخلياً تحتاج إلى دعم معارضة منظمة تتبنى أطروحات راديكالية تتعلق بالتغيير الجذري، أيضاً تحتاج إلى دعم من الجيش، وتفكك النخب حول الحكم ونزولها من قاربه، وفوق كل ذلك تحتاج إلى دعم خارجي حتى تستطيع ان تحصل على المشروعية.
بالطبع كل تلك العناصر غير موجودة، فرغم وجود منغصات كثيرة في المجتمع الأردني لكنه لا يزال يعيش بشكل ريعي، فهو يعتمد في كثير من شؤون حياته على ما تقدمه الحكومات، وهو أصبح مرتبطا بهذا الواقع وليست لديه بدائل حقيقية مغرية كي يسعى لتغييره.
أما العنصر الثاني (المعارضة)، فلا توجد معارضة موحدة تمتلك رؤية واضحة للمستقبل خارج الإطار الحالي، وهي أصلاً لا تتمتع بالقوة الكافية لتقود هكذا تحول. أما إذا قررت الحكومة اعتبار الناشطين إعلامياً في الخارج أنهم معارضة قادرة على تحريك الوضع الداخلي وقيادته نحو التغيير، فإن هذا التفكير لن يكون إلا واحدا من اثنين؛ إما أنها تجهل معنى المعارضة، وأنا أستبعد عن دولة ضاربة في العمق أن تقرأ الأمور بمثل هذه السذاجة، فهي تعلم أنهم مجموعة من الغاضبين أتاحت لهم وسائل التواصل الاجتماعي الوصول إلى فئات مختلفة من الناس، ما شجعهم على الاستمرار، طبعاً مع عدم صعوبة الحصول على المعلومات في بلد صغير مثل الأردن ما سهل ذلك عليهم النقاش في القضايا السياسية والمجتمعية. والمتتبع لحديثهم لا يجد بينهم رابط سياسي أو تنظيمي ولا حتى رؤية موحدة لطبيعة التغيير، وعلى كل الأحوال هم لا يمتلكون أي من الأدوات التي تمكنهم من قيادة حالة اجتماعية داعية للتغيير.. أو (ثانيا) أن أحداً ما أراد أيستثمر هذه الأصوات لغايةٍ ما!
أما بالنسبة للجيش فلا أعتقد أن عاقلاً يمكن أن يفكر بأن الجيش الأردني قد يكون شريكاً في أي محاولة للتغيير، فهو يتمتع بالحرفية اللازمة لإبعاده عن السياسة، وهو يمتلك بكل قيادته وأفراده رؤية موحدة مؤمنة بدور الأسرة الملكية على حفظ التوازن؛ ليس فقط في داخل الأردن بل في الإقليم وربما العالم. لذلك فعقيدته راسخة بأن العائلة المالكة هي ثابت استراتيجي يضمن بقاء البلد، وبالتالي فإن الولاء لها ولبقائها هو جزء صميمي من الولاء للدولة. فالمراهنة إذاً على محاولة تدخله هي مراهنة مراهقة تفتقر إلى المعرفة الحقيقية بطبيعة الأمور.
لم يبق من عناصر نجاح أي تغيير سوى الدعم الخارجي، والبعض يستذكر تدخل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في دعم ثورات الربيع العربي. وإن كان هذا صحيحا في ذلك الوقت، لكن تصور الوضع مع الإدارة الأمريكية الحالية مشابه لما كان في تلك الإدارة يفتقد إلى القراءة الصحيحة لواقع الحال، بالذات إذا ما عرفنا أن باراك أوباما كان قد تخلى في أواخر أيامه عن فكرة دعم التحولات الديمقراطية في المنطقة بسبب تكون قناعة لديه بصعوبة ذلك.ولا يُنسى أن الرئيس الحالي كان رئيساً لواحد من اللجان في الكونجرس المسؤولة عن العلاقات الخارجية، ولم يُلحظ أنه كان مهتماً في أي يوم بالديمقراطية في المنطقة أو كان معنياً بتغيير الأنظمة السياسية. ربما في فترة حكمة قد يستثمر فكرة الدفاع عن حقوق الإنسان كوسيلة للضغط على الحلفاء والأعداء، لكن للاستثمار السياسي وتحقيق المصالح باستخدام هذه الورقة للحصول على تنازلات. فهو بدأ باستخدامها في أكثر من منطقة، لكن ليس إلى الدرجة التي تحث على التغيير. بل بالعكس بالنسبة للأردن فهذه الإدارة أكثر وداً من إدارة دونالد ترامب وتربط القيادة الأردنية علاقة وثيقة مع الرئيس الحالي، والملك عبد الله سيكون من أوائل قادة المنطقة الذين سيلتقون الرئيس بايدن. إذاً فليس للولايات المتحدة مصلحة في دعم أي تغير في بلد يُعتبر حليفاً استراتيجياً.وذهب البعض إلى أن الأردن يتعرض لمؤامرة من كيان الاحتلال (إسرائيل) وبعض الدول العربية، وهذه المقولة تناقض المقولة الأردنية بأن الأردن استطاع ورغم ما يعتري الإقليم من تغيرات عاصفة؛ أن يحافظ على علاقة وثيقة مبنية على الأخوة والتعاون مع جميع الأطراف العربية، وإن أي تصوير للأمور غير ذلك يكذب تلك المقولة ويطعنها في صميمها. إذ ما مصلحة أي طرف عربي في إحداث تغيير في الأردن؟ لا أجد هذه الفرضية قادرة على الثبات أمام أي محاججة عقلانية، رغم عدم نفي وجود اضطرابات هنا أو هناك تأخذ شكل المناكفات السياسية لا غير .
أما بالنسبة لدولة الاحتلال فالخلاف ليس في جوهر العلاقة رغم ارتفاع حدة الخلافات في الفترة الأخيرة، سواء على صعيد الأماكن المقدسة أو الاستيطان وأخيراً صفقة القرن. رغم كل ذلك فالعلاقات الأمنية والاقتصادية والتنسيق المشترك في مستوياته العادية، صحيح أن الامتعاض متبادل بين الملك عبد الله ونتنياهو، لكن المؤسسات الاستراتيجية في “إسرائيل” تدرك أهمية استمرار الاستقرار في الأردن، وهي لذلك لن تنخرط في أي محاولة للتغيير في الأردن ذات طبيعية استراتيجية رغم كل ما يقال.
ولنعد لواقع الحال في الأردن فالملك عبد الله يحظى بتأييد وشعبية واسعة، وهو يمتلك زمام المبادرة في كل مفاصل الدولة، ولقاءاته متواصلة مع مكونات الشعب الأردني بكل أطيافه سواء بلقاءات مغلقة أو علنية، وهو يطرح المسائل الخلافية بوضوح لدرجة أنه طرح رؤية متقدمة للإصلاح من خلال مجموعة من الاوراق النقاشية، مما يشير إلى أن حالة الانغلاق السياسي غير موجودة حتى تفتح الباب لمحاولة التغيير. ورغم سوء الوضع الاقتصادي وتراكم عوامل التغيير، إلا أن تحولها إلى فعل على أرض الواقع أمر بعيد المنال للأسباب السابقة.
إذاً يبقى السؤال من هي الجهة المعنية بجعل هذه المناسبة على هذا القدر من ألاهمية، بحيث صُور الوضع بأنه مفصلي: إما.. أو. إما أن تتم السيطرة عليه أو سيؤدي إلى تغيير جذري في الدولة. فالأمن في كل مكان، وحالة من التحفز بحيث تم تصوير الناشطين في الخارج بأنهم يقودون جيوشا في الداخل ستتحرك عند نقطة الصفر، تدعمها قوى خارجية تريد إسقاط الحكم في الاردن لغايات تخدم مصالح تلك الأطراف، وإن هؤلاء الناشطين هم بيادق تلك القوى، وطلائع قوتها!
طبعاً أنا لا أستبعد أن تستخدم الدول شتى الوسائل للضغط على بعضها، لكن في ظل المعطيات المذكورة سابقاً أعتقد أن التفكير في هذا الاتجاه أمر غير واقعي. إذاً ما الذي جرى؟ أيريد أحد أو جهة ما أن تسجل إنجاز بأنها أسقطت مؤامرة كان مقرراً أن تحدث فقامت بعملية التجييش تلك؟ لكن ما هو الثمن الذي يريده ذلك الطرف من وراء ذلك؟ بدون شك هو ثمن سياسي. لا أمتلك إجابة فعلاً، لكن ما حصل أضر بسمعة الأردن وخلق الانطباع بوجود مخاوف عميقة على استقرار مؤسسات الحكم أمام العالم، مما قد تكون له آثار على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. كما أن الاعتقالات التي تمت بشكل متوتر للناشطين جعلت الأردن يبدو كدولة اليد الطولى فيها للقمع، بينما تتراجع حرية التعبير والتجمهر والاعتراض إلى الحضيض. وكل ذلك له انعكاسات سلبية عميقة على مكانة الأردن في مجال حقوق الإنسان، مما قد يشكل نقطة ضعف كبيرة على الصعيد الداخلي والدولي.
والأخطر في هذا السلوك هو بداية تكوّن مجموعات تفكر في مصلحتها الذاتية بمعزل عن المصلحة الاستراتيجة للدولة، وهذا أمر شديد الخطورة، فبدلا من الالتفات لإصلاح أي خلل قد يكون مدعاة لإثارة غضب المجتمع؛ أو قد يكون سبباً في تراجع مستوى التقدم على الصعيد المؤسساتي أو الاقتصادي وتجاوز الخلل أياً يكون.. بدل حلّ ذلك يتم التركيز على إيجاد ذرائع لتبرير الفشل، فيتم إرجاع سبب أي فشل لوجود مؤامرة أو تدخل خارجي، أو كل تلك الافكار التي تتبناها الأنظمة الشمولية لتوصل شعوبها إلى قناعة بأن الخارج وحده هو السبب في ما هي فيه.
والمؤلم أنه اذا ما تعزز هذا النمط من التفكير لدى البعض فإن النتائج ستكون وخيمة، فما يحدث في الإقليم حولنا يكفي وحده لنبذ هكذا نمط من التفكير، وسلوك الطريق الأطول والأصعب ولكنه الأسلم والأجدى للسير فيه.. أعني هنا طريق الإصلاح الفعلي الذي يأخذ بجدية مصلحة الكتل الاجتماعية وطموحاتها. بذلك فقط أعتقد أن الكثير من دول العالم حققت الاستقرار ومن ثم النجاح.