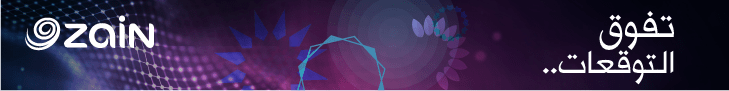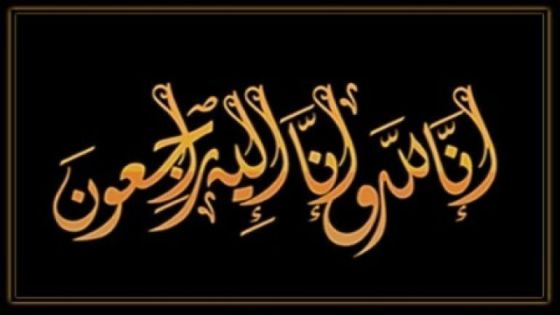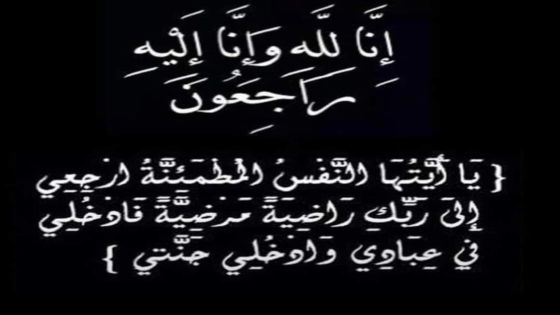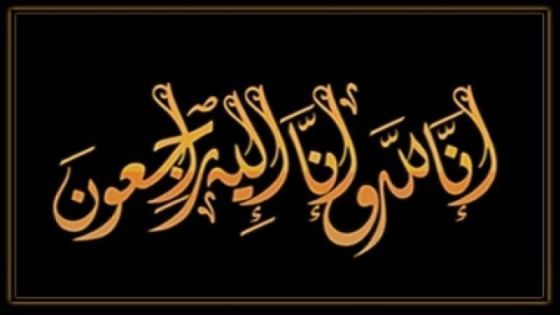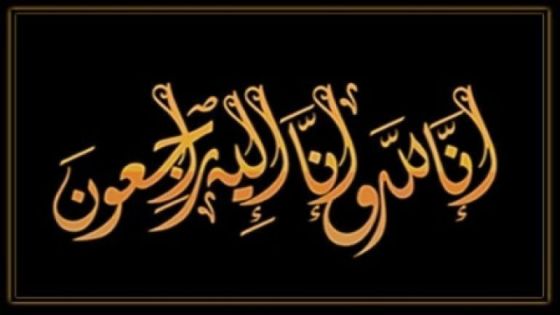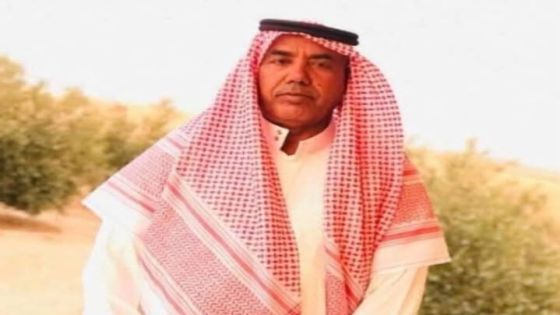مركز حزب عزم للدراسات الاستراتيجية
منذ أكثر من عقدين، يشكّل الملف النووي الإيراني أحد أكثر الملفات تأثيرًا في توازنات الشرق الأوسط والعالم. ورغم العقوبات والضربات الإسرائيلية والأميركية والمفاوضات المتكررة، يبقى السؤال مطروحًا، هل انتهى المشروع النووي الإيراني فعلًا، أم أن المنطقة تعيش في هدوء مؤقت قبل البدء بعاصفة جديدة؟
إسرائيل تمتلك ترسانة نووية غير معلنة، وإيران تسعى منذ سنوات لتطوير برنامجها النووي تحت شعار الاستخدام السلمي، بينما الشكوك الدولية قائمة. وقد لخّص يوفال هراري المشهد بقوله “في الشرق الأوسط، النووي ليس توازن ردع، بل معركة وجود بين أنظمة وهويات متصارعة”.
عام 2015، وقّعت إيران اتفاقًا نوويًا مع الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، لكن انسحاب واشنطن عام 2018 في عهد الرئيس ترامب أنهى الاتفاق وأدخل المنطقة في مرحلة ضبابية. ومنذ ذلك الوقت، فشلت محاولات إحيائه بسبب أزمة الثقة المتبادلة، طهران لا تنسى انسحاب الرئيس ترامب، والغرب يشكّ في نواياها. وأي اتفاق جديد يحتاج ضمانات أعمق ورقابة أكثر صرامة.
العقوبات أضعفت الاقتصاد الإيراني لكنها لم تغيّر سلوك النظام، بل دفعت طهران نحو تعزيز تحالفاتها مع موسكو وبكين، واعتماد ما يسمى “اقتصاد المقاومة”. وقد دعمت روسيا والصين إيران استراتيجيًا واقتصاديًا، فيما واصلت الولايات المتحدة سياسة الضغط المزدوج، عقوبات خانقة وضربات محدودة لأذرع طهران في سوريا والعراق.
هكذا تحوّل الملف النووي إلى ساحة تنافس دولي مفتوح. وكما قال كيسنجر “المشكلة مع إيران ليست اليوم، بل فيما قد تفعله غدًا إذا تُركت بلا قيود”. إسرائيل بدورها لم تكتفِ بالضغط الدبلوماسي، بل نفّذت عمليات نوعية ضد العلماء والمنشآت النووية مثل تفجير مفاعل نطنز عام 2020، مما أبطأ البرنامج دون أن يوقفه، وأثار شكوكًا داخلية حول هشاشة المنظومة الأمنية الإيرانية.
وفي الوقت ذاته، وسّعت إيران نفوذها منذ مطلع القرن الحالي، مشكّلة ما عُرف بـالهلال الإيراني، الممتد من طهران إلى بيروت عبر بغداد ودمشق، وهو ما حذّر منه الملك عبد الله الثاني مبكرًا عام 2003. إلا أن هذا الهلال بدأ يتراجع؛ ففي العراق تصاعدت مقاومة النفوذ الإيراني، وفي سوريا تبدلت المعادلات بعد سقوط نظام الاسد، وفي لبنان تراجع حزب الله تحت وطأة الأزمات التي عصفت به. لكن نفوذ طهران العقائدي والسياسي لم يختفِ، بل أعاد التموضع بأساليب أكثر مرونة.
فإيران ترى في شبكة وكلائها (حزب الله، فصائل العراق، الحوثيين، وبعض الفصائل في غزة) عنصرًا جوهريًا لاستمرار نفوذها، ما يعني أن أي حل مستدام يجب أن يتعامل مع هذه الشبكات بقدر ما يتعامل مع الملف النووي ذاته.
بعد تصاعد التوترات، شنّت إسرائيل في حزيران 2025 ضربات على مواقع داخل إيران، تبعها هجوم أميركي على منشآت نطنز وفوردو وإصفهان. وقد هدفت العمليات إلى إبطال قدرات قريبة من إنتاج سلاح نووي. وردّت طهران بصواريخ وطائرات مسيّرة دون توسيع المواجهة، خوفًا من تكاليف إقليمية ضخمة. وأكدت التقارير أن الضربات أحدثت أضرارًا جسيمة وأبطأت التخصيب، لكنها لم تدمر القدرات بالكامل.
فبحسب تقارير المفتشين، ما زالت آلاف أجهزة الطرد المركزي قائمة جزئيًا، وبعض مخزونات اليورانيوم المخصب مخبأة، ما يجعل تقدير القدرة الفعلية على تصنيع السلاح صعبًا. فالضربات عطّلت البرنامج مؤقتًا، لكنها لم تُزل البنية التحتية أو القدرة والخبرة البشرية والبحثية، وهو ما يجعل الخطر مؤجلًا لا منتهيًا.
روسيا والصين أدانتا الهجمات ودعتا لضبط النفس، لكنهما لم تقدّما دعمًا عسكريًا لطهران، إذ لا مصلحة لهما في تصعيد يضرّ بمصالحهما. ومع ذلك، تريان أن المسار الدبلوماسي لا يزال ممكنًا وإن كان يمرّ بمرحلة حرجة.
في المقابل، عادت العقوبات الأميركية والأوروبية إلى الواجهة، وشُدّد الحصار المالي والتكنولوجي. وردّت طهران بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفعت مستوى التخصيب كورقة ضغط تفاوضية. ومع تزايد العمليات الإسرائيلية الاستخبارية، بات المشهد قريبًا من حافة الاشتعال الشامل.
البرنامج النووي الإيراني ما زال ممكنًا تقنيًا إذا توفرت له مساحة زمنية كافية أو دعم خارجي. التغيير الجوهري اليوم هو تعطيل مؤقت، مقابل عزلة سياسية واقتصادية غير مسبوقة.
ومع انتهاء الحرب في غزة، أو تحولها إلى تهدئة طويلة، يُتوقّع أن يعود الملف النووي الإيراني إلى صدارة الاهتمام الدولي. فوقف القتال سيفتح الباب أمام تركيز جديد على طهران وبرنامجها النووي. وهنا تقف القوى الكبرى أمام ثلاثة خيارات: دبلوماسي، اقتصادي، أو عسكري وربما مزيج بينها.
الخيار الدبلوماسي يقوم على إعادة صياغة اتفاق أكثر صرامة، يتضمن زيارات تفتيش دائمة وآليات عقوبات فورية، وهو الأكثر استدامة لكنه يحتاج ثقة، وهي التي باتت معدومة حاليًا بين واشنطن وطهران. كما قد تسعى موسكو وبكين لإضعاف فاعلية العقوبات كي لا تُعزل إيران تمامًا.
الخيار الاقتصادي يتمثل في تشديد العقوبات وقطع خطوط التمويل والتوريد، وهو مطبّق فعليًا. ميزته أنه يضغط على النظام ويحدّ من موارد برنامجه النووي، لكنه يزيد عزلة إيران ويدفعها نحو خيارات انتحارية، ويضرّ بالمدنيين ودول الجوار عبر ارتفاع أسعار الطاقة وتدفّق اللاجئين.
الخيار العسكري يتمثل في تدمير منشآت التخصيب والمخازن بضربات جوية واستخبارية دقيقة. ورغم أن ذلك قد يبطئ البرنامج لسنوات، إلا أن مخاطره جسيمة، فمواقع كفوردو بُنيت تحت الأرض، وأي هجوم واسع قد يشعل حربًا إقليمية تمتد من الخليج إلى المتوسط، مع احتمالات ردّ إيراني عبر الوكلاء وضرب الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة. كما أن المعرفة النووية لا يمكن تدميرها بالقصف، مما يعني أن التهديد سيعود لاحقًا بشكل او باخر.
أما الخيار المختلط، فهو الأكثر واقعية، ويقوم على الدمج بين الردع العسكري والمفاوضات المتدرجة، بحيث يُربط رفع العقوبات بتقدم ملموس في الرقابة التقنية. هذا الخيار يقلّل فرص الحرب لكنه يتطلب تنسيقًا دوليًا عاليًا وثقة تكاد تكون معدومة بين الاطراف. دول الخليج قد تكون الأكثر ميلاً لمثل هذا الخيار، خصوصًا مع فرصة التهدئة في غزة التي قد تفتح نافذة محدودة لاستئناف التفاوض ضمن صيغة جديدة توازن بين ضمانات إيران والقيود الغربية.
في المقابل، تبقى تركيا وإسرائيل القوتين الإقليميتين الأكثر تأثيرًا. فتركيا تفرض حضورًا اقتصاديًا وعسكريًا متصاعدًا، وإسرائيل تملك تفوقًا تقنيًا ونوويًا. أما الاتفاقية الدفاعية بين السعودية وباكستان، فتمثل تحوّلًا استراتيجيًا يمنح الرياض عمقًا ردعيًا من خلال حليف يمتلك السلاح النووي، في رسالة واضحة لطهران ولغيرها، بأن أي تهديد مباشر سيقابل بردع غير تقليدي، مما يعيد رسم ميزان القوى ويزيد تعقيد الحسابات الإيرانية.
الأردن، بدوره، يقف في موقع حساس بوصفه حليفًا أمنيًا مهمًا للغرب ومضيفًا لملايين اللاجئين. وقد دعا دائمًا إلى التهدئة ومنع تحوّل المنطقة إلى ساحة حرب. وتحذيرات الملك عبد الله الثاني المتكررة من الهلال الإيراني عام 2003، إلى التحذير عامي 2006 و2025 من مخاطر ضرب إيران، تعبّر عن رؤية استراتيجية تعتبر أن أي مواجهة ستفجّر المنطقة بأكملها.
يدعم الأردن كل جهد لمنع الانتشار النووي، ويدعو إلى حل دبلوماسي شامل يحمي استقرار الإقليم ويصون سيادته. وفي الوقت نفسه، يوازن بين التحذير السياسي والحفاظ على شراكاته الأمنية مع الولايات المتحدة والخليج، مع الحرص على منع أي اضطرابات حدودية أو موجات لجوء جديدة.
لقد نقلت الضربات الأخيرة الملف النووي من خانة التكهّن إلى خانة الإمكان الواقعي، لكنها لم تُنهِ الطموح الإيراني. فما جرى هو إعادة رسم للمعادلات وتقليص مؤقت للقدرات، وسط تصعيد سياسي ودبلوماسي واسع. وبغياب آليات تحقق فعّالة وتنسيق إقليمي، يبقى التهديد النووي قابلًا للعودة في أي وقت.
من منظور حزب عزم الأردني، فإن الهلال الإيراني لم ينتهِ، لكنه تراجع جزئيًا تحت وطأة الضغوط والهزائم في ساحات مختلفة. غير أن نفوذ طهران الأيديولوجي والسياسي ما زال حاضرًا، والملف النووي بات اختبارًا لمدى قدرة النظام الدولي على ضبط الانتشار في منطقة متشابكة المصالح.
اليوم تتقلص البدائل الدبلوماسية، ويبدو أن أي تصعيد إيراني سيعيد تشكيل التحالفات الإقليمية والدولية من جديد. فالضربة على المنشآت الإيرانية أعادت طرح السؤال المحوري، هل يمكن احتواء الانتشار النووي عبر الضغط العسكري، أم لا بد من تسوية قابلة للتحقق؟
الا ان حزب عزم يرى الربط الواضح بين الحرب في غزة وبين الملف النووي الإيراني، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي في خطابه امام الكنسيت الإسرائيلي يوم أمس، الى ان التوصل الى اتفاق السلام بين إسرائيل وغزة لم يكن ممكنا لولا قصف الولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية، مضيفا أنه يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام صفقة خاصة بها؟
ويبدو أن ما قاله الرئيس الأميركي في خطابه الأخير أمام الكنيست الإسرائيلي جاء ليؤكد هذا التحول في فلسفة واشنطن تجاه الملف الإيراني. فقد حرص على التذكير بأن “إسرائيل دولة صغيرة المساحة، لكنها كبيرة في دورها الأمني والاستراتيجي”، في إشارة واضحة إلى أن حماية إسرائيل لم تعد قضية ثنائية بل محورًا لسياسة الردع الأميركية في المنطقة. ومن خلال تناوله لبرنامج إيران النووي بلهجة حازمة امتزجت بين التهديد والدعوة إلى الحوار، بدا وكأن الولايات المتحدة ترسم حدود اللعبة الجديدة، لا عودة إلى الاتفاق النووي بصيغته القديمة، ولا مواجهة شاملة ما لم تُستنزف كل خيارات الردع الذكي.
هذا الخطاب لم يكن مجرد رسالة دعم لإسرائيل، بل أيضًا رسالة اختبار لإيران مفادها أن مستقبل الشرق الأوسط سيُعاد رسمه على أساس موازين القوة الجديدة، حيث يمتلك من يضبط برنامجه النووي ويمارس ضبط النفس موقعًا تفاوضيًا أقوى (في الخطاب الموجه لإيران، “نحن مستعدون عندما تكونوا مستعدين”). ومع ذلك، فإن ترك الباب مفتوحًا أمام صفقة سلام محتملة بين إيران وإسرائيل، كما لمح الرئيس، يعكس إدراكًا أميركيًا بأن أمن المنطقة لن يتحقق بالضربات الوقائية وحدها، بل بتسوية شاملة توازن بين الطموح النووي الإيراني ومتطلبات الاستقرار الإقليمي. ان مثل هذا الطرح قد يكون اخذ في الحسبان التطورات المتلاحقة في موقف روسيا (بعد المواقف الجديدة في تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة)، والصين (بعد تفاقم التصريحات عن الرسوم الجمركية والتي تشير الى بوادر حرب اقتصادية مكتملة الأركان).
يمكن ان قراءة ما ورد في الخطاب من الزاوية السياسية والاستراتيجية، عن تحوّل واضح في الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران من سياسة الاحتواء إلى الردع الموجّه، وما يعنيه ذلك لمعادلة الردع في الشرق الأوسط. اما من زاوية التوقعات الجيوسياسية، فان أمريكا لا تنظر إلى النووي الإيراني كملف تقني فقط، بل كمدخل لإعادة تشكيل النظام الإقليمي وموقع إسرائيل فيه.
إن عادت واشنطن وتل أبيب إلى القناعة بأن طهران تعيد بناء قدراتها بسرعة، فقد تتكرر الضربات بوتيرة أعلى، مما يرفع خطر الانزلاق إلى مواجهة إقليمية مفتوحة، خاصة أن أي هجوم جديد سيقابَل بردّ من إيران مباشرة، ومن أذرعها عبر استهداف مصالح أميركية واسرائيلية في المنطقة. وهكذا تبقى المنطقة رهينة الردع القلق، تدور في حلقة من الإبطاء والتصعيد، بلا حسم نهائي.
ويؤكد حزب عزم أن الشرق الأوسط اليوم، يمر بمرحلة غير مسبوقة من الخطورة، ويبقى امام المنطقة خيارات، إمّا إدارة الأزمة بعقلانية قائمة على حسابات دقيقة للتكلفة والمنفعة، أو الدخول في صدام قد يعيد رسم خرائط المنطقة لعقود مقبلة، ويحوّل الملف النووي من قضية تفاوض إلى أزمة وجودية مفتوحة.