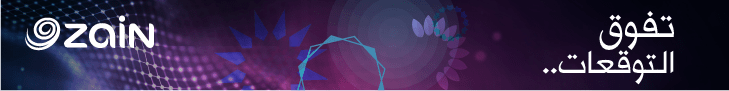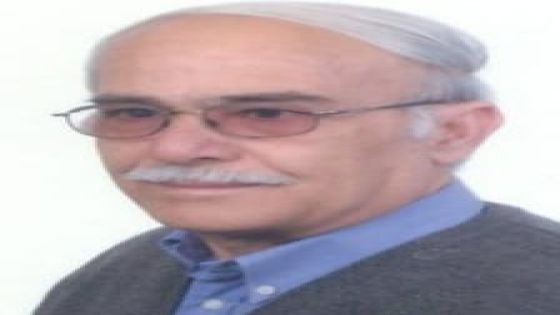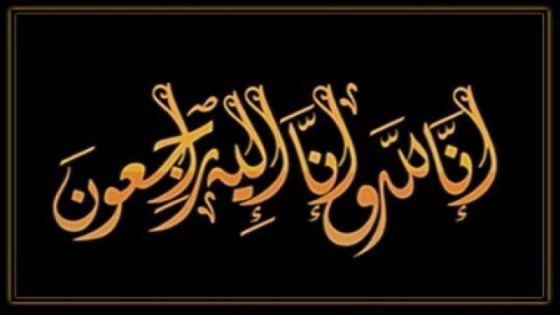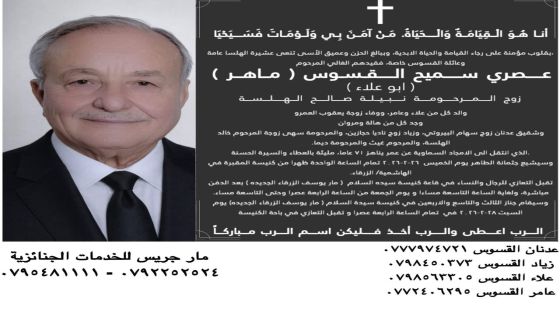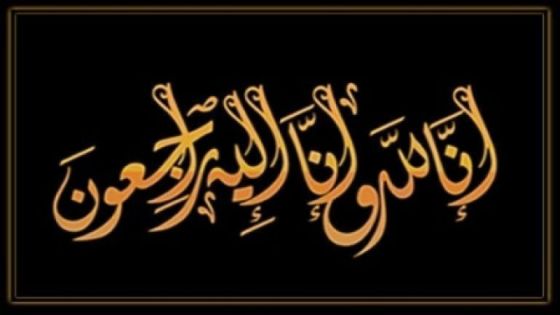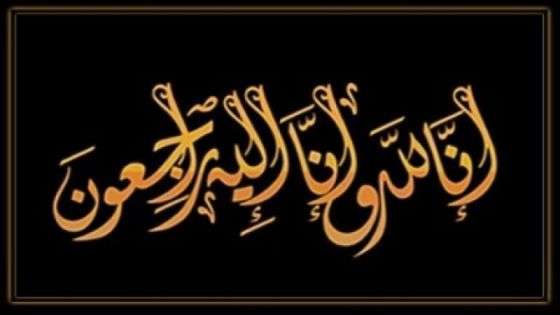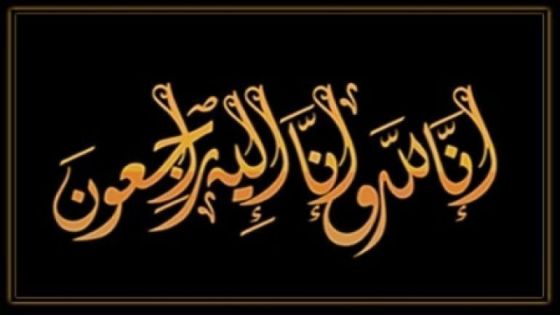كتب د. محمد عبد الله القواسمة
يسعى القارئ قبل أن يبدأ قراءة أي نص إلى معرفة المؤلف، فلا نستطيع فصل النص عن صاحبه، وإذا كان النص مجهول المؤلف فإن القارئ يحاول أن يتصور هذا المؤلف من خلال النص؛ فهو الذي يحمل مشاعره وأفكاره، وأسلوبه وعواطفه، وتوجهاته الفكرية والأدبية.
لا تسعفنا نظرية التلقي وتجليات القراءة بفهم تأثير هذه المعرفة في معالجة النص؛ فلا تجعله النظرية ضمن اهتمامها بأفق التوقع أو أفق الانتظار، ذلك المفهوم الإجرائي الذي وصف به الناقد الألماني ياوس عملية تلقي القارئ النص والتعامل معه حسب قراءاته ومستواه الفكري والثقافي؛ ليصل إلى معنى النص المقصود، مع أنها النظرية، التي تهتم بالقارئ وتُقدّمه على عنصري الإبداع الآخرين: النص والمؤلف.
وإذا كان القارئ الذي نهتم به في هذا المقال هو القارئ الذي يتمتع بمعرفة حياة المؤلف وأسراره، فإن هذا يقودنا، إذا ما تحققت هذه المعرفة، إلى التساؤل عن تأثيرها في فهم النص وتأويله، والحكم عليه وتقييمه، والتساؤل إن كانت تُعلي من أهمية المؤلف أو تنقص منها، أو تؤثر في إقبال القارئ على قراءة النصوص الأخرى للمؤلف نفسه أو في عزوفه عنها.
تثبت التجربة لدى كثير من القراء أن معرفتهم بالمؤلف تضيء جوانب كثيرة من النص، وتساعد على فهم معانيه وفك رموزه، وتفسير ما غمض من أفكاره، وكشف ما فيها من أسرار، ووضع النص في سياقه التاريخي والاجتماعي. وقد تزيد تلك المعرفة أو تنقص من قيمة المؤلف والإقبال على ما يكتب. فعلى سبيل المثال، فإن معرفة القارئ بلجوء المتنبي إلى تكسب المال يفسر له كثرة المديح في شعره، ومبالغاته في وصف الممدوح، وحرصه على دقة معانيه وتنوعها، وبلاغته اللغوية ليظفر برضا ممدوحه دون غيره من الشعراء. ووجدنا غير قليل من الأدباء والبلغاء يقللون من أهميته شاعرًا بسبب تلك الصفة في الغالب، ويتهمونه بأنه أول من فتح باب التكسب على مصراعيه في تاريخ الشعر العربي.
والمثال الآخر أبو فراس الحمداني، فإن معرفة قرابته لسيف الدولة الحمداني أتاح لبعض قراء قصيدته» أراك عصي الدمع» التي قالها وهو في سجن الروم أن يفسروا مقدمتها الغزلية بأن الشاعر لا يخاطب امرأة بعينها، فيشكو من صدها، ومن وعودها المترددة في اللقاء، يل يخاطب ابن عمه سيف الدولة عندما لم يهب لإنقاذه من الأسر، مع أنه الفارس الشجاع الذي لا يستحق أن يُنسى. إن فهم هذه القصدية لم يكن إلا بمعرفة صلة القرابة بين الشاعر وسيف الدولة.
ونجد أن بعض الأدباء يزداد الاهتمام بأعمالهم وتتسع شهرتهم على ضوء معرفة تاريخ حياتهم والنهاية التي آلت إليها، مثل مقتل الشاعر التشيلي بابلو نيرودا بالسم عام 1973م بعد الإطاحة بحاكم البلاد سلفادور ألندي الذي كان مقربًا منه. وكذلك مقتل الشاعر الإسباني لوركا عام 1936م على يد القوات الموالية للجنرال الدكتاتور فرانكو. ومثل ذلك اغتيال الشهيد غسان كنفاني بتفجير سيارته في بيروت عام 1972م على يد الموساد الصهيوني. ولا ننسى تلك النهاية الحزينة للشاعرين تيسير سبول وخليل حاوي عندما أقدما على الانتحار لاحتجاج الأول على هزيمة العرب عام 1967م. والآخر لدخول الدبابات الإسرائيلية بيروت عام 1982.
لا شك في أن نهاية هؤلاء الأدباء كانت صدمة للقراء في مختلف بلاد العالم، وبخاصة العالم الثالث، وأقبلوا على البحث عن أعمالهم، وانكبوا عليها بالدراسة والترجمة؛ فاتسعت شهرتهم، وارتفعت قيمتهم على ما يتميزون به إبداعًا وإنسانية. ولم يكن ليحظوا بذلك دون تلك المعرفة أو الاطلاع على حياتهم.
إن تأثير معرفة القارئ حياة المؤلف في فهمه النصوص والحكم عليها ربما يفسر محاولة بعض الأدباء تجنب الحديث عن حياتهم الخاصة، وإضفاء هالة من الغموض عليها؛ ليحافظوا على شهرتهم وقيمتهم، ويتركوا الأمر للنص ليتحدث عنهم. وهذا ما كان يحرص عليه جبران خليل جبران على سبيل المثال؛ فقد عرف بسموه الروحي، وقيمه الخلقية الراقية، وظهوره كالقديس الخالي من الخطايا، كما تبدى في كتابه «النبي»، وقصته» الأجنحة المتكسرة»، وأشعاره الرومانسية، حتى كُتب على قبره «هنا يرقد نبينا جبران». ولكن تغيرت صورته لدى القراء، وتغيرت النظرة إلى كتاباته، وطريقة دراستها عندما جاء صديقه ميخائيل نعيمة، وتناول حياته بصدق في كتابه» جبران خليل جبران» وأظهره إنسانًا له خطاياه بخلاف ما تجلى في كتاباته، إذ أنزله من السماء إلى الأرض.
وربما فكرة موت المؤلف، التي أعلن عنها الناقد الفرنسي رولان بارت في ستينيات القرن الماضي لم تكن للحد من غلبة المناهج النقدية الخارجية في فهم النص فحسب، بل لإبعاد حياة المؤلف عن مجال تأثيرها في فهم النص، وتقويم صاحبه أيضًا.
لكن ما يجب الإشارة إليه أن بعض القراء يتعسفون في وقوفهم من المؤلف، وليس من النص وحده على ضوء فهمهم حياته الخاصة، سواء بتعزيز قيمته، والاهتمام به، أم بوضعه في مرتبة متدنية إبداعًا وسلوكًا، وفي الحالتين ظلم للنص، الذي هو المحور الرئيسي في العملية الإبداعية.