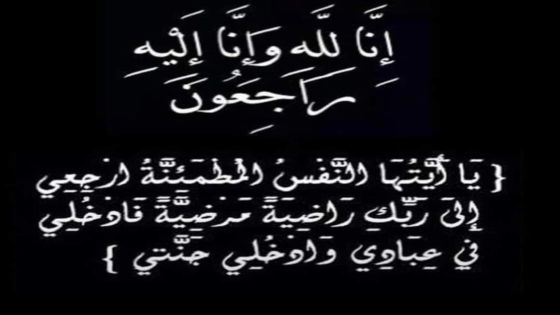نضال المجالي
290 دينارا هو الحد الأدنى للأجور المعلن رسميا، والذي كالعادة جاء مخيبا للآمال، لفئة من الشعب هي الأكثر تضررا في قدرتها على تلبية متطلبات الحياة، التي تتجاوز قيم نفقاتها في متوسطها المقبول 600 دينار شهريا، وغالبا لأسرة مكونة من أربعة أشخاص، إن كانوا قد اختاروا أحد الأحياء البعيدة عن متطلبات الحياة أو إحدى القرى النائية مسكنا لهم، لمحاولتهم ضمان اكتفاء الدخل الشهري لتغطية أجرة منزل وخدمات كهرباء وماء ومتطلبات نقل عام وإعاشة وتعليم وصحة، دون أي فرصة لترفيه ولو لمرة واحدة كل عشر سنوات لرحلة داخلية إلى العقبة أو البحر الميت أو آثار جرش، لولا تدخل برنامج “أردننا جنّة»، الذي أتاح لعدد من تلك الأسر فرصة العمر برحلة داخلية، فكيف الحال بالتغني والدفاع عن تحديد 290 دينارا بأنها حد أدنى مقبول لأجر شهري لعامل في أي موقع كان؟
في موضوع الحد الأدنى للأجور من المستفيد وصاحب المصلحة لإبقائه بحد أدنى دائما؟ سؤال يحتاج للإجابة من قبل الجهات المختصة، التي توصلت أو أُلزمت باتخاذ هذا القرار، والذي قد تكون عضوية لجانه المختصة في قراءة ودراسة تحديد المبلغ المعلن قد تقاضت مكافآت فوق رواتبها تتجاوز ما أقرته من حد أدنى للأجور؟ فلن يقبل أي موظف أن يتقاضى مبلغ 290 دينارا شهريا كمكافأة بدل عمله بتلك اللجنة، علما أن حضوره لا يتجاوز فيها ساعات محدودة، في وقت يتم التوصية بإقرار منح من يعمل نحو 200 ساعة شهريا مبلغا يعادل دينارا ونصف دينار بدلا لكل يوم عمل له!! علما أن قيمة هذا المبلغ وحده سوقيا تجيب عن السؤال المطروح من هو صاحب المصلحة والمستفيد؟ بالرغم أن الصف الأول الابتدائي في علم الاقتصاد يؤكد أن خلق فرص العمل وارتفاع الرواتب يقابله ارتفاع الإنفاق الذي يزيد من حركة الأموال وما تحققه من عوائد الرسوم والضرائب المحصلة بقيم أكبر.
والسؤال المقابل لذلك، لماذا لا يتم مثلا تحديد حد أعلى لا يسمح بتجاوزه لقرارات الزيادة المتتالية على أثمان الكهرباء والماء والطاقة والرسوم والضرائب والاتصالات والنقل والتأمين وغيرها كثير من عوامل هي سبب تآكل رواتب الموظفين من أصحاب الحد الأدنى خصوصا؟ ولماذا ما هو متاح وقرار المصادقة على رفع سقوفه سهل في نظر المعنيين تحت عنوان المصلحة الوطنية وعندما يصل الأمر لجيب المواطن يكون التفكير بحد أدنى وقيود لا تنتهي من خصومات على حقوق في عائدات لم تكن يوما تكافئ عمله؟ أسئلة ليست محيرة إن صدقنا الإجابة عليها، بل ونسأل المئات منها يوميا ولأكثر من خدمة، ولكنها أسئلة تغضب المعني أو المكلف بضمان حياة أو عيش مقبول بالرغم من أنها تمثل أولى خطوات الأمن والسلم المجتمعي! ولكن غضبهم ليس لعدم قدرتهم على إجابتها، فهم أول من يجيب عليها عند خروجهم من باب المسؤولية ومغادرة كرسي القرار، والدلائل كثيرة على ذلك، بل غضبهم بما تمثله من زلزال يهز مواقعهم وامتيازاتهم ما داموا عاملين عليها.
وحتى لا ننسى، لنعلم أننا قد نكون الوحيدين ممن يصادق في نظام العمل على مستويين من مصطلح “الأدنى للأجور»، فالأدنى العام يقابله أدنى مخصص لمن يعملون من أبناء الوطن في قطاع الحياكة -الغزل والنسيج- والذي يسجل عوائد مرتفعة لمالكيه ومستثمريه، إلى جانب ما يحققه أيضا من عوائد إضافية من رسوم التصدير والجمارك والنقل، محققا مصلحة وأرباحا كبيرة للمستثمرين في هذا القطاع، ولهذا كانوا أقوى في فرض ما هو أدنى من الأدنى للعاملين في هذا القطاع محققين بقرار حكومي رسمي ضررا يلحق بما يزيد على 93 ألف عامل أردني، والذين وإن كانت بيئة عملهم قد جُهزت بالتكييف كما أجابني أحدهم تبريرا لجودة بيئة عملهم، كنت قد أجبته نعم؛ فعلا بيئتهم كانت صالات مكيفة ونظيفة، ولكن لضمان جودة وسلامة الخيوط والأقمشة لا العاملين عليها، ولنعلم أن هذه الفئة من العمالة هي عمالة ماهرة محترفة ومنتجة بكفاءة عالية وللتذكير هم يحملون صفة البشر أيضا فلا فرق بينهم وبين أقرانهم المظلومين بحد أدنى عام للأجور، ولا قيمة حقيقية وعائد في بيئة عملهم سوى انضمامهم منتسبين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي تحتضنهم كما تحتضن كل موظفي وعاملي الوطن، وأما غير ذلك من امتيازات فهي لم تتجاوز كونها هبات وصدقات تنتهي بانتهاء يوم العمل
الأدنى للأجور.. الكل خسران فلمن المصلحة؟