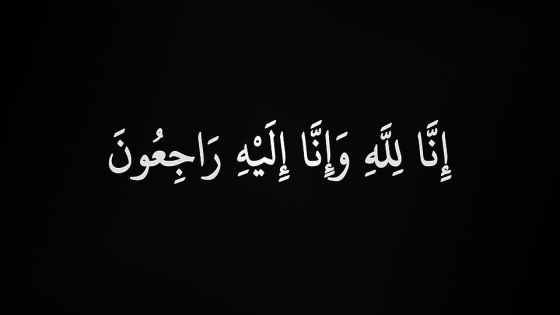بقلم/ أ.د. طالب أبو شرار
مثل بقية العلوم، تشهد كافة مدخلات الإنتاج الزراعي تقنيات متجددة هدفها الوحيد هو تعظيم العائد من النشاط الزراعي عبر تطوير أي من عناصر بيئة الإنتاج الزراعي النباتي أو الحيواني كالتحكم في الحرارة أو الضوء أو الرطوبة النسبية أو ابتداع بيئات إنتاج غير تقليدية أو أي خليط مما سبق أو تطوير مدخلات العملية الزراعية كاقتراح خلطات جديدة من الأسمدة الكيميائية الذوابة في الماء أو ابتداع أنظمة ري غير مألوفة تقنن كميات المياه اللازمة للمحصول وتحد من الفاقد المائي وتحافظ على نوعية التربة أو اقتراح إدارة مالية أو تقنية تخفض كلف الإنتاج أو تطوير صناعة المكائن التي تؤدي كافة الأعمال الزراعية بكفاءة واقتدار كالحراثة وتمهيد التربة للزراعة ورش مبيدات الآفات وحصاد المحاصيل المختلفة وفرز وتعبئة ونقل وتخزين المحصول والحؤول دون تلفه حشريا أو فطريا. أحيانا نشهد مزاوجة بين أسلوبين أو أكثر لتعظيم كم ونوعية الإنتاج. مثال ذلك حزمة عمليات الإنتاج المتداخلة التي طورتها فرق بحثية متنوعة في إطار الثورة الخضراء التي يطلق عليها لقب الثورة الزراعية الثالثة والتي شهدها عقدا الخمسينات والستينات من القرن المنصرم. يوحي الترتيب العددي السابق بأن هناك ثورتين زراعيتين قد سبقتا الثورة الخضراء: أولاهما عرفت بثورة العصر الحديث الزراعية Neolithic Revolution والتي تجسدت بانتقال الجنس البشري من عصر الصيد وجمع الغذاء (Paleolithic Age) الى عصر الانتاج الزراعي والاستيطان البشري. في ذلك العصر المبكر من عمر البشرية تعلم الإنسان تكنولوجيا الزراعة وحصاد المحصول وتربية ومزاوجة الحيوانات بهدف تحسين الأصناف الحيوانية. في تلك المرحلة المبكرة كان لا بد للإنسان أن يتحول من عصر الترحال الى عصر الاستقرار وما تلي ذلك من تعاظم النشاط الذهني الإبداعي للجنس البشري. لقد تركز جزء كبير من ذلك النشاط الإنساني في بعض بلادنا العربية خاصة بلاد الشام ووادي الرافدين ووادي النيل. تلي تلك المرحلة الزراعية الممتدة عبر قرون عديدة الثورة الزراعية الثانية وهي بريطانية الهوية تقريبا. امتدت تلك الثورة على هامش زمني بين منتصف القرن السابع عشر ونهاية القرن التاسع عشر. في تلك الفترة ازداد الناتج الزراعي البريطاني بوتيرة فاقت الزيادة في عدد السكان لأسباب عدة أهمها تطوير مدخلات الإنتاج الزراعي خاصة استخدام الجوانو (زرق الطيور البحرية والخفافيش) القادم بالدرجة الأولى من سواحل وجزر البيرو الجافة الى المزارع البريطانية مما عظم الإنتاج النباتي وحفز التقدم العلمي خاصة الكشف عن آليات نمو النبات وأهمية تغذيته بالعناصر المعدنية وما تلا ذلك من تطوير عمليات صناعية لاختزال النيتروجين الجوي الى أمونيا واستخدامها كسماد كيميائي.
الثورة الخضراء هي حزمة من التقنيات الزراعية الموجهة الى تعظيم الإنتاج الزراعي أو ما يعرف بإنتاجية الأرض Land Productivity وهو مصطلح اقتصادي المدلول إذ يشير الى جملة من أساليب إدارة الأعمال والتقنيات التي تؤدي مجتمعة الى زيادة ربحية وحدة المساحة من الأراضي الزراعية سواء جاءت تلك الربحية من الإنتاج النباتي أو الحيواني. تشمل تلك المدخلات استخدام الأصناف النباتية ذات الإنتاجية المرتفعة والمقاومة للأمراض خاصة الرز والقمح الذي انتقيت منه الأصناف قصيرة الساق (المتقزمة) عالية الإنتاج والمقاومة لمرض الصدأ، والأسمدة الكيميائية ومبيدات الأفات وإدارة الأعمال الزراعية. جاء ذلك النشاط المنهجي استجابة لتفاقم أزمة الغذاء العالمي وبدعم سخي من مؤسستي فورد وروكفيللر الأمريكيتين خاصة الأبحاث التي كانت تجرى في المكسيك. لقد تبنت أقطار عديدة ذلك النمط المتكامل من تقنيات الإنتاج الزراعي وبصفة خاصة في الهند والباكستان اللتين عانتا أكثر من غيرهما من الأقطار النامية من وطأة المجاعة. وبسبب مساهمته المميزة في تلك الإجراءات منح نورمان بورلاو Norman Borlaug والذي أطلق عليه لقب “والد الثورة الخضراء” جائزة نوبل للسلام في العام 1970.
في خضم الاندفاع وراء أحلام الاكتفاء الغذائي آنذاك لم يعر أحد الاهتمام الكافي للتأثيرات الجانبية على عناصر البيئة الحيوية بما في ذلك الإنسان والمترتبة على الإفراط في استخدام الأسمدة الكيميائية ومبيدات الآفات الزراعية واستنزاف التربة من مخزونها الاستراتيجي من العاصر الغذائية. في زحمة أحلام الثورة الخضراء وفي العام 1962 تحديدا، نشرت سيدة أمريكية غير مختصة بأي من العلوم الزراعية اسمها راشيل كارسون كتابا عنوانه “الربيع الصامت”. تحدثت تلك السيدة عن مشاهداتها في فصل الربيع الذي ما عادت تزور أزهاره الفراشات وما عادت موسيقى زقزقة العصافير المألوفة تسمع في ذاك الفصل بسبب الإفراط في استعمال المبيدات الحشرية التي تقتل النافع من الحشرات، كالنحل، قبل الضار منها. لقد حظي كتاب راشيل كارسون بشعبية كبيرة إذ تربع على عرش الكتب الأكثر مبيعا في تلك الفترة وقد قيل إن الرئيس الأمريكي الراحل جون ف. كينيدي قد قرأ الكتاب قبيل اغتياله في ذات العام. لقد نبه كتاب السيدة كارسون المعنيين بسلامة البيئة الى وجود مشاكل مستعصية تكمن وراء تعظيم قدرة الثورة الخضراء على حل المعضلات الكبرى التي يواجهها العالم الثالث اللاهث وراء لقمة العيش. بعيد ذلك بسنوات خبا الحماس غير المشروط للثورة الخضراء وتعلمت البشرية درسا فائق الأهمية مؤداه أن التعميم هو أمر غير موضوعي ومنحاز فالانحياز ضرب من رد الفعل العاطفي المرفوض علميا إذ لا يعتمد العلم على الحماس أو التحيز أو العاطفة. العلم هو نشاط منهجي حيادي يوثق النهايات غير السعيدة قبل تلك المكللة بالنجاح. وعلى العكس، فإن النهاية المحزنة لبحث طويل الأمد تصبح حافزا لإعادة المحاولة مرة تلو الأخرى وفي كل مرة يتجنب الباحث(ون) الأخطاء التي تكشفت في المحاولة السابقة الى أن تتحقق الشروط الموضوعية للحظة الحصاد الكبير. ما نراه في العديد من الحالات الراهنة هو حماس منقطع النظير لبعض الأنماط أو التقنيات الزراعية كما هو الحال في تقنية الزراعة المائية. لقد ضخمت تلك التقنية الى المدى الذي دفع بالبعض الى الاعتقاد بأنها بديل موضوعي عن الزراعة التقليدية التي تلعب فيها الأرض أو بتعبير أكثر دقة التربة الدور المحوري. قبل ذلك روج بعض المتحمسين هنا في بلدنا الأردن الى فكرة زراعة شجيرات الهوهوبا JoJoba والتي تتوطن في ولايات جنوب غرب الولايات المتحدة وتنتج زيتا مطابقا لزيت حوت العنبر Sperm Whale Oilالمكون من سلسلة طويلة ومستقيمة من ايستر الشمع (Wax Ester) مؤلفة من 36-46 ذرة كربون ثم تبين أن نجاح ذاك المحصول يتطلب مناطق ذات معدل أمطار سنوي مناظر لذاك الخاص بمناطق زراعة القمح في بلادنا أي أن زراعة محصول الهوهوبا توجب احلالها في مناطق انتاج القمح؟
في أعقاب غزو القضاء، اكتسب البحث في إمكانيات الزراعة في غير البيئة الطبيعية التي تطورت عبرها الحياة النباتية على كوكب الأرض أهمية كبرى ولأسباب موضوعية أهمها انتاج الغذاء في مستوطنات بشرية خارج كوكبنا مثل القمر والمريخ. أذكر في هذا الصدد أن جمعية الزراعة الأمريكية (American Society of Agronomy) نشرت في العام 1989 كتابا عنوانه “الزراعة القمرية-تربة نمو النبات” أو “Lunar Base Agriculture: Soils for Plant Growth” ثم تلي ذلك ابتداع بيئة مغلقة تبرمج فيها كافة مدخلات ومخرجات النشاط النباتي والميكروبي (تحلل البقايا العضوية) بطريقة تضمن توازن عمليتي استهلاك وإطلاق غازي الأكسجين وثاني أوكسيد الكربون من والى الهواء. لقد صممت تلك المنظومة المغلقة بكيفية تحاكي النشاط الحيواني والنباتي في مستوطنة بشرية مغلقة على سطح القمر. وبتأثير تلك التجربة، طورت بعض المؤسسات الأمريكية الأكاديمية في العقود الأخيرة ما أطلق عليه “Precision Farming” أو الزراعة الدقيقة. يقصد بذلك التعبير تقنين مدخلات الإنتاج الزراعي خاصة إضافة المادة العضوية والأسمدة الكيميائية ومبيدات الآفات بحيث لا يرتفع تركيزها في أنسجة النبات الى مستويات تضر بصحة المستهلك وأيضا بحيث لا تتراكم تراكيزها في التربة بمرور الوقت الى مستويات تخل سلبا بالمنظومة البيئية الزراعية. كانت تلك محاولة مثالية جميلة لكن ثبت تعذر تطبيقها على أرض الواقع في نظام مفتوح يتبادل المادة والطاقة مع محيطه. على سبيل المثال، يمتص النبات العناصر المعدنية المغذية ويتعاظم انتاجه عند بلوغ تراكيز تلك العناصر مستويات الكفاية Adequacy. ولتحقيق ذلك تحدد كميات ومواقيت إضافة تلك العناصر الى التربة أو الى المحلول المغذي في حالة الزراعات المائية. وبما أن تركيز أي عنصر غذائي في النبات هو محصلة كسر عددي من رقمين، بسطه كتلة العنصر المغذي ومقامه كتلة النبات العضوية التي تتراكم نتيجة التمثيل الضوئي. يتأثر الرقمان كلاهما بجملة من العوامل أهمها درجة حرارة الجو ومستوى رطوبة التربة وجاهزية العناصر المغذية في محلول التربة وفترة وشدة السطوع الضوئي وغيرها من العوامل البيئية التي تحدد مجتمعة قيمة الكسر زيادة أو نقصانا وما يترتب على ذلك من حيود النتيجة عن الرقم المثالي الذي حددت بموجبه مقادير تلك العناصر في التربة. بمعنى آخر، تصبح الزراعة الدقيقة هدفا بعيد المنال لكن يمكن الاقتراب منه بدرجة أو بأخرى. وإذا عدنا الى الأرض، فإنه مهما تطورت أدوات التحكم في بيئة المحصول الزراعي فإن حالات اصطناع البيئة النموذجية لا يمكن تحقيقها بكلفة بسيطة نستطيع عبرها استبدال التربة كوسط طبيعي لنمو النبات ببيئات مائية لعدة أسباب سأسوق أهمها في هذه العجالة:
1. التربة هي الوسط الطبيعي لنمو النبات فهي التي تتحكم في سلسلة من التوازنات الكيميائية بين ما يحصل عليه المحصول من أيونات العناصر الغذائية وبين ما يمكن للتربة أن تعوضه من نقص في تلك الأيونات عن طريق الذوبان أو التبادل الأيوني أو إطلاق الممتزات (Adsorbates) من الطور الصلب الى الوسط المائي. هذه السمة لا يمكن للبيئة المائية أن تقوم به بل نحن من يقنن ذلك عبر تقنيات التحكم الإليكتروني محدود القدرة لأن كل عملية تحكم بحاجة الى مخزون من محلول كيميائي يضاف الى البيئة المائية عند الحاجة وبمقادير تنضبط لتوازنات كيميائية مبرمجة حاسوبيا. وبما أن الحاجات الغذائية متعددة ومتشعبة فستظل أية منظومة مائية عاجزة فيزيائيا وكيميائيا عن تلبية تلك الاحتياجات مجتمعة دون الإخلال بهذه الصفة أو تلك ويهذا القدر أو ذاك من الصفات الحيوية للمحلول كرقم الحموضة أو الملوحة أو التوازن الإليكتروستاتيكي. لذلك يكتفي المطور البشري بالتركيز على السمات الأكثر أهمية عند التدخل في عمليات الضبط الأيوني. من هنا يتوجب استبدال المحلول المائي بين الفينة والأخرى بمحلول طازج وتتحول عملية تصريف المحلول المبتذل ذاك الى معضلة بيئية بحاجة الى حل إبداعي؟ على نقيض المحلول المائي تتميز التربة بمكوناتها المعدنية الصلبة التي تلعب دور المخزون الإستراتيجي لمعظم العناصر الغذائية بل وتتبادل الأدوار بين المكونات الذائبة والأخرى الصلبة في عمليات معقدة تضمن وفرة العناصر الغذائية الميسرة لامتصاص النبات من محلول التربة.
2. هنالك كلفة مادية يتطلبها بناء المنظومة المائية فيزيائيا مثل الهياكل المعدنية والأنابيب ودوائر التحكم الإليكتروني والإضاءة وتصريف المياه المبتذلة والأملاح المعدنية المغذية التي تضمن التوازن الإليكترو ستاتيكي للمحلول المائي وتوفير المياه ممتازة النوعية لإعداد المحاليل المغذية.
3. وبناء على ما سبق فإن كلفة الإنتاج المحصولي في حالة البيئة المائية ستزيد عن تلك المترتبة على الإنتاج المحصولي التقليدي. لكن زيادة الكلفة تلك يمكن تجاوزها اقتصاديا في الحالات التي تتعذر فيها عملية الإنتاج المحصولي محليا لأسباب عديدة كسوء الأحوال الجوية في دول الشمال شتاء أو قسوة الطقس صيفا في دول الصحاري العربية أو ندرة المياه العذبة في تلك الدول على مدار العام. ونظرا للقدرة المالية المرتفعة لبعض تلك الدول، يصبح من المعقول اقتصاديا انتاج بعض المحاصيل هناك مثل المحاصيل الورقية لتزويد بعض الزبائن (مشتريات شركات الطيران على سبيل المثال) بتلك المنتجات وهي حتما غير ملوثة ميكروبيا أي آمنة صحيا عند اعداد وجبات المسافرين دوليا على مدار الساعة. وعلى نقيض المحاصيل الورقية قد يكون من غير المناسب انتاج محاصيل في بيئة مائية بينما يمكن استيرادها بكلف متدنية نسبيا مثل البندورة والخيار. وعلى نقيض المحاصيل السابقة، هناك محاصيل لا يمكن للزراعة المائية أن تنافس التربة في انتاجها اقتصاديا بل قد يكون ذلك مستحيلا في بعضها مثل انتاج الفواكه كالأعناب والبرقوق والتفاح أو محاصيل الحبوب.
عند هذه المرحلة لا يمكننا أن نغفل بعض الجوانب الإيجابية للزراعات في غير التربة الطبيعية والتي تمثل وقائع استثمارية من غير المنطق تجاوزها. مثال ذلك استثمار الأنفاق المهجورة مرحليا والموجودة في بعض المدن الأوروبية الكبرى كبيئات مناسبة لإنتاج أصناف معروفة من الفطر الذي ينمو في أوساط معينة من الزبل أو نشارة الخشب أو استثمار أسطح البيوت لعمل دفيئات زجاجية صغيرة يمكن استثمارها في زراعات مائية لإنتاج المحاصيل الورقية وبعض أصناف الخضراوات لغايات الاكتفاء الذاتي الأسري. هنا تمكن الإشارة الى إمكانية استثمار الهواء الدافئ الخارج من عوادم غرف حارقات الديزل المستخدم في تسخين مياه شبكات التدفئة المنزلية شتاء خاصة إذا علمنا أن مثل ذلك الهواء غني بغاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يعتبر واحدا من متطلبات النمو النباتي والإنتاج المحصولي المرتفع. مثل تلك الترتيبات المنزلية بحاجة الى مبدعين ينحتون فرص عمل ويكتسبون مهارات يحولون بواسطتها موارد مهدورة ضارة بالبيئة الى موارد إنتاجية غير مكلفة.
وبناء على ما تقدم، يمكنني الخلوص الى استنتاج بسيط هو عبثية التعميم فالعقل البشري المنفتح قادر على اجتراح المعجزات. أستذكر في هذا المقام مثالا آخر هو الزراعة العضوية. في هذا الصدد، لا يمكن أن يجادل اثنان بعد مرور أكثر من مائة وخمسين عاما على اكتشاف حقيقة كيفية نمو النبات وحاجته الحيوية الى عناصر معدنية يأخذها من التربة ليكمل بناء جسمه العضوي بعد اختزال ثاني أكسيد الكربون من الجو وانتزاع الهيدروجين من الماء وإطلاق محتواه من الأكسجين الى الهواء الجوي في عملية التمثيل الضوئي من أجل بناء المادة العضوية. يتم عبر هذه العملية تخليق الكربوهيدرات فإذا أضيف اليها النيتروجين والكبريت ينتج النبات البروتين مثلما ينتج بروتينات أخرى بدمج بعض العناصر المعدنية مع الأحماض الدهنية. ما يعنينا فيما سبق هو حاجة النبات الى مقادير ليست قليلة من العناصر المعدنية التي تتوجب اضافتها الى التربة وبانتظام عن طريق الأسمدة الكيميائية لتحقيق غلة زراعية اقتصادية. للتذكير فقط، يشكو العالم هذه الأيام من انخفاض الإنتاج الزراعي بسبب العجز في تزويد العديد من الدول بالأسمدة البوتاسية والنيتروجينية الناجم عن تبعات الحرب الروسية-الأوكرانية. على نقيض تلك الحقيقة، يجادل البعض بأن الرجوع الى الزراعة العضوية هو خيار مثالي. هنا لا بد من التساؤل عن قدرة السماد العضوي على توفير احتياجات أي محصول من النيتروجين أو الفسفور أو البوتاسيوم؟ الإجابة المبسطة هي لا توجد مادة عضوية يمكنها منفردة توفير تلك الاحتياجات. وعليه، فإن الحديث عن الزراعة العضوية هو حديث ترفي ليس بذي فائدة حتى بمنطق الحصول على ثمار غير ملوثة بالأسمدة الكيميائية إذ يمكن تجنب ذلك بإدارة برامج التسميد بطريقة حصيفة تتجنب وفرة النيتروجين في التربة تحديدا للحؤول دون تراكم النيترات في أوراق أو ثمار المحصول الزراعي وما قد يسببه ذلك من تطور مرض الميثوموجلوبينيميا Methemoglobinemia لدى المستهلك والمعروف بالإزرقاق الناجم عن تعطيل وظيفة الهيموجلوبين في نقل الأكسجين من الرئتين الى خلايا الجسم. في هذا الصدد، أنا لا أتجاهل وجود معجبين كثيرين بفكرة الزراعة العضوية يتركز معظمهم بين الفئات الميسورة ماليا وهم لا يمانعون بدفع مال إضافي نظير تجنب احتمال تلوث المحاصيل بالنيترات والمبيدات وربما غيرها من الملوثات غير المتوقعة. بناء على ما سبق، يعوض المزارعون انخفاض الإنتاج برفع الأسعار وهو أمر لا تقدر عليه المجتمعات الفقيرة التي تعاني من نقص الغذاء وبالتالي لا تلتفت الى حديث النوعية ذاك.
يذكرني المثال السابق بنمط آخر من أساليب الزراعة تم الترويج له منذ بضعة عقود هو أسلوب المكافحة الحيوية. يعتمد هذا الأسلوب على إطلاق مفترس طبيعي لآفة معينة غالبا حشرية مما يحد من تأثير تلك الآفة على كم ونوعية المحصول الزراعي. خلال تلك الفترة أصبح الحديث عن المكافحة الحيوية أمرا ذا أهمية قصوى بل أصبح موضوعا للدراسات العليا. وكالمعتاد تحمس العديد من الباحثين لذاك الأسلوب وعرضت في منافذ تسويقية منتجات زراعية لا تدخل المبيدات في مكافحة أفاتها لكنها كانت ذات نوعية أقل جودة من المعتاد وتباع بأثمان باهظة لا يقدر عليها سوى الميسورين جدا من البشر ولنقل من المهوسين بالسلامة الشخصية. وبمرور الوقت، خبى بريق المكافحة الحيوية وعاد الحديث من جديد عن تقنين استعمال المبيدات بل وإنتاج أصناف منها ذات عمر قصير لا يلوث المنتج الزراعي فترة طويلة ليصبح معها ضارا بالصحة العامة أو مستعصيا على الانحلال في بيئة ما بعد الإنتاج الزراعي. ترجمت تلك الطموحات بالإدارة المتكاملة للآفات “Integrated Pest Management” وهي مزيج من الاستعانة بالمفترسات الحيوية لطفيليات النباتات والاستعمال المحدود لمبيدات الآفات عند الضرورة. في الوقت الراهن، ما يزال هناك زبائن من ميسوري الحال جدا الذين يدفعون ثمنا باهظا لمنتوجات زراعية لم تستخدم المبيدات المختلفة في مكافحة آفاتها كالأقمشة القطنية. تشرف على انتاج القطن ذاك (خاصة في الهند) شركات غربية مرموقة في عالم الأزياء والموضة وتسوق أزياءها لزبائن معروفين لها. بالمناسبة، كان مثل تلك الممارسات شائعا أيضا في مصر حيث اشترطت شركات النسيج في مانشستر البريطانية أن تتم مكافحة دودة القطن يدويا لتجنب استخدام مبيدات الحشرات التي تؤثر بالدرجة الأولى على نعومة ألياف القطن، ومن ثم، على نعومة قماشه ومنافسته التجارية. والآن، لكم أن تتخيلوا حجم المعاناة البشرية واسترقاق أطفال المدارس في موسم زراعة القطن لجمع الدودة يدويا لقاء دريهمات هي حتما دون شروى النقير لتحقيق طموحات شركات النسيج البريطانية. كان الدافع وراء تلك الممارسات أحلام بشرية لم تعر المعاناة الإنسانية اهتماما ذا وزن وادعت اهتمامها ببيئة نظيفة تماما أو لم تلتفت الى تأثير متطلباتها على حجم الإنتاج الذي يعني الغالبية العظمى من البشر. تقودنا تلك النهاية وما سبقها من أمثلة الى القول بأن العقل البشري قادر على اجتراح الحلول لكافة المعضلات العلمية والتقنية التي تتحدى بقاءه أو رخاءه لكن، وبالمقابل، علينا أن نتذكر دائما أن بعضا من تلك الحلول قد يتحول الى معضلة كبرى إن اعتمدناها حلولا دائمة وذلك لسبب بسيط هو أن ما نعرفه اليوم أقل كثيرا مما سنعرفه غدا وبذلك فإن معطيات اليوم التي دللنا بمقتضاها على نجاعة الحلول الراهنة قد تبدو ساذجة ومضللة في المستقبل.
أستاذ كيمياء التربة والماء
الجامعة الأردنية