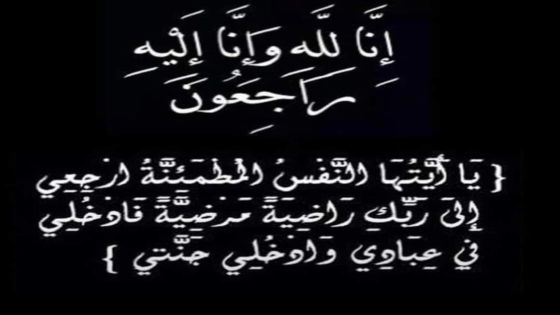الكاتب: د. جواد العناني
هل سيتحول الأردن تدريجياً نحو اقتصاد خدمي مزدهر على غرار ما نراه من تحول في اقتصاديات بعض دول الخليج، وبخاصة دولة الامارات العربية المتحدة، أو دولة قطر؟ هل سيكون هذا من نتاج السير نحو السلام والتطبيع المتوقعين في منطقتنا؟ وهل سيصبح هذا النمط مستقبلاً هويتنا الاقتصادية التي يشكو كثيرون من غيابها، ويطالبون بتأكيدها؟ وهل سنرى في مقبلات الأيام قبولاً لهذا التحول يقوده رجال الأعمال، والصلعان كما يسمي البعض نفراً من المتنفذين من حليقي الشعر؟ وهل سيؤيده كثير من الناس الذين يشتكون من خيبة الحال، وانحباس المطر، وبطالة الأبناء؟ أسئلة برسم المستقبل القريب.
في أعماق كل أردني اصول بداوة وفلاحة، وشظف العيش وقسوته تبقى في ذاكرتهم الدفينة، يحنون إليها إما شوقاً إلى بساطتها أو تذكيراً بنجاحهم في الابتعاد عنها.
لقد عانى الأردنيون الأمرين من أيام القحط المطري، والكساد الاقتصادي في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وحتى في خمسينياته وستينياته. ولما جاءت الهجرة اللبنانية في منتصف السبعينات مكثوا قليلاً ثم غادر كثير منهم بحثاً عن الخدمات الهاتفية والتلكس وغيرهما من وسائل التواصل فلم يجدوها، وبحثوا عن مديرات مكاتب يتمتعن بخدمات سكرتارية عالية فلم يجدوهن، وجابوا الأسواق بحثاً عن مساحات تصلح أن تكون مكاتب متخصصة وصديقة للأعمال فلم يجدوا إلا النزر اليسير منها. ولذلك غادر كثير منهم إلى قبرص، واليونان، ومصر، وحتى فرنسا وسويسرا.
ولكن الخطط الاقتصادية التي وضعت اوجدت مجالات رحبة للاستثمار على مستوى القطاعين العام والخاص، وساعد على ذلك بالطبع وفرة الأموال النفطية، وارتفاع الأجور وزيادة الطلب على التخصصات والخدمات المتطورة، ووفرة السيولة في المصارف المحلية ولدى المستثمرين في القطاع الخاص. فحدثت في الأردن نقلة نوعية متميزة، ولذلك شهد معظم عقد الثمانينات فورة كبيرة خاصة أيام حرب العراق وايران، وانتقلت وتساقطت فوائد النمو على كل الفئات الاجتماعية في مختلف المدن والمحافظات.
ولكن كما قال لي واحد من أعظم الاقتصاديين وقد جلست إلى جانبه في مؤتمر اقتصادي عام 1974، وأنا أدرس للدكتوراة واسمه «توماس فريدمان» من جامعة شيكاغو والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد «اسمع يا ابني.. لا شيء يصعد ويبقى صاعداً ولا شيء يهبط ويبقى هابطاً، الحياة دورات والذكي من يتوقف عندما يصل السوق إلى قمته، والمحظوظ من يبدأ في الاستثمار قبل الانطلاقة في دورة صاعدة. وقد بقيت هذه الكلمات عالقة في ذهني، ووجدت فيها على بساطتها حكمة. ولو أضفنا إلى هذه الكلمات الجوانب النفسية والسلوكية التي دخلت علم الاقتصاد بقوة، وفاز العاملون عليها بخمسة جوائز نوبل في الاقتصاد خلال الأعوام السبعة الأخيرة، لتذكرنا منتهى الحكمة الإلهية في قوله سبحانه وتعالى في سورة المعارج «إن الانسان خلق هلوعا* إذا مسّه الشر جزوعاً* وإذا مسه الخير منوعاً* الآيات (19-21). فالانسان هلوع ويحب المال حباً جماً، وإذا تغيرت حياته وابتلي بنقص في الأموال وقع في الخوف والجزع، وإذا منح نعمة من ربه ظن بها فلا يكرم إلا بالطبع المصلون الذين يخافون الله ولهم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
ولنعد بالتاريخ إلى النصف الثاني من القرن الثاني عشر، حين ابتليت بلاد العرب والمسلمين بالغزو الأوروبي المتوشح برداء الدين، والذي بدأ في نهاية القرن العاشر بحملة بطرس الناسك. ولكن الحملات توالت حتى سقطت القدس بأيدي الصليبيين. ولكن في عام 1187 ميلادية، قاد صلاح الدين الأيوبي جيوش العرب بمسلميهم ومسيحييهم وبالكرد والشركس والترك الذين كانوا معه فانتصر انتصاراً ثانياً في معركة حطين، وتمكن بعدها من استعادة القدس.
وقبل تلك المعركة بقرن من الزمان، وقعت المعركة الخالدة في المغرب العربي. فقد قاد الاسبان القشتاليون جيشاً لاحتلال واحدة من أجمل مدن الأندلس وأكثرها في ذلك الوقت ازدهاراً وتطوراً، وهي مدينة اشبيلية. وقد حكمها في ذلك الوقت ملك شاعر اسمه أبو القاسم المعتمد على الله بن عباد ولقب بالظافر وكذلك بالمؤيد، وذلك لأنه خاض حروباً كثيرة ضد الاسبان وملوك الطوائف الأخرى وأحياناً مع الأمازيغ (البربر) في شمال افريقيا، ولذلك غلب عليه لقب المؤيد بالله. وفد توسعت رقعة مُلْكِه فشملت إلى جانب اشبيليه كلاً من قرطبة والجزيرة الخضراء ومرسيه. ولكنه كان يحب الحياة وملذاتها، ويقرض الشعر الناعم الرائع. وهذه هي السمعة التي اشتهر بها. ومع أنه أحب زوجته المعروفة باسم اعتماد الزميكية إلا أنه أحب زوجاته وجارياته الأخريات وتغزل بهن. وقد نشر ديوانه في مصر وقد جمعه كل من الدكتور حامد عبدالمجيد والدكتور أحمد أحمد بدوي وراجعه الدكتور طه حسين.
ولما هاجم القشتاليون بجيش عرمرم مملكة اشبيليه، استغاث بأمير المرابطين الذين كانوا يعيشون عيشة خشنة صحراوية لا تخلو من الجدب أحياناً وشظف العيش في معظم الأحيان، فَهَّب ابن تاشفين لنجدة أخيه في الاسلام، ودارت معركة شهيرة اسمها معركة «الزّلاقة» عام 1086م. ونجح فيها ابن تاشفين في كسر شوكة الاسبان في ذلك الوقت. ولما رأى الرفاه والعز الذي يعيش فيه المعتمد بن عباد، جنّ جنون ابن ثاشفين وقال له كيف لا تدافع عن كل هذا النعم وتنغمر في ملذات الحياة والخطر محدق بك، وتستعين بي أنا الذي أحيا حياة الضنك والمعاناة في الصحراء الجديبه. ونقله معه إلى المغرب، حيث لم يتحمل بن عباد مذلة الأسر وهوانه على خلق الله فمات ودفن هناك في نفس العام.
ويتذكر الناس عادة ما جرى في الأندلس بعدما انتهت الخلافة الأموية فيها، وصارت كل مدينة دولة مستقلة بذاتها ويحكمها ملوك الطوائف. ورغم أن حياتهم لم تكن بالبساطة التي يحكم الناس بهم عليها وينسون أن الاندلس كانت منطقة معزولة داخل أوروبا، وما كان لها لتعمر طويلاً، ولكن قصة انهيارها والحروب التي دارت بين أطرافها هي ما بقي في الذاكرة التاريخية البسيطة، ونسي الناس ما كان لبعض هؤلاء من إنجازات كبيرة، كما حصل مع ملوك بني عباد الثلاثة.
واتذكر في إحدى رحلاتي إلى الراحل الحسين العظيم، في «مايو كلينيك» أنه سألني سؤالاً صعباً جداً اقلقني، قال يا أبو احمد ما الذي تعتقد أن التاريخ سيتذكرني به؟ فقلت له يا سيدي التاريخ سيتذكرك بأنك رجل همام شجاع كريم شهم، محارب، عادل منصف بدون صغائر. فقال وفي قلبه غصة وفي عينيه دمعة مخنوقة «أخشى ما أخشاه أن يتذكرني التاريخ بأنني الملك الذي خسر القدس» وصدمتني عبارته إلى حد أنني اطرقت رأسي وتراخت يداي على خاصرتي، وانفلتت افكاري كالجِمال السارحة في البوادي. ولملمت شتاتي «سترجع القدس يا سيدي» ولذلك تراني شديد الأمل بالملك عبدالله الثاني وأنا أراه يتمسك بناجِذيْه ويديه وبكل ما أوتي من قوة وايمان بالوصاية الهاشمية على الأقصى والأماكن المقدسة.
ولكن وقع الحياة غريب، ويأخذنا في دروب لا ندري أحياناً إلى أين تقودنا، ولا إلى أي نهايات توصلنا. ونحن نبدو وكأننا نعيش تراجيديا يونانية، حيث يبذل أبطالها كل ما لديهم من عزم وتصميم لكي يفلتوا من قدرهم، فلا يستطيعون.
ولكن التراجيديا لا تصبح كذلك إلا عند خواتيمها، وأصحاب الايمان لا بد لهم من تغيير الخواتيم لأن الله يحب هؤلاء ويمنحهم الرشاد والبصيرة. ولكن وسط هذا التنقل بين التراجيديا والقدرة على تغيير الخواتيم نقف متسائلين عما يحصل معنا، وما الذي نحن سائرون إليه.
صحيح أن القوة لها جانبان. جانب ناعم يتمثل في الاعداد الصحيح للقوى البشرية، وبالملكات الإبداعية الخلاقة، وبالخُلُق والثقة الممكنة من مواجهة الطوارئ والمستجدات، ومن المرونة التي تفتح أمامنا البدائل والمغلقات من الوسائل حتى نتكيف مع المستجدات ونقتحم الصعاب. وهناك القوة الخشنة التي نحن بحاجة إليها، مثل الجيش، والمخابرات والأمن العام. واجتماع القوتين أمر ضروري.
ولكن القوة الناعمة في عَصْر الذكاء الاصطناعي والحسابات الرقمية والكمبيوترات الجبارة فائقة السرعة تتطلب نوعاً مختلفاً من الرجال والنساء. وليس صدفة أن معظم هؤلاء، وبغض النظر عن لحاهم وصلعهم، وحجاباتهم أو بنطلونات الجينز الممزقة عند الركب، فهم يميلون للانطلاق المرتبط عادة بالابداع والمعتمد على قدرة هؤلاء على الخروج عن المألوف والشائع من السلوك، والذي يسميه التقليديون الخروج عن التقاليد، وأحيانا عن التراث.
هل نحن بحاجة إلى مزيج من الاثنين؟ الجواب نعم. فيجب علينا أن نتنعم، وأن نتخوشن، وأن نحسب في أيام الرخاء لأيام الشدة، وأن أهل التجربة في الأندلس مثل الشاعر أبو البقاء الرندي يذكرنا بأن هذه «هي الدنيا كما شاهدتها تحول، من سَرَّه زمن ساءته أزمان». ومن قال إن الأصلع أو طويل الشعر «الهيبي» لا يكون عنده استعداد للقوة.
علينا أن نخرج من القوالب الثابتة في الحكم على الناس، ومن غير المعقول أن تمدح الشيخ عبدالله النديم خطيب الثورة العرابية لأنه رفض تغيير لفته وَحبَّتَه لمقابلة السلطان حسين كامل، ثم ننفر من شخص يرتدي ملابس عادية حسب مقاييس هذا اليوم، يمكن اعتبار الصحابيين أبي ذر الغفاري وأبي هريرة من الهيبيز حسب ما وصفه المحدثون عن ملابسهما الرثه، بينما وصف أغنياء الصحابة بالأناقة أو بالاسراف حكماً عليهم من الملابس التي يرتدونها.
نحن الآن أمام قضايا أكبر. ومن الواضح أن الأردن قد بدأ يتخذ خطوات نحو تعزيز السلام مازجاً بين الأسلوبين الناعم والخشن. فنحن مازلنا نبني الجيش، ونفكر في المثل والدروس التي ندربهم عليها ونريد زراعتها في كل جندي نشمي منهم. وهي الشجاعة، والبسالة، والانضباط، والانتباه للتفاصيل في الأكل والملبس والكلام والحرب وحفظ الأمن. وبالمقابل، نريد سنداً لهؤلاء جيوش القوى الناعمة من الشباب القادر بوعيه، وعلمه، وانطلاقه، وعدم رؤيته للمحددات، وبصيرته النافذه إلى الآفاق، أن يكون مبدعاً ومتحرراً في حدود المعقول من قيودنا ولكنه مخلص لوطنه، ويتفانى في خدمته بالطريقة التي يعرفها.
ولعل قواتنا الخشنة تستطيع الاستفادة أكثر من القوى الناعمة في هذا العصر. وحتى نمزج من بين الاثنين، فعلينا أن نبني انموذج اقتصادنا على تلك الأسس: ابداع في التعليم، والصحة، والإنتاج، وإدارة الموارد، وبناء سلاسل التزويد، والانتقال للحكومة الالكترونية، وتطوير مهاراتنا الدفاعية بالرقمنة والذكاء الاصطناعي المتفوق. وكل هذه الأهداف تتطلب مناخاً آمناً مستقراً.
البعض يرى أن العالم العربي بحاجة إلى سنوات من السلام والتآلف حتى ينفك أعداؤه عنه. هنالك أناس يؤمنون أن البناء والتطوير وخلق القدرات الإبداعية هو السلاح الأمضى على المدى الطويل. ولكن هل يكفي هذا المنطق بحد ذاته لكي نقبل بأن نحيد الغرب وإسرائيل عن طريق الوصول إلى سلام حقيقي يؤمن للفلسطينيين حقوقهم، ويقول للعالم أن منطقتنا أقدر على أن تحيا حياة كريمة في ظل السلام، أم ان استمرار حالة عدم الاستقرار، والتشتت العربي، وخوض المعارك الخاسرة هو الأجدى؟
أمامنا طرق ثلاث: الأولى أن نقدم البناء والاعمار والإنتاج وأمان الناس، وهذا بحاجة للتعاون مع العالم واحترام القوانين المحلية والدولية، والانخراط في المنظومة الدولية، والابتعاد عن الحروب والفتن والاكتفاء بالاستعداد للدفاع عن النفس بدلاً من شن الحرب.
أو أن نختار شظف العيش، والعودة لحياة التقتير والابتعاد عن كل ما هو دنيوي، وقبول رفض العالم لنا ونكون أقرب إلى ما يطلبه البعض منا من أن ننأى عن الانخراط في الحياة.
أو أن نؤمن بالتوازن. سلام قائم على الندية واسترجاع الحقوق، وبناء قوة ناعمة تدعم القوة الخشنة عندما تتطلب الظروف ذلك، وانفتاح على الجميع حتى نبقى معهم في علاقات ود وتوازن نستفيد منهم ويستفيدون منا، ونصمم في الوقت ذاته على حقوقنا كاملة في الأراضي المحتلة والقدس حتى ننالها طال الزمان أم قصر.
أي حل نختاره له صعوباته وتحدياته. ولكن الحكمة هي الرائد في كل ما نفعل. نحن بلد يكره إراقة الدماء، وموت الأطفال، وقطع الأشجار، ولدينا نظام هاشمي إنساني له بصيرة متقدمة والبديل الثالث هو ما نريد. ويجب أن نعمل له ونشتغل من أجل تحقيقه. ودعونا من السلبيات وبث السموم.