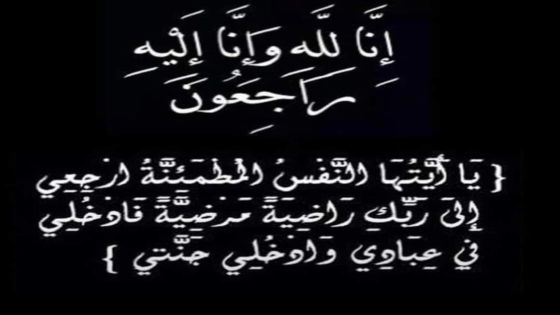حسين الرواشدة
أغلبية الأردنيين لا يثقون بالعملية السياسية، ربما، هذه نتيجة طبيعية أفرزتها ظروف وعوامل وتراكمات قديمة ومستمرة يطول شرحها، وهي -بالطبع- ليست مفاجئة لكنها صادمة، وتستحق أن نتعامل معها بمنطق الاعتراف والمكاشفة، ثم التوافق على ما يلزمها من معالجات.
يشير آخر استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية إلى أن نحو 69 % لا يثقون بـ”لجنة تحديث المنظومة السياسية” و68 % غير متفائلين بمخرجاتها، على الرغم من أن 47 % منهم لا يتابعون أخبارها، هذه” الكتلة الشعبية” تمثل واقعياً نسبة الأردنيين الذين عزفوا عن الاقتراع في صناديق الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كما تعكس أيضا، وبالأرقام ذاتها تقريبا، اتجاهات ثقة الأردنيين بالحكومات والمجالس البرلمانية المتعاقبة، وما يجري من تعديلات على الحكومات، أو ربما بكل ما يتعلق بحركة السياسة في بلدنا.
يمكن فهم هذه النتيجة في سياقين أساسيين؛ الأول يتعلق بحالة المجتمع الأردني ومزاجه العام، وما طرأ عليه من إصابات وتحولات، وما تعرض له من ضغوطات، تسببت في إنتاج منظومة من القيم السلبية (منها فقدان الثقة)، ثم صناعة ما يشبه الرأي العام حول مختلف القضايا والأزمات، وربما اللجان والمقرارات، وهذه كلها، سواءً انعكست على السلوك الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي، شكلت أغلبية من المتشائمين والمنسحبين من المشاركة في العمل العام، أو المشككين فيه أو غير المهتمين، والشامتين به أيضا.
أما السياق الثاني فيتعلق بسلوك مؤسسات الدولة، سواء في علاقتها مع المجتمع أو مع بعضها بعضا أو مع توصيات اللجان التي سبق وشكلتها، لا أتحدث فقط عن الحكومة والبرلمان وعموم المسؤولين، وإنما عن التغيرات التي حدثت على صعيد قيم الدولة ووظيفتها، وما تملكه من لواقط “وحساسات” سياسية، هذا السلوك الذي قد يكون مفهوما في إطار ما جرى داخليا وإقليميا ودوليا من تحولات واستحقاقات أثرت على بلدنا، إلا أنه أفرز من الأردنيين مزيجا من حالات الرفض والانتقام والإحساس باللاجدوى، وعدم الثقة والخوف من المستقبل وعليه.
هذان السياقان، السياسي والاجتماعي، تصادف وجودهما بالتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة، تصاعدت مع قدوم “الوباء”، وألقت بأثقالها على مزاج الأردنيين وعلى سلوك الدولة، لدرجة أن أولوية المواطن أصبحت اقتصادية بامتياز، وأن الإصلاح السياسي -على أهميته- يأتي في المرتبة الثانية بعد الإصلاح الاقتصادي (حسب استطلاعات الرأي)، كما تصادف حضورهما مع مرور بلدنا بأزمتين (فتنتين إن شئت)، اشتبك فيهما السياسي مع الاجتماعي، وتقرر للخروج من صدمتهما تشكيل “لجنة التحديث السياسي” باعتبارها مدخلاً لمرحلة جديدة، أو وصفة لفك هذا الاشتباك.
في إطار ذلك، ظلت المناخات العامة التي أفرزتها الحالة السياسية كما هي، ولم تتغير، إذ بينما كانت لجنة التحديث تبشر بتشريعات لمرحلة سياسية غير مسبوقة (حكومات وأحزاب برلمانية وإصلاح سياسي) كانت المؤسسات الرسمية تعمل كالمعتاد، ولم تتوجه لتطمين المجتمع أو تهيئته لهذه المرحلة بمقررات تسهم في تخفيف الأزمات التي يعانيها، سواءً على صعيد أزمة الموظفين المحالين للاستيداع والتقاعد المبكر، أو الموقوفين على قضايا غير جنائية، ما عمق لدى المزاج الشعبي إحساسا بأن اللجنة مجرد “جزيرة” معزولة وأن مخرجاتها ستبقى كذلك.
ما ذكرته سلفاً كان مجرد فهم لما حدث، أما سؤال العمل فيحتاج إلى مزيد من الصراحة والجدية، ومع أنني أدرك تماما أن ثمة إرادة سياسية حاضرة هذه المرة باتجاه تغيير سلوك الدولة، والسير قدما في عملية التحديث، وفقا لمخرجات اللجنة تحديدا، إلا أن ما أخشاه هو أن “يتمنع” المجتمع عن قبول هذه التحولات بحجة افتقاده الثقة بها، وبمن يتولى تنفيذها.
وهنا يفترض أن يتحرك الجميع لترميم هذه الثقة، أو “تسليفها” على الأقل، ليس فقط من خلال الترويج لمخرجات اللجنة وتحسين صورتها، وإن كان ذلك مجرد “باروميتر” يقتضيه واجب الوقت، وإنما بتعديل منهجية وحركة العملية السياسية والاقتصادية معا، بكل ما يستدعيه ذلك من سياسات ومناخات مقنعة ومؤثرة في حياة الناس، وهي مهمة قد تبدو صعبة، لكنها ممكنة ولا يجوز الاعتذار عنها، أو التباطؤ في تنفيذها تحت أي ذريعة.