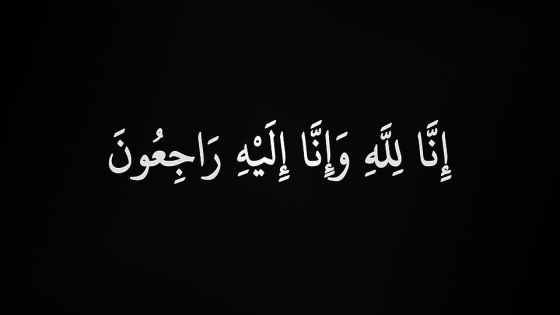وطنا اليوم – عاشت الهوية الأردنية الحديثة على ميراث الثورة العربية الكبرى، وعلى المكانة الخاصة للأسرة الهاشمية ودورها في تأسيس إمارة شرق الأردن ثم المملكة الأردنية الهاشمية. لكن هذه الهوية سرعان ما استقرّت على شكل متدامج ومتنافر في الوقت نفسه، هو ثنائية الأردني – الفلسطيني، خصوصًا بعد وحدة الضفتين، الشرقية والغربية، في عام 1950. ثم راحت تعبّر عن نفسها أحيانًا بطريقة فلكلورية مسلية أَكان ذلك في الطعام أو غطاء الرأس أو حتى الرياضة كالتنافس بين ناديي الوحدات الفلسطيني والفيصلي الأردني، أو اعتمار الكوفية ذات اللونين الأسود والأبيض في مقابل الشماغ الأحمر والأبيض من طراز “أبو الشراشيب”، أو المنسف في مقابل المسخّن والمقلوبة. ولشديد الأسف، صارت تلك الثنائية الطبيعية مدعاة للخوف، أحيانًا، لدى بعض الشرق أردنيين كلما سمعوا كلامًا إسرائيليًا عن “الوطن البديل” أو “الخيار الأردني”، وكلما تضاءل حلّ الدولتين في فلسطين. وقد حاولتُ أن استقصي وجود تلك الثنائية في مذكرات مضر بدران الموسومة بعنوان “القرار” (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2020) فما عثرتُ على ملامحها ألبتة، وهذا مفهوم، ما دام صاحب المذكرات التي قدّم لها خالد الكركي، من أصول فلسطينية نابلسية، ووالدته شامية وزوجتة شامية أيضًا، ووالده كان قاضيًا في حمص، وهو نفسه درس في الشام وتخرّج في جامعتها. ونابلس، كما هو معروف، هي “دمشق الصغرى”، ومعظم عائلاتها مثل آل النمر وطوقان ويتحدّرون من حماة وجوارها. وقد عثرنا على اسم والدة مضر بدران فريزة المولا (باللام ألف)، لكننا لم نعثر إلا على الاسم الأول لزوجته، وهو مؤمنة، وكنيتها “أم عمّار”، فكأننا نقرأ على الطريقة المصرية التي تكتفي بعبارة “حرم دولة رئيس مجلس الوزراء”، من دون ذكر اسمها الشخصي، وفي هذا محو للفردانية. ومع ذلك عثرنا، مصادفة، على اسم عائلة زوجته (السرايجي) في الصورة المنشورة في الصفحة 411، ففككنا عقدة تجهيل اسم عائلة زوجته. ومهما يكن الأمر، فليس في هذه المذكرات أيديولوجيا أو “فلسفة” أو “فذلكة”، فلا الثورة العربية الكبرى حاضرة، ولا الهاشميون يتلألؤن إلا كإشاراتٍ عابرة هنا وهناك. وحده الملك حسين يحظى بالحضور الكلي، وحتى المذكرات نفسها تتوقف عن الكلام والبوح مع وفاة الحسين في 27/2/1999.
كيف تمكّن من زيارة سيناء قبل حرب 1973، وكانت محتلة بتمامها وكمالها حتى قناة السويس؟
كان يُقال في الأوساط السياسية العربية إن الملك حسين إذا أراد أن يحسّن علاقته بسورية يجعل زيد الرفاعي رئيسًا للوزراء، وإذا أراد أن يحسّن علاقته بالعراق يجعل مضر بدران رئيسَا للحكومة. ومن غير الممكن وضع علامةٍ مدرسيةٍ تفضيليةٍ لهذه المقولة مثل العلامات التي يضعها معلمو المدارس لطلابهم. ولكن مضر بدران، كما يبدو في المذكرات نفسها، قومي عربي، ولعله تأثر ببعض أفكار القومية العربية في أثناء دراسته في دمشق. ولاحقًا كان شاهدًا على هزيمة عام 1967، وعلى ظهور المقاومة الفلسطينية المسلحة ومعركة الكرامة وغيرها. وفي هذا الميدان، لم يتحرج في الإفصاح عن رأيه بشأن ما سُمّي “الربيع العربي” فيقول إن ذلك الربيع “بلغ مستوى المؤامرة على سورية الموحدة” (ص 360). وبدران اتخذ موقف الرافض لزيارة أنور السادات القدس ولمفاوضات كامب دايفيد ولاتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية، وكان معارضًا لمعاهدة وادي عربة من غير أن يعلن ذلك (ص 343) (هل الكتمان في هذه الحال يساوي التأييد؟). وقد استقال من رئاسة الحكومة الأردنية في عام 1991 لأنه كان يرفض المشاركة في التفاوض مع إسرائيل، وكان يعلم، علم اليقين، أن اسرائيل لن تلتزم أي اتفاق سلام، وأن أميركا لن تضغط عليها من أجل اتفاق سلام مع العرب (ص 342). وفوق ذلك، في جنازة الملك حسين، لفته عدنان أبو عودة إلى أن شيمون بيريز يفتش عنه كي يلقي السلام عليه، فهرب حتى لا يصافحه (ص 355).
الانسحار
مضر بدران أحد ثلاثة عملوا على تطوير الوحدة الأردنية الداخلية، وعلى تحديث الإدارة وتنمية الاقتصاد ومكافحة الفساد. والثلاثة هم عبد الحميد شرف ومضر بدران وأحمد عبيدات. والثاني والثالث توليا إدارة المخابرات العامة. والمعروف أن أكثر الأشخاص ليونةً في الأزمات السياسية ليس السياسيون، بل رجال المخابرات الذين يعرفون الواقع الحقيقي جيدًا، ويعرفون ما يجري في ثنايا المجتمع، خلافًا للسياسي الذي يُغلّب الخطاب التعبوي والشعبوي والأيديولوجي على المعالجة الصحيحة للمشكلات. ومع ميوله القومية الخفيفة، إلا أنه كان غارقًا في حب الملك حسين، ومغرمًا بوصفي التل. وقد يبدو ذلك أمراً معتادًا في الأردن، لكن الصورة من خارج الأردن ليست على مثل هذا البهاء ألبتة. فهو يصف الملك حسين بأنه “أسطورة لا تتكرر” (ص 354). صحيح أن الملك حسين كان لاعبًا ماهراً، واكتسب خبراتٍ مهمة لم يتسنَ لأي زعيم عربي آخر أن يكتسيها جراء طول مدة حكمه، لكنه لم يكن أسطورة على الإطلاق، وثمة فارق هائل بينه وبين جمال عبد الناصر، ومع ذلك نحن لا نسمي عبد الناصر أسطورة، بل زعيم عربي نادر. وكل ما في الأمر أن الملك حسين كان أحد الحكام العرب الذين أقاموا طويلاً في عروشهم، فاكتسبوا خبراتٍ جمّة، وتعلموا كيف يتعاملون مع موازين القوى، وفهموا إكراهات الواقع، وأتقنوا فنون المناورة بين المتناقضات والسير في حقول الألغام، أو بين حبال المطر، لكن هذا الانسحار بالملك حسين عجيب غريب، حتى أن بدران كان يدعو الله أن يميته قبل الحسين. وفي جميع صفحات الكتاب لم يرد اسم “الملك حسين” ألبتة بل كان اسمه يرد بصيغة “الراحل الحسين”. ولا ريب أن للملك حسين مزايا كثيرة قرّبته من شعبه، وهو أيضًا أتقن فن التواصل بالأردنيين، قبائل وعائلات وسياسيين وتجار ومثقفين. والصفات الفردية هذه كانت جزءًا من صناعة الصورة كقيادات السيارات السريعة والطائرات والتزلج على الماء والثلوج … إلخ. وهذا كله مشغول بدقة، كي يتسرب التأثير إلى سريرة كل شخص، وحينذاك سيجد مضر بدران في الملك حسين أسطورة. ومن مرصدي هنا، خارج الأردن، لم أرَ في الملك حسين لا أسطورة، فالمسلك السياسي للملك كان مندغمًا بالسياسات الغربية، خصوصًا البريطانية ثم الأميركية، وبالتحديد في ذروة صعود حركة التحرّر القومي العربي بزعامة جمال عبد الناصر. ويُسجل للملك حسين في تلك الأثناء أنه حوّل عمان إلى بؤرة للعمل الاستخباري ضد الوحدة المصرية – السورية، وجنّد لهذه الغاية العميد فيصل سري الحسيني وشقيقه أكرم سري الحسيني وحيدر الكزبري قائد قوات البادية في سورية، والعميد موفق عصاصة، ومعهم خلوصي الكزبري ومأمون الكزبري وعبد الغني دهمان، وهؤلاء هم أركان الانقلاب على الوحدة وبيادق المخابرات الأميركية والبريطانية التي كان رجل المخابرات السعودية، كمال أدهم، يسخو عليهم بالأموال أيما سخاء.
مضر بدران أحد ثلاثة عملوا على تطوير الوحدة الأردنية الداخلية، وعلى تحديث الإدارة وتنمية الاقتصاد ومكافحة الفساد
وحين لاحت فرصة للتقارب العراقي – السوري بعد أكتوبر/ تشرين الأول 1978 مع توقيع اتفاقية كامب دايفيد، وأحس عرب كثيرون بإمكان تعديل موازين القوى، ولو قليلًا، لتعويض خروج أنور السادات من الصراع العربي – الاسرائيلي، أرسل الملك حسين، في مطلع عام 1979، مبعوثًا إلى صدّام حسين، وكان هذا نائبًا لرئيس الجمهورية العراقية أحمد حسن البكر، ليبلغه أن مجموعة من خمسة أشخاص في مجلس قيادة الثورة اتفقوا مع الرئيس حافظ الأسد على إنجاز اتحاد عراقي – سوري يكون البكر رئيسًا للجمهورية الجديدة، وحافظ الأسد نائبًا للرئيس، ومنيف الرزاز أمينًا عامًا للحزب بدلًا من ميشال عفلق. وبناء على هذه المعلومات غير الصحيحة، بادر صدام إلى الفتك بالمجموعة الخماسية، فأعدمهم، وهم: عدنان الحمداني ومحمد محجوب وغانم عبد الجليل ومحمد عايش ومحيي المشهداني، وتولى السلطة في 16/7/1979 بعدما أرسل أحمد حسن البكر ومنيف الرزاز إلى منزليهما. أما لقاءات “الملك الأسطورة” مع القادة الاسرائيليين فتحتاج مجلدًا لتدوين وقائعها التي بدأت، بحسب المعروف منها، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1970 حين جاء الملك من قصر الحمر بطائرة عمودية، ووصل يغآل ألون بطائرة عمودية أيضًا من مطار بير السبع، والتقيا في نقطة تقع بين إيلات والبحر الميت، وكرّت السبحة، فاعترف الملك حسين نفسه لمحطة BBC في مايو/ أيار 1998 بأنه التقى غولدا مئير في 25/9/1973، وأخبرها أن القادة العسكريين السوريين الكبار قد أصبحوا في غرف العمليات، وعلى الأرجح سيشنون حربًا مع مصر على إسرائيل (يوري بار يوسف، الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2017، ص 210)، ثم التقاها في 4/10/1973 ليحذّرها من أن المعركة ستقع خلال يومين. وفي السياق نفسه، يذكر صديقه، الوزير ورئيس الديوان الملكي الأسبق، عدنان أبو عودة، أن وكالة رويترز بثت خبرًا، نقلاً عن محطة NBC، عن لقاء عقده الملك حسين ورئيس الحكومة الأردنية في حينه، زيد الرفاعي، مع غولدا مئير ويغآل ألون وشلومو غازيت في وادي عربة في مايو/ أيار 1974 (راجع: يوميات عدنان أبو عودة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017، ص 163)، وهذا غيض من فيض اللقاءات المتكرّرة مع القادة الأمنيين والعسكريين الاسرائيليين مثل اللقاء مع موشي دايان في لندن في أغسطس/ آب 1977.
وأثار دهشتي حقاً أن يكتب مضر بدران: “كيف لي أن آتي [رئيساً للوزراء] بعد وصفي التل الذي كان “طافِفْ” على الكرسي [أي انه أكبر منها بكثير]. فأنا لا أغطي يد الكرسي الذي يجلس عليه وصفي” (ص 136). ويعترف بدران بقلة معلوماته عن اغتيال وصفي التل أمام فندق شيراتون في القاهرة في 28/11/1971 بالقول: “بقي السؤال الذي يحيرني عن ضعف حراسة وصفي في فندق الشيراتون من قبل الجهات الأمنية المصرية بلا إجابة” (ص137). ولو! بعد تسع وأربعين سنة على الاغتيال، ولا زالت تفصيلات ذلك الحدث تحيرك، وأنت رجل استخبارات في الأساس، ورجل سياسة في المراس؟
تصويبات لا بد منها
1- يقول صاحب المذكرات: “أُطيح بأديب الشيشكلي بعد أن اندلعت مظاهرة من قلب جامعة دمشق […] وكان رئيس الجامعة في ذلك الوقت مؤسس حركة القوميين العرب قسطنطين زريق. وبعد أن دخلت الشرطة العسكرية [إلى حرم الجامعة] بدأ إطلاق النار غزيرًا، ووقعت إصابات واستشهد بعض الطلبة” (ص 52). ويضيف: “علمتُ بعد أن انتهت تلك المظاهرة الفاصلة، والتي أدت إلى أنهاء فترة حُكم رئاسة الشيشكلي لسورية أن من نفذها اليساريون […] وأن أربعة طلاب قُتلوا في تلك المظاهرة وجُرح المئات، وتعطلت الجامعة عشرة أيام” (ص 53). والمشهور الصحيح في تاريخ سورية المعاصر، ومنها تظاهرة جامعة دمشق تلك (وهي واحدة من تظاهرات كثيرة كانت الجامعة ميدانها الدائم) أن تلك التظاهرة اندلعت في عام 1952 للاحتجاج على تجفيف بحيرة الحولة في فلسطين. أما الشيشكلي فقد سقط في عام 1954، أي بعد عامين. إذاً لم تكن تلك التظاهرة هي الفاصلة على الاطلاق. إن الذي أجهز على حكم أديب الشيشكلي هو تمرّد النقيب مصطفى حمدون في 24/2/1954 الذي انضم إليه معظم ضباط الجيش السوري. وفي مساء اليوم نفسه، غادر الشيشكلي دمشق إلى بيروت، وفي 26/2/1954 أعلن تخليه عن الحكم. أما قسطنطين زريق فليس هو مؤسّس حركة القوميين العرب، بل المؤسس هو جورج حبش ورفاقه أمثال وديع حداد وصالح شبل (من فلسطين) وهاني الهندي (من سورية) وأحمد الخطيب (من الكويت) وحامد الجبوري (من العراق)، وهؤلاء اتكأوا على كتابات قسطنطين زريق، وأفكاره القومية التي كان يبثها في الجامعة الأميركية في بيروت من خلال جمعية العروة الوثقى. والذي أسقط الشيشكلي هي “الجبهة الوطنية” المعارضة للشيشكلي المؤلفة من حزب البعث وحزب الشعب والحزب الوطني والأخوان المسلمون (عدا الحزب السوري القومي الاجتماعي) والحزب الشيوعي، وشخصيات من عيار سلطان الأطرش وهاشم الأتاسي. وهذه الجبهة هي التي عقدت مؤتمرًا في حمص أعلنت فيه هدفها، وهو إسقاط دكتاتورية الشيشكلي. ثم جاء تمرّد الضابط مصطفى حمدون في السياق نفسه، ليدق آخر مسمار في نعش استبداد الشيشكلي. والمعروف أن جرحى سقطوا في تلك التظاهرة، لكن ليس بالمئات، ولم يسقط فيها قتلى. أما إغلاق الجامعة، فلم يتم بعد تظاهرة 1952 المشار إليها، بل بعد تظاهرة أخرى لها صلة بالانتخابات الطالبية. وقد صدر قرار إغلاق الجامعة عن الحاكم العسكري. ومن شهود التظاهرة التي تعرّض فيها قسطنطين زريق لبعض اللكمات الطالبان ممدوح رحمون وجودت البارودي (ممدوح رحمون، محطات على درب الحياة، دار النفائس، بيروت، 2005، ص 389 و390). وقد حدثني قسطنطين زريق نفسه عن تلك الحادثة، في أحد لقاءاتنا الكثيرة في مؤسسة الدراسات الفلسطينية حين كان رئيسًا لمجلس أمنائها، وكتبت ذلك في غير مقالة عنه (راجع بعض مقالاتي عن زريق في ملحق فلسطين، الصادر عن صحيفة السفير 15/5/2013)، وفي الملحق الأدبي لصحيفة النهار (18/8/2002)، وفي مجلة “الحوار” اللبنانية (19/8/2000).
بعد تسع وأربعين سنة على اغتيال وصفي التل، لا زالت تفصيلات الاغتيال تحيّرك، وأنت رجل استخبارات في الأساس، ورجل سياسة في المراس!؟
2- يقول مضر بدران: “في سنة 1968 دخلت قوات إسرائيلية إلى سيناء، واستولت على الرادار المصري الموجود هناك وعادت إلى ميناء إيلات” (ص 94). والحقيقة أن سيناء كلها كانت قد احتلتها إسرائيل في 5/6/1967، ومن المحال أن يكون فيها رادار مصري. والراجح عندي أنه يقصد عملية سرقة إسرائيل الرادار المصري في رأس غارب الذي يبعد 300 كلم غرب قناة السويس، ونقله إلى إسرائيل مع أربعة جنود مصريين في 27/12/1969. ولهذه الحادثة قصة مؤلمة، فقد عمد قائد الموقع المصري، بعد نجاح عملية التسلل الإسرائيلية، إلى وضع متفجرات في محطة الرادار ونَسَفَها، ثم اتصل بقيادته، زاعمًا إن الإسرائيليين هاجموا الموقع، وأنه تصدّى لهم، لكن القوة الاسرائيلية المهاجمة تمكّنت من تدمير الرادار. غير أن صحيفة دايلي إكسبرس البريطانية كشفت الأمر في 3/1/1970، وأرسل السفير المصري في لندن المقالة إلى وزارة الخارجية التي أحالتها إلى الرئيس جمال عبد الناصر.
3- يورد المؤلف أنه “زار مواقع في سيناء قبل حرب العام 1973، واطلع على جانبٍ من مخطط الجيش المصري للمواجهة” (ص 153). ويبدو أنه خلط الأمكنة، مثلما خلط التواريخ أحيانًا. فكيف تمكّن من زيارة سيناء قبل حرب 1973، وهي كانت محتلة بتمامها وكمالها حتى قناة السويس؟
4- يذكر مضر بدران أنه زار القاهرة في سنة 1968، وكان معه نذير رشيد (مدير المخابرات الأردنية تاليا)، وتحدّث مع القادة العسكريين المصريين عن صفقة طائرات الميراج التي ابتاعتها إسرائيل من فرنسا، وانه اكتشف أنه ليس لدى المصريين أي معلومات عنها. وحين قابل مدير الاستخبارات العسكرية، راح ذلك المدير يقلل من أهمية الميراج … إلخ (ص 95). وهذا الكلام صحيح، لو أن بدران قال إنه جرى قبل الخامس من يونيو/ حزيران 1967، لا في سنة 1968 بحسب سياق الرواية في كتابه. والمعلوم أن الرئيس الفرنسي، شارل ديغول، أوقف شحن السلاح إلى إسرائيل في 27/11/1967، وأعلن ذلك في مؤتمر صحافي في اليوم نفسه. وكان هدّد في 3/6/1967، أي قبل يومين من اندلاع الحرب، بأن الدولة التي تبدأ الحرب في الشرق الأوسط لن تنال تأييد فرنسا، وقرّر، في اليوم نفسه، حظر شحن السلاح الفرنسي إلى دول الشرق الوسط.
5- يكشف المؤلف أن دائرة المخابرات هي مَن أسّس “الجمعية العلمية الملكية”، وأنها هي من دفع ميزانية العام الأول، وهي من شكّل مجلسًا للعلماء فيها، فضلاً عن اللجنة العلمية المؤلفة من أكاديميين كبار، وهي من ابتاعت أهم تكنولوجيا الرصد آنذاك، وكذلك المنظار الليلي (ص 99). وهذا الكلام هو ربع الحقيقة. والحقيقة الكاملة أن البروفيسور الفلسطيني، أنطوان زحلان، هو صاحب الفكرة، وأن ثلاثة من الفلسطينيين هم مَن أقنعوا الملك حسين بفكرة إنشاء جمعية علمية غداة اكتشاف الفجوة العلمية الهائلة بين اسرائيل والعرب التي فضحتها بجلاء ووضوح حرب 1967. وهم: وليد الخالدي وبرهان الدجاني وانطوان زحلان نفسه. وقد اقتنع الملك حسين بجدوى الفكرة، لكنه اشترط أن يكون الثلاثة أعضاء في مجلس إدارة الجمعية، وتولى زحلان موقع المدير العام. وكان ذلك في 1969 لا في 1968 كما ورد في الكتاب (صقر أبو فخر، أنطوان زحلان وضمور الأنتلجنسيا الفلسطينية، صحيفة العربي الجديد، 9/9/2020). الآن، ربما أحال الملك حسين مهمة الإشراف الخفي على الجمعية إلى المخابرات العامة، لأن من بين غايات الجمعية وأهدافها رصد القدارات العلمية الاسرائيلية. لكن الفكرة، في الأساس، لم تكن فكرة المخابرات العامة على الإطلاق. وفي أي حال، انسحب الثلاثة (الخالدي والدجاني وزحلان) من الجمعية بعد حوادث أيلول 1970.
6 – يروي مضر بدران أن مصورًا محترفًا متعاونًا مع المخابرات العامة صوّر في سنة 1968 من بلدة أم قيس حركة لواء اسرائيلي كامل داخل اسرائيل، حين كان يتجه إلى شمال هضبة الجولان على بعد مئات الكيلومترات. وأن عملية التصوير جرت في يوم عاصف ماطر، والضباب تكاد لا ترى عبره شيئًا، وجاءت الصور واضحةً تمامًا، حتى أنه شاهد علم لواء غولاني بحجم علبة السجائر، وأنه أرسل الصور وتحليلها إلى السوريين الذين استعدّوا للأمر، وقاتلوا الإسرائيليين بقوة في عام 1968، وأوقعوا فيهم خسائر وأضرارًا كبيرة (ص 99). وقد ذُهلت لهذه الحكاية أيما ذهول؛ فبلدة أم قيس يفصلها عن الجولان نهر اليرموك، وهي تبعد عن طبرية كيلومترات قليلة جدًا، لا مئات الكيلومترات بحسب رواية المؤلف، وفي الإمكان مشاهدة مدينة طبرية بالعين المجرّدة وبوضوح تام. أما في يوم عاصف وماطر، والضباب يغمر كل مشهد “حتى تكاد لا ترى عبره شيئًا”، ثم تأتي الصور الملتقطة من أم قيس واضحة تماماً، فهذه معجزة مدهشة، لا تعجز عنها وسائل التصوير الحديثة من طراز عام 2020 فحسب، بل كان يعجز عنها الدكتور داهش نفسه (سليم العشي) في عام 1968. والحكاية تحتاج إلى “بردخة وتنعيم” بلغة النجارين.
7- يكشف المؤلف أنه كان على علاقة جيدة مع علي بشناق رئيس القيادة العامة للجبهة الشعبية، وأن المخابرات الأردنية زوّدت أحمد جبريل، مساعد علي بشناق، بشحناتٍ من الأسلحة بينها ألغام وقنابل وأسلحة (ص 102). وهذه الرواية مفاجئة حقًا، بيد أن من الضروري تقويم اعوجاجها؛ فأحمد جبريل لم يكن مساعدًا لعلي بشناق، بل هو المسؤول الأعلى عنه بصفة كونه الأمين العام، فيما علي بشناق (أبو مراد) أدنى مرتبة، مع أنه أحد مؤسّسي الجبهة الشعبية – القيادة العامة المنشقة على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي كان يقودها جورج حبش، وهذه غير تلك.
8- يورد الكاتب في كتابه أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خطفت في 6/9/1970 ثلاث طائرات أجنبية، حطت اثنتان منها في الأزرق” (ص 115). وللدقة التاريخية، فإن الجبهة الشعبية خطفت في ذلك اليوم أربع طائرات: الأولى لشركة إلعال الإسرائيلية، وقد فشلت العملية واعتُقلت ليلى خالد واستُشهد رفيقها باتريك أرغويلو. والثانية تابعة لشركة بان أميركان، وقد فُجّرت في مطار القاهرة. وطائرتان حطتا في منطقة “قيعان الخنا” التي كان الإنكليز يسمونها داوسون فيلد. وفي 8/9/1970 اختُطفت طائرة خامسة من البحرين تابعة لشركة Boac وحطت في قيعان الخنا، فصار عدد الطائرات ثلاثًا، ونُسفت معًا في 12/9/1970.
ورد في الكتاب أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خطفت في 6/9/1970 ثلاث طائرات أجنبية، حطت اثنتان منها في الأزرق. وللدقة التاريخية، خطفت الجبهة أربع طائرات
9- يتذكر المؤلف أن الجيش السوري وصل إلى مدينة إربد في سبتمبر/ أيلول 1970 لمساعدة الفصائل الفلسطينية. آنذاك ضغط الملك حسين على الولايات المتحدة الأميركية كي تبقى على الحياد في المواجهة المحتملة بين الأردن وسورية (ص117). ويجب مضاهاة هذه الرواية مع رواية عدنان أبو عودة التي يقول فيها إن الملك حسين استدعى وزراء حكومته حين تقدّمت القوات السورية من الرمثا إلى جرش في سبتمبر/ أيلول 1970 للحصول منهم على تفويض باستدعاء قوات أجنبية (يوميات عدنان أبو عودة، مصدر سبق ذكره، ص 35). والقوات الأجنبية المهيأة للتدخل حينذاك إنما هي القوات الاسرائيلية، فيما لو استبعدنا القوات الأميركية بحسب رواية مضر بدران.
10- يؤكد صاحب المذكرات إن السوريين حشدوا قوات عسكرية على الحدود مع الأردن، وكان هدفهم دخول الأردن عسكريًا لقطع خط الإمداد الذي يصل ميناء العقبة بالعراق (ص 224). وكالعادة، لا يحدّد الكاتب تاريخ الحدث، ويترك لنا مهمه استنباطه، وهو يقع في مرحلة ما بعد عام 1980، أي عام اندلاع الحرب العراقية – الايرانية. وأعتقد أن مثل هذه الحكاية إنما هي تهويلٌ راجف، وتقدير موقفٍ خائف غير واقعي، على طريقة تحليلات المخابرات التي تجعل كل حركة مؤامرة. ففي تلك الفترة لم يكن في إمكان القيادة السورية اجتياح الأردن، والبقاء في بعض أنحائه لقطع طريق العقبة – بغداد؛ فالأحوال في لبنان كانت كالوحول المتحرّكة، والوضع السوري الداخلي مضطرب جرّاء العمليات الارهابية التي كان الأخوان المسلمون يقومون بها ضد مراكز النظام، خصوصًا عمليات اغتيال رجال النظام. وأظن أن اجتياح الأردن في تلك الفترة لا يمكن أن يفكر فيها رئيسٌ يحسب حساب النملة إذا تحرّكت، من عيار حافظ الأسد. وهذه المعلومة ليست متينة، وهي من منتوجات الخوف الأمني الأردني في تلك الحقبة، سيما بعد اغتيال اللاجيء السياسي السوري، عبد الوهاب البكري، في عمّان في 1980، وبعد تعرّض مضر بدران نفسه لمحاولة اغتيال في 1/2/1981 على أيدي عناصر تابعة لسرايا الدفاع التي كان يقودها رفعت الأسد. وفي سياق هذا الصراع المحتدم، تعرّض القائم بأعمال سفير الأردن في بيروت، هشام المحيسن، للاختطاف في عام 1981 ردًا على دعم الأردن جماعة الإخوان المسلمين في سورية. وقد تصاعدت العمليات والعمليات المضادة إلى درجة خطِرة وخطيرة جداً، ما ألجأ الملك حسين إلى توجيه رسالة إلى الرئيس حافظ الأسد في 10/11/1985 يعتذر فيها عن دعم جماعة الأخوان المسلمين السوريين. وتلك الرسالة تذكّرنا بالرسالة التي وجهها الملك حسين إلى الرئيس جمال عبد الناصر في مارس/ آذار 1961 يطلب فيها الصفح عن سياسة العداوة التي انتهجها ضد مصر. لكن الملك حسين، وخلافًا لمنطوق رسالته تلك، كان يعمل على أمر آخر، هو فرط الوحدة المصرية – السورية، وهو ما نجح فيه في ذلك اليوم المشؤوم 28/9/1961.
تنبوءات وتوقعات
يخبرنا مضر بدران أنه تنبأ بإفلاس خزينة الدولة في سنة 1988، وبسقوط شاه إيران في سنة 1979 خلافاً لتوقعات الملك حسين، وبهبة نيسان (إبريل) 1989 الشعبية الاحتجاجية، وبأن ياسر عرفات لن يوقع الصيغة الأولية لاتفاق عمّان في سنة 1984، وبأن الولايات المتحدة الأميركية ستتخذ من اجتياح العراق للكويت في سنة 1990 ذريعة لتدمير قوة العراق. وفي شرحه قصة الاتفاق مع عرفات يقول: إن الملك حسين وضع صيغة أولية لاتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية. وأراد عدنان أبو عودة أن يحصل على توقيع ياسر عرفات على تلك الصيغة في أثناء عشاء في المدينة الرياضية في عمّان. فقال مضر بدران لعدنان أبو عودة إن عرفات لن يوقع الاتفاق، بينما أكد طارق علاء الدين (مدير المخابرات الأردنية) ومعه عدنان أبو عودة أن أبو عمار سيوقع الاتفاق قبل العشاء. وتبين في تلك الليلة أن عرفات لم يوقع الاتفاق، ثم ذهب ولم يعد (ص 236). والحقيقة أنه عاد. والدليل توقيع “اتفاق عمّان”، لا في تلك الليلة، بل في 11/2/1985؛ ذلك الاتفاق الذي ألغاه الملك حسين في فبراير/ شباط 1986، ولم يلبث طويلاً حتى أعلن قطع روابط الأردن الإدارية والقانونية بالضفة الغربية في 31/7/1988، أي في ذروة الانتفاضة الأولى، وتوقف الأردن عن دفع رواتب 23 ألف موظف فلسطيني في الضفة الغربية، وأُقيل الأعيان الفلسطينيون من مجلس الأعيان. أما لماذا لم يوقع ياسر عرفات الصيغة الأولية للاتفاق في تلك الليلة، وقد جاءت بعنوان “الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين”، فلأنه كان يحتاج موافقه أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح. وبالفعل ذهب أبو عمار إلى الكويت، وجمع قادة حركة فتح الموجودين هناك، وعرض عليهم الصيغة، فرفضها الجميع، لأنها تمثل تنازلًا عن الحق في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وكان أبو عمار وحيدًا في تلك المعمعة، واستولى عليه الغضب. ومن طرائف هذه الحادثة أن أبو عمار هدّد بالاستقالة حينذاك، فقال له أبو إياد (صلاح خلف): إذاً، تقدّم باستقالة مكتوبة. فكتب عرفات على ورقةٍ النص التالي: “إلى جماهير الشعب الفلسطيني، بما إن إخوتي في قيادة حركة فتح وقيادة الشعب الفلسطيني قد تخلوا عن دورهم وواجباتهم كقادة في الدفاع عن مصالح الشعب، فإني أقدم إستقالتي آملاً أن تجدوا مَن هو أفضل مني”، وأرسل الورقة إلى قيادة فتح من دون توقيع. ولما قرئت الورقة طفق الجميع بالضحك، وردّد بعضهم أن أبو عمار لم يوقع الرسالة، وهي ليست استقالة بل تحريض على أعضاء اللجنة المركزية الموجودين في الكويت.
بعض نبوءات مضر بدران صحّت، وبعضها خاب
إذاً، بعض نبوءات مضر بدران صحّت، وبعضها خاب. ومع أنه ماهر في التوقع والتنبوء، فما باله ينسى اسم قائد شرطة دمشق فلا يتذكّر إلا أنه من عائلة الحسيني (ص51). وسننجد ذاكرته في هذا الأمر؛ فاسم ذلك الضابط هو إبراهيم الحسيني الذي اشتهر ببطشه وموالاته أديب الشيشكلي. وكذلك ينسى اسم زميله الطالب السوري من بيت الأتاسي (ص 53)، وهو نور الدين الأتاسي، طالب الطب الذي اعتقل في تظاهرة عام 1952 وسجن، ثم أصبح لاحقًا رئيسًا للدولة السورية. وسأترك هامشًا بسيطًا للخطأ. فإذا كان يقصد طالبًا زميلاً له في كلية الحقوق “من بيت الأتاسي” فهو زهير الأتاسي أو توفيق الأتاسي. أما إذا كان يقصد ذلك الطالب الذي ضُرب وسجن بعد تلك التظاهرة فهو بالتأكيد نور الدين الأتاسي. وكانت كلية الطب في الجامعة السورية مجاورة لكلية الحقوق. والقاعدة الترجيحية لدى قليلي الهمّة في البحث والتقصي تقول: إن لم يكن إبلاً فمعزى. لكن المؤكد لدي هو أن “الطالب السوري من بيت الأتاسي” هو نور الدين. وكذلك نسي اسم سفير سورية في الأردن، ولم يتذكّر إلا أنه من آل الصباغ (ص180). والصحيح أنه عبد الكريم الصباغ. وما دام صاحبنا ينسى فكيف يتنبأ.
خفايا غائبة
قيمة أي مذكرات من مذكرات رجال السياسة أو الأمن تكمن في ما تكشفه من المعلومات والخفايا وخلفيات الوقائع، لا بما تسرده مما هو معلوم بالضرورة. ومذكرات مضر بدران مهمة بلا شك، لكنه، لأمرٍ ما، لم يتطرّق إلى شؤون كثيرة جدًا كبعثة روجر فيشر، على سبيل المثال، التي جاءت إلى الأردن في فبراير/ شباط 1971 حاملة معها عرضًا لإقامة دولة فلسطينية، أو إلى عملية اغتيال حردان التكريتي في الكويت في مارس/ آذار 1971 وصلة الاغتيال بحوادث أيلول 1970، أو إلى إعلان المملكة المتحدة في إبريل/ نيسان 1972، أو إلى تسلل محمد داود عودة (أبو داود) إلى الأردن، وظهوره على شاشة التلفزة الأردنية في 19/2/1973 ليروي أن خطته كانت تتضمن اقتحام مقر رئاسة الوزراء في عمّان واحتجاز رهائن، وأن أبو إياد وأبو مازن (محمود عباس) هما مَن وضع الخطة، وتدبّرا أمر جوازات السفر والأسلحة والنفقات. وأبعد من ذلك، فقد زاغ صاحب المذكرات عن قصة محاولة اغتيال الملك حسين في مؤتمر القمة العربية في الرباط سنة 1974، وعن خطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة في السنة نفسها، وعن الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت في عام 1975، والتي كان للمخابرات الأردنية شأن فيها، فثمة وثيقة في الأرشيف الوطني الأميركي تذكر أن الملك حسين قدّم للمليشيات اليمينية اللبنانية 400 طن من السلاح والذخيرة (أسعد أبو خليل، أميركا أشعلت حرب لبنان، الفرات للنشر، بيروت 2017). ولم تقترب المذكرات من حادثة اغتيال فهد القواسمة في عمّان في 29/12/1984 على أيدي مجموعة إرهابية أرسلها موسى العملة (أبو خالد العملة) لاغتيال محمود تيم، وكانت مؤلفة من نايف البايض وشاكر العبسي (قائد عصابة “فتح الاسلام” في ما بعد). ولم نعثر في المذكرات على أي خبر ربما ينير معرفتنا بمن اغتال الصحافي الأردني ميشال النمري في أثينا في عام 1985.
يكشف مضر بدران أن المخابرات المركزية الأميركية جنّدت عميلاً للمخابرات العامة الأردنية، وطلبت منه أن يسافر إلى برلين، ويلتقي قريبه محمود الزعبي (رئيس الحكومة السورية فيما بعد)، ويحصل منه على معلومات تحتاجها المخابرات الأميركية، فما كان من مضر بدران، وكان مديرا للمخابرات الأردنية في حينه (من إبريل/ نيسان 1968 – يونيو/ حزيران 1970)، إلا اعتقال ذلك العميل، لأن الولاء المزدوج غير مسموح به، ومنعه من السفر إلى برلين على الرغم من إلحاح المخابرات الأميركية (ص91). وحين أخبره وزير خارجية الأردن، مروان القلسم، أن هنري كيسنجر كتب في مذكراته تمجيدًا للرئيس السوري حافظ الأسد، ونقدًا أساء فيه للملك حسين، بادر مضر بدران إلى وضع اسم كيسنجر على القائمة السوداء، ومنعه من دخول الأردن. وعندما أراد كيسنجر زيارة عمّان فوجيء بأنه ممنوع من الدخول إلى البلاد، فاتصل بالملك حسين الذي غضب لهذا القرار، وطلب رفع اسم كيسنجر من القائمة السوداء، لكن بدران رفض، وكاد الملك ينفجر من الغضب (ص161 و162). السؤال: من أين له القوة ليرفض طلبًا للملك حسين، وهو الذي كثيرًا ما دعا الله أن يميته قبل الملك؟.
قيمة أي مذكرات من مذكرات رجال السياسة أو الأمن تكمن في ما تكشفه من المعلومات والخفايا وخلفيات الوقائع
يذكر مضر بدران أن لدى المخابرات المركزية الأميركية (CIA) مصدرًا للمعلومات في قيادة حركة فتح في الكويت (ص 92)، وهو يوافق ما ذكره عدنان أبو عودة في يومياته عن أن جميل الرمحي (أبو اسماعيل)، وهو قناة استخبارية، كان لديه عميل رفيع في حركة فتح يزوده بتقارير وافيه عن أوضاع المقاومة الفلسطينية وعن أحوال منظماتها. كما يكشف أن مصادره في داخل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جيدة المستوى ورفيعة المرتبة (ص 110). ولهذا تمكّن بسرعة من تحديد مكان احتجاز أحمد عبيدات في مخيم الوحدات، الذي كان الرجل الثالث في المخابرات العامة بعد مضر بدران وأديب طهبوب، والذي اختطفته الجبهة الشعبية في تلك الفترة. ويكتب مضر بدران إن أنور السادات كان يكره الملك حسين كثيرًا (ص151)، لكنه لا يفسر أسباب هذا الكره ودوافعه. ويؤكّد أن المخابرات الأردنية كان لها مصدر مهم في القصر الجمهوري في مصر كان يرسل محاضر اجتماعات أنور السادات أول بأول (ص151). ومع ذلك، فإن الملك حسين كان يرغب في إرسال برقية إلى أنور السادات، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1977ن تشيد بشجاعته بعد زيارة القدس (ص 184). وفي هذا السياق، يقول بدران “إن حرب 1973 لم تحظَ بالقراءة الشاملة في ظل المتوفر من المعلومات والمدرك في التحليل، خصوصًا أمام حقائق قد يكون الآن موعد الكشف عنها (ص 155)، ويتساءل: “لماذا توقف السادات عند ممر متلا في سيناء، ولم يتقدم أكثر على الرغم من قدرة الجيش المصري على ذلك” (ص 154). وهذا غلط بغلط مجددًا، فالجيش المصري في حرب 1973 لم يتوقف عند ممر متلا الذي يبعد نحو 40 كلم شرق قناة السويس، بل توقف على مبعدة نحو 10 كيلومترات فقط، وبقي ممرا متلا والجدي في منطقة السيطرة الإسرائيلية، وهذا من ألاعيب أنور السادات الذي اتفق مع الرئيس السوري حافظ الأسد وأركانه على “خطة غرانيت – 2″، لكنه وضع مع رئيس أركانه، سعد الدين الشاذلي، خطة أخرى دُعيت “العملية 41″، ثم قلّص الأهداف مرة ثانية في “خطة المآذن العالية”، من دون أن يتفق على ذلك مع السوريين. وهكذا وضع المصريون والسوريون “خطة غرانيت -2” ، لكن السادات خدع السوريين بالأهداف التي وضعها معهم، ونفذ خطة أخرى، واستخدم الجيش السوري لتشتيت قوة الجيش الاسرائيلي في سبيل ضمان نجاح عملية عبور قناة السويس.